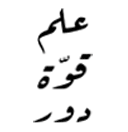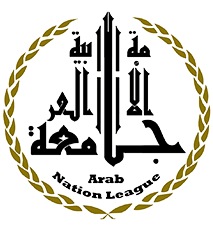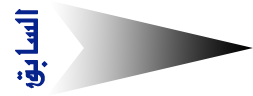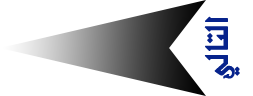هل للمواطن العربي من دليلٍ يركن إلى تطبيقه بخطواتٍ متتاليةٍ تسفر عن إخراجه من حالة الانحطاط والتمزق إلى حالة يأخذ فيها دوره كانسانٍ منتجٍ واعٍ في مجتمعه في دولته الواحدة ليشكل أداة النهوض لامته ووطنه؟ ربما تشكل إثارة هذا التساؤل معضلة بحد ذاتها تحتاج إلى البحث لها عن حل، واستطراداً يمكن القول، وبثقة، أنه ما من وصفة محددة سلفاً لا للعرب ولا لغيرهم للنهوض من كبوتهم، فاستلهام تجارب الشعوب والأمم يمكن أن يفيد ويصحح ويعدل بالإضافة او الحذف لخطوات الحل لكنها تبقى قاصرة، فتلك التجارب تمتلك خصوصية الأمم التي مرت بها، فمشاريع النهوض القومي امتازت أنهاانتجت تجربتها في اطار تفاعل عناصر تلك الأمم البشريةوالاقتصادية والتاريخية والجغرافية في اجتراح الحل لعقدةالنهوض القومي.
حقيقة التساؤل المطروح في مطلع هذا المقال تتلخص في سؤال بسيط: ما العمل؟ وربما كان هذا السؤال يشكل سمةً مشتركةً بين البشر عبر عصورهم وخصوصاً حينما تكون الأمم في حالة انهيار وتراجع، فسؤال النهضة القومية لا يطرح في الأمم التي أنجزت مشروعها النهضوي بتازم مسارات حياتها كالوحدة ونهوض عجلة الاقتصاد وانطاق نهضة علمية وثقافية وثورة مجتمعية على كل ما سبق مرحلة الانطاق وإنما تتغير طبيعة الأسئلة المطروحة في تلك الأمم. وجوهر التساؤل هنا يمثل الصراع المتفجر على أرض بلادنا من مشرقها إلى مغربها بين مشاريع الحل المختلفة وبين تلك المشاريع وبين أبناء الامة، فمن المشروع الاساموي الذي يتبنى العقيدة الإسامية حاً وحيداً في مواجهة غيره، إلى الماركسية التي تتبنى حقوق الطبقات المهمشة والعمال والمثقفين وتبني تحليلها في الحل على الصراع الطبقي كحلٍ وحيدٍ ستحسمه البروليتاريا لصالحها، إلى الليبراليين الذين يتبنون الديمقراطية التمثيلية والحرية الاقتصادية منهجاً للحل، وصولاً إلى القوميين العرب الذين يتبنون فكرة الوحدة العربية منطلقاً للحل.
في سياق السؤال الأزلي “ما العمل؟” نتوقف عند “جيمس هنري بريستد” في كتابه “انتصار الحضارة” الذي يشير إلى جدٍل ملفت للنظر - حين انهارت فترة سماها عصر الأهرامات والتي دامت قرابة الألف عام حين شاعت الفوضى وخرج الكثير من المتنفذين على سلطة الدولة التي تمثلت بالاتحاد الأول في تاريخ مصر بين أمصارها – وتمثل ذلك الجدل في توق الناس إلى العودة إلى حالة الاتحاد ودفع الغزاة الذين قدِموا من كل صوب بعد ضعف السلطة المركزية، وانقسم الرأي بين الناس وبقيادة مفكري تلك المرحلة في أنٍ ))عصراً جديداً سيبدأ عندما يتولى الأمر جيل من الموظفين العادلين ذوي الأمانة، بينما آمن البعض الاخر أن هذا العصر الجديد يمكن أن يجيء على يد ملكٍ عادلٍ ينقذ الناس ويعيد تنظيم المجتمع((. القراءة المتأنية في هذا النص والظروف الملابسة له تقول بالحرف إن انهيار الدولة المركزية الوحدوية يتبعه انهيار لكل شيء وانحطاط في كل شيء، وثانيها أن يقترن الحل بإعادة الدولة المركزية الواحدة إلى حيز الوجود وفي هذا لم يختلف أهل تلك العصور، ولكن التباين بينهم ظهر على يد من يكون النهوض وكيف سينجز هذا الحل، وملخص الحلين يقول إما أن النخبة - التي اسموها الموظفين والذين يشترط في هم مسبقاً الأمانة والعدل – تتصدى لمشروع النهوض، وإما أن يظهر القائد العادل الذي يعي مشكلة التجزئة التي حلت بمصر وانحال حكومتها المركزية فيعيد الأمور إلى نصابها، هذا التبسيط كما يبدو للوهلة الأولى لا يصمد أمام التعقيد في الواقع العربي المعاصر، إن أردنا إسقاط دروس التاريخ على الحاضر، وهذا ليس هدفنا هنا، لكن التعمق في الفهم فعلى سبيل المثال كانت تجربة محمد علي باشا تمثل نوعاً من النهوض القومي الذي جاء على يد محمد علي في مصر والذي بدأ في التمدد نحو السودان لتأمين أعالي النيل بمجاورته للحبشة ومن ثم انطلق في المشرق العربي.
لا شك في أن هذه التجربة نبهت الاستعمار العالمي إلى خطورة موقع مصر واهميتها في الواقع القومي العربي، وهنا يمكن أن يصح القول أن وجود الملك العادل يكون محفزا للنهوض،على أنه لا بد من الأخذ بالمتغيرات المحيطة والتعقيد والتداخل الحاصل في الساحة الدولية، وتجربته كان يمكن لها النجاح لو اجتاز العقدة الشامية التي تم تجييش القوى الاستعمارية خلف الدولة العثمانية لتحريضها وتأليب الجماهير عليه، بالرغم من وجود تيار شعبي عريض في باد الشام كان يؤيد محمد علي أيضاً، وبالرغم من أن هزيمة مشروعه الوحدوي النهضوي جاء أساساً بسبب التدخل الأوروبي الداعم لتركيا، وليس بسبب تمردات داخلية، كانت أيضاً مدعومةً من الخارج. ولكن هنا يبرز دور النخب ومهمتهم التوعوية والتبشيرية التي تمهد الأرض للعسكر الفاتحين قبل ان تطأ قدمهم أي أرض يتجهون إلى تحريرها، ولذلك اذا جازت المقاربة التي استوحيناها من بطون التاريخ المصري القديم فإن ظهور القائد لا يعطي دائماً نتائج محققة بدليل أنه حتى في التاريخ المصري القديم عندما ظهر في فترة متأخرة أحد الملوك العادلين )امنمحات الأول(، والذي استطاع أن يعيد الأمور إلى نصابها، وينظم شؤون مصر، إلا أنه بقي بعض أمراء الأقاليم خارج إطار نفوذ الدولة.
ولا نزال في مصر كونها بيضة القبان في الواقع العربي على مر العصور، وكونها كتلة تمتاز بالتماسك ومن الحجم المتوسط من حيث الجغرافيا والسكان والموارد، لتعود التجربة تتكرر في الواقع العربي على يد عبدالناصر، وهنا نتوقف ملياً لننظر إلى هذه التجربة بالتوازي مع تجربة البعث في المشرق العربي، فقد ظهرت التجربة الناصرية في خضم موجة عارمة من حركات التحرر الوطني، وكانت الحركة القومية العربية كطليعة لمشروع التحرر العربي في أوج توهجها في المشرق العربي وخصوصا في سورية، فكما بدأ محمد علي قومياً بالدور الموضوعي أكثر مما كان قائداً انطلق مسبقاً من منطلقات قومية عربية، كذلك كان عبدالناصر في بداياته، وكما أصبح محمد علي )وإبراهيم باشا( قومياً بالموقف المعلن والرؤيا، كذلك أصبح عبد الناصر، وكما انضجت التجربة التاريخية لمصر محمد علي في فترة قياسية، اتجه بعدها إلى المحيط العربي، كذلك نهج عبدالناصر ذات النهج مستلهماً الفكر العروبي من الشام، فيمكننا القول ان الشام علمت عبدالناصر العروبة التي كانت بين جنباته لكنها لم تترجم إلى خطاب، ولم يكن قد وعى
عليها بعد، ولو أن العروبة كحس مبهم غير متبلور تظل نتاجاً طبيعياً لحقيقة الوجود القومي، ولكن صيرورة الصراع على الوطن العربي ومصر في قلبه نبهت القائد الشاب إلى هذه الأيديولوجيا الجديدة نسبياً على مصر، مصر التي تغلفت - طوال عصر الانكفاء الذي اعقب هزيمة جيوش محمد علي باشا في سورية – بغافٍ دينيٍ صوفي الطابع في العموم، وكانت قد نشأت على هامش حملة محمد علي التحديثية نهضة ثقافية قومية )بإشراف رفاعة الطهطاوي(ظلت تتفاعل حتى بدايات القرن العشرين.
شكلت المدرسة البعثية بتعاليمها وامتداداتها الأفقية بين الشباب في عموم الوطن العربي طلائع ناصرية، وبتنا أمام نخبة مثقفة ووعي قومي بين شباب الأمة وقائد التقط اللحظة التاريخية حاماً آمال الامة، واستطاعت هذه الثلاثية قائداً ونخبةً وجماهير أن تنجز في غضون سنوات أول وحدة عربية قائمة على الوعي ودونما حاجة للقوة، لكنها وللأسف أخفقت حيث نجح محمد علي، فإذا كان محمد علي قد نجح بضم الشام بالقوة ) رغم وجود تأييد شعبي ونخبوي نسبي لها (، قبل أن تتكالب عليه القوى الاستعمارية وتخرجه منها وتعيدها إلى السلطنة العثمانية، فقد نجح عبدالناصر بذلك من دون القوة، لكنه أخفق بعدم استعماله للقوة لحماية الوحدة، لتكتمل لدينا الصورة أن القوة عنصر إضافي لتحقيق الوحدة والحفاظ عليها من الطامعين والمخربين.
ويجب أن نتوقف عند حقيقة ما حدث لنضيف إلى ما سبق أن عبدالناصر آمن بالعروبة من دون أن يتتلمذ في أي تنظيم قومي، وكان من أشد الناس اخلاصاً للعروبة ومشروعها، لكن هناك من قيادات البعث شركاء لعبدالناصر في الوحدة العربية الأولى في العصر الحديث ممن لم يكونوا عروبيين حق العروبة، بل أن بعضاً منهم لم يحتمل فكرة أن يكون خارج الإطار أو أن يكون جندياً فحسب في دولة الوحدة فالنزعات الذاتية افضت إلى التحريض على الوحدة من بوابة الغمز على «تسلط » عبدالناصر، وإذا كان من الجائز أن نناقش وننقد فكرة حل الأحزاب ذات النزعة الوحدوية، مثل حزب البعث، أو نقد طريقة إدارة الإقليم الشمالي، لمن رأي فيها خلاً، فإنه لا يجوز بأية حال أن يصبح ذلك ذريعةً للمساس بالمنجز الوحدوي نفسه كمنجز تاريخي يجب البناء عليه وتطويره، لا محاولة تقويضه بهذه الذريعة أو تلك.
لا نشك في أن انهيار الجمهورية العربية المتحدة شكل ضربةً قوية لوجدان الإنسان العربي، وشكلت هزيمة عام 1967 ضربة لوعيه أيضاً، كمحاولة إسقاط رمزية القيادة الناصرية وأثرها في النهوض العربي، رغم ذلك بقيت التجربة الناصرية ملهمةً لكثير من الشباب والأجيال العربية، واستمرت الأيديولوجيا البعثية كذلك، لكنها فقدت ركيزة الكاريزما الناصرية، وحتى لو لم يصبح البعثيون ناصريين ولو لم يتحول عبدالناصر إلى بعثي إلا أن جدلية الحقل المغناطيسي الذي نشأ بين الطرفين أعطت أكلها وأثمرت ثمراً طيباً في مراحل معينة، فأصبح الشارع العربي يشعر باليتم، ورافق غياب ناصر عن المشهد العربي حملة بترودولارية ساداتية لتدمير ذلك الإرث وحصار ممنهج لتجربة البعث تطور إلى استيعاب مزدوج بعثي-بعثي لسنا في مورد مناقشته في هذا السياق. ترتب على هذه الحال انفجار جنون الصحوات الإساموية التي قامت على إلغاء ونفي كل ما عداها، فكانت محاربة «العروبة الكافرة » قوت تلك الجماعات اليومي وخطابها الممنهج، تمهيداً لشطب كل ما يشي أو يقول بعروبة الإنسان او الأرض، تحت ستار من المقولات أن الإنسان أينما كان، وأيما كانت هويته العرقية هو عبد لله وأن الأرض أرض الله لا هوية لها، هذه الدعوات التي خلقت وعياً الغائياً متطرفاً نحو كل شيء لم يسلم من جنونها شيء، في الحين الذي كان المشروع العربي، والذي تمثل بالتجربة الناصرية والبعثية، مشروعاً أبعد ما يكون عن إلغاء فكرة الإسام كدين او حتى المسيحية، فقد نظرت تلك التجربة إلى الدين كجزء مكمل في البنيان الهوياتي الحضاري للعرب.
وليس من نافل القول أن نذكر أن المشروع العربي قاتل طوياً ليبعد عن ذاته الصفة العنصرية الشوفينية التي طالما رماه بها الاسامويون والماركسيون أيضاً، وحتى اليوم لا تزال هذه التهمة تلتصق بحمَلة هذا المشروع ودون سند، مقابل التعنصر والتمذهب والارتداد الطائفي للحركات الإساموية فلم تترك باباً من هذا القبيل إلا وطرقته لنتوقف نحن
العروبيين أمام سؤال: ماذا كنا نفعل عندما كان هؤلاء يتسللون في مساجدنا ومدارسنا وبين أطفالنا؟ هل تنفع فعاً روحالتسامح معهم، أم أن الموضوع كان يحتاج إلى اجتثاث حقيقي؟ فما فعله الإساميون بتلاوينهم الطائفية بالشعب العربي في العراق وسورية، من اجتثاث البعث في العراق إلى اجتثاث العروبة من سورية، بحجة محاربة «الروافض »، إلى نهج تدمير كل ما يمت إلى العروبة بصلة، إلى توظيف عرقيات بأكملها في بلادنا في خدمة العدو بفضل القيادات الكردية التي أصبحت رأس حربة في تمزيق العروبة ووطنها، إلى اليهود الذين نجد من يحلو له التفريق بين اليهودي والصهيوني وهم ملة واحدة، إلى من ينظر إلى الإدارات الأمريكية والأوروبية التي لم ولن نجد أشد تطرفاً وعنصرية منها على ظهر البسيطة، ويطلب منا نحن العروبيين أن نتحلى بالهدوء والحكمة وتقبل الآخرين كيا نتهم بالشوفينية والعنصرية، أم نتحدث عن الاتراك الذين باسم الله والسنة حطموا حضارتنا وسلبوا خيرة عقولنا، وتركونا اثراً بعد عين في خواء فكري وثقافي واقتصادي بعد أن سلمونا للاستعمار الأوروبي ليكمل مهمتهم التدميرية؟!
إن حجم التطرف والعنصرية في هذا الكون وبين جنباتنا أيضاً يعجز عنه الوصف، فلما لا نكون عرباً فحسب، بعروبتنا نعتز ونفاخر الدنيا بها، فليس لدينا إلا ما نرفع به رؤوسنا ولا نخجل من واقعنا لأن علينا أن نضع حداً لكل متطاول على هويتنا، وأن نرى في ذاتنا تميزاً خلقه الله فينا ولم يحُز عليه غيرنا من بني البشر، فإذا نادينا بالحضارة فنحن أهلها وسنعيدها كما كانت، وإذا نادينا بالأديان فبلادنا مهدها، المسيح منا ومحمد منا شرفنا الله برسالاتهم ونحن حملناها للبشر ليؤمنوا بها، فلنتعز بعروبتنا لأنها شرفنا ولنتعصب لها ما استطعنا ولنتطرف في حبها والدفاع عنها، لا يعنينا مرجف أو حاقد أو حاسد أو طامع، بها نحمل وطننا إلى النجوم ونسود الدنيا، كما سدناها بالعمل والعلم من قبل، ليكن خطابنا إلى الجماهير بسيطاً: العروبة أولاً، وثروات العرب للعرب، العربي لا يحده حد في وطنه من المحيط إلى الخليج.
إن تبسيط الخطاب إلى الجماهير الواثق بقدرتها والمعتز بقوميتها يمكن أن نجعل منه شعاراً يجوب أرجاء الوطن نهتف به في بغداد لنسمع صداه في تطوان، نخلق من الشباب المحبط طلائع جاهزة تنتظر قائدها، نجند الشباب تحت عنوان الأمة العربية، ونصل العمل بالعمل في بناء الكادر القومي الذي يمهد الأرضية أمام الطوفان القومي.
بقي من القول أن في أبناء العروبة ما يُشد به الأزر، وفيهم من الأمل ما تخر له الجبال أمام عظمتهم وشموخ قوميتهم، إن بذرة النهوض تحتاج إلى تربة خصبة تمتد جذور العروبة فيها بعمق وهذا العمق ينبغي له إيمان مطلق بحق هذه الأمة وبعدالة قضيتها وبحقها في تحطيم كل العوائق في طريقها، عاشت أمتنا وشمخت عروبتنا بشبابها.