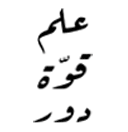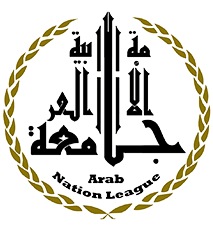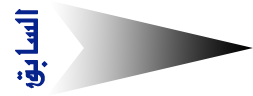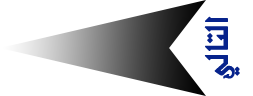كان حدث “طوفان الأقصى”، دون شك مفاجئاً بقوّة انطلاقتِه. إلّا أنّ الأبعاد التي ينطوي عليها، كانت على جانبٍ أعظم من المفاجأة!
سوف أُبرز بعض هذه الأبعاد، على أن أفصّلها بعض الشيء، الواحد تلو الآخر.
أوّلاً.
أبدأ بما يبدو لي، على جانبٍ مطلق من الجلاء، غياباً جذريّاً وكلّيّاً في جميع العهود دون استثناء، لقوانين دولية مزعومة، يُدّعى أنّها تنظّم العلاقات بين الشعوب والأمم. وذلك على مستوى العالم بأسره.
أجل، أجرؤ وأدّعي اليوم، في ضوء ما يجري في غزّة، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، نظراً للاحتقار التام الذي تواجه به إسرائيل العالم كلّه. بدءاً من الأمم المتّحدة ومجلس الأمن، أنّ القانون الوحيد الذي كان قائماً على الدوام، طوال أحقاب التاريخ العام، إنما هو قانون الأقوى. وإن هذه الحقيقة لم تعد تبدو لا خياليّةً، ولا سخيفةً. وليس مَن ينكرها سوى الأغبياء… وأصحاب المصالح!
إن كان ذلك يمكنه أن يبدو صحيحاً بصورة عامة، على نطاق أزمنة ماضية وبعيدة، فهو يصحّ أيضاً، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، بالنسبة إلى العصور الوسطى والحديثة.
ولنمضِ إلى ما هو أبعد من ذلك.
إذا حدّقنا في الأزمنة التي كان الحكم يُمارَس فيها باسم الله، سواء كان ذلك في بيزنطة، أو في الغرب المسيحي، أو في دار الإسلام، في بغداد، ومصر، وسورية، وعلى نحو خاص في زمن الإمبراطورية العثمانية، لم يكن الله، بكل تأكيد، ليرتاح إلى ما كان ممثّلوه يفعلون، في نهاية المطاف، باسمه. وإني لأرى بكل بساطة، أنهم كلّهم دون استثناء، كانوا أسوأ جلّاديه!
أمّا فترة الإبادات المتمادية، التي لازمت اكتشاف القارة الأميركية، والتي أعقبتها سريعاً فترة الحروب الدينية في أوروبا، ومن ثم الفتوحات الاستعمارية الرهيبة، التي قامت بها بلدان أوربية تدّعي المسيحيّة، أما هذه الفترات، فلا بد للمرء من أن يكون قد فقد كل مفاهيم الإيمان والأخلاق، كي يجرؤ ويزعم أنّها كانت تنطوي على شيء من الأخلاق، ولو في حدودها الدنيا.
إلا أن من يتسنّى له أن يستعرض تاريخ أوروبا، ماضياً وحاضراً، مع العالم العربي، فسيتعيّن عليه دون أدنى شك، أن يعترف بأسبقيّة اللاأخلاق واللاشرعية، للسياسيّين الذين أملَوا تصريح بلفور، والتزموا به منذ عام (1917) إلى يومنا هذا، الموافق الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2023.
ثانياً.
وأصل الآن إلى ما يبدو لي الانهيار المطلق لكل تعايش ممكن بين جميع الديانات من جهة، ولا سيما المسيحية واليهودية، وجميع الدول من جهة أخرى، باستثناء بعض الفترات، كما حدث في عهد الأمويين، والعباسيين، ولا سيما في الأندلس، طوال القرون الماضية، وخلال فترة حديثة نسبياً، في لبنان وسورية… وإن مثل هذا التأكيد، لا يستند البتّة إلى أي تضخيم أو تجاهل لوقائع التاريخ.
وباقتضاب، حسبي أن أذكّر بالدرجة الأولى، بالاضطهاد الذي انتهجه الكنيس اليهودي ضدّ يسوع أوّلاً، ثمّ ضدّ تلاميذه وأتباعه حتى عام (313). والمؤسف أنّ هذا التاريخ المشؤوم، بدل أن يسجّل بداية حقبة إنجيليّة صرف، افتتح عهداً من الاضطهاد المناقض كلّيّاً للإنجيل، وقد سوّلت فيه الكنيسة لنفسها أن تفرضَه على اليهود، في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية، أملاً واهياً منها بإرغام اليهود على اعتناق المسيحيّة. وإنّ هذا الاضطهاد المبطّن، هو الذي خلق في ما بعد، تلك اللاسامية البغيضة، التي انتهت إلى حقن الكنيسة الغربية كلها، وجميع الكنائس التابعة لها، والمجتمعات الأوروبية كلها، المسمّاة مسيحية، بسمٍّ زعاف، حتى منتصف القرن العشرين.
وكان أن نجم عن ذلك نتائج عصيّة على أي علاج: منها، على مستوى الكنيسة والمجتمعات الأوروبية، عقدة ذنب حيال اليهود، يستحيل اقتلاعها، بل هي تفضي إلى دعم اليهود، وحتى الصهاينة وإسرائيل، دعماً غير مشروط ودائماً، على الرغم من جميع الأهوال التي أجازوا لأنفسهم أن يرتكبوها، طوال الخمسة والسبعين عاماً، التي انقضت على زرع إسرائيل عام (1948)، والتي يجيزون لأنفسهم أن يرتكبوها على مرأى ومسمع من العالم بأسره، في هذا الوقت بالذات، وفي غزّة وفي فلسطين المحتلّة!
وثمّة نتائج أخرى، عصيّة على العلاج، ولكنّها تطال هذه المرة، جميع اليهود على مستوى الأرض كلها، ولا سيما في فلسطين: إنها لكراهيّة مَرَضية وشاملة، تطال ليس فقط كل ما هو مسيحي، بل كل إنسان أيضاً، لا سيما إذا اتضح أنه ضعيف، مثلما كانت حال العرب دائماً، ولا تزال، منذ أن اختارت الحركة الصهيونية فلسطين، لتقيم فيها “وطنها القومي”.
وإلى ذلك، فلا بد لنا من الاعتراف بأن الإسلام وحده، منذ أن فتح دمشق عام (635)، ثم القدس عام (639)، ثم مصر عام (641)، ولا سيما الأندلس، ما بين (711) و(1492)، أجل إن الإسلام وحده قد عرف أن يبدع نمطاً من التعايش مع الشعوب المقهورة، قدّم الدليل على جدواه عبر التاريخ كله. وحسبُنا البرهان الحاسم على ذلك، ما جاء لدى المؤرّخين اليهود، بل الإسرائيليين، مثل “آبا إيبان”، والحاخام الفرنسي “جوزي أيزنبرغ”، والمؤرّخ الأميركي “أبرام ليون زخار”. والحال أن كل ذلك قد حدث، مع أن الإسلام قد سجّل في جميع فتوحاته الماضية، زخماً لم يُعهَد لدى سواه.
وإنّ لنا برهاناً ثابتاً عل هذا التعايش الاستثنائي، الذي أبدعه الإسلام ومارسه، يطيب لي أن أبرزه في استمرار حضور العرب المسيحيّين – ومثلهم اليهود – في الشرق الأدنى، حتى اليوم (24/11/2023)، مع مواطنيهم المسلمين، على الصعيدين الثقافي والسياسي، بحيث أنشأوا أحزاباً سياسية قوية، انتهى بها الأمر إلى إبداع التيار العروبي، أي تلك الأيديولوجية السياسية التي ترمي إلى احتواء المجتمع العربي برمّته، في حراك سياسي واحد.
وثمّة برهان آخر، إن اقتضى الأمر، ولكنه هذه المرة، برهان يتحدّى كل إنكار متوقّع. إنه المقاومة الأسطورية التي برهنت عليها سورية، خلال هذه الحرب الكونية والجهنمية، التي خُطِّطت ضدّها، منذ منتصف شهر آذار/ مارس، عام (2011)، من قبل ما لا يقل عن (140) بلداً، على رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.
ثالثاً.
وأما البعد الثالث، فليس لديّ سوى استعباد الضمير العالمي للقوى الرسمية أو المخفية التي تسيطر على العالم.
وهنا، لا أفتقر إلى أمثلة. إلّا أني لن أبرز إلّا مثالاً واحداً، وهو أكثر من مقلق. وإني لأقدّمه في وجهَيْه المتكاملَين.
هوذا وجهه الأول: عندما شُنّت الحرب الكونية الراهنة ضد سورية، في (15) آذار/ مارس، عام (2011)، كانت جميع وسائل الإعلام، أجل جميع وسائل الإعلام، الناشطة في الدول الحليفة، المائة والأربعين، قد اندلقت، طوال سنوات وسنوات، ليل نهار دون انقطاع، ضد سورية، سورية التي باتت بين ليلة وضحاها، العدوّ الألدّ والأوحد، الذي يتوجّب القضاء عليه. فضلاً عن ذلك، هل يجوز لنا إغفال مئات “العلماء”، “الحقيقيّين” أو “المرتجلين” بقدرة قادر، الذين كانوا يتنافسون في التسويغ والتحريض، من أجل إرسال مئات الآلاف من “الجهاديّين” المزعومين، الذين اختيروا ودُرّبوا ومُوّلوا، عبر البلدان العربية والإسلامية على السواء، وكذلك بالطبع عبر جميع البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة، وكندا وأستراليا، والصين وبلدان أفريقية! وإني لأمتنع عن المزيد!
وأما الوجه الثاني، فحسبي شاهداً عليه الانتفاضة الفلسطينية في غزة، يوم (7) تشرين الأول/ أكتوبر، من عام (2023).
وفي الواقع، فإني لا أراني مبالغاً، إن أكّدت أنه لولا صورة وصوت هذه المحطة التلفزيونية الاستثنائية، التي تُدعى الميادين، ولولا العديد من شركائها، وصحفيّيها ومراسليها ومندوبيها، المنتشرين في العالم كلّه، من تُراه كان عرف، أو حتى تخيّل ولو بالحدود الدنيا، الهول العصيّ على أي وصف، لما كان يجري في غزة، منذ ذاك اليوم المحتوم، يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2029؟
لقد بات الجميع، منذ ذلك الحين، على بيّنة جليّة أن ما يُسمّى شرعة الأمم المتحدة لم تكن سوى خدعة. ومثلها كل ما يُسمّى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وجميع المنظّمات الدولية المزعومة، إذ ليست سوى أدوات في خدمة جبابرة هذا العالم!
ومنذ ذلك الحين، بات العالم العربي وباتت البلدان الإسلامية، في حاجة ماسة إلى إعادة تقييم معايير علاقاتها، إن مع “القوى الكبرى”، أو مع هذه الدولة “الصغيرة”، ولكن المتوحشة، التي تدعى “إسرائيل”، والتي تكشّفت في الواقع بوصفها سيدة العالم الوحيدة!
على كل حال، فإنّ التظاهرات العملاقة التي أيقظت العالم، تأييداً للفلسطينيّين، قد مزّقت كلياً الحجاب الذي أَلِف العديد من “الزعماء” العرب والمسلمين، أن يلوّحوا به في بلدانهم المختلفة، ضدّ إرادة شعوبهم الصريحة، تحت مسمّى بريء، هو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
حقاً، فإن الحقيقة وحدها هي التي تحرّر، ولكنها حقيقة غارقة في دم الأطفال والنساء، قبل كل شيء، في إدانة صارخة لإسرائيل وعبيدها!
ولذلك، فإني لا أتردّد البتة في الإعلان أخيراً، ولكن بما لدي من قلب كاهن مؤمن بيسوع المسيح، وقد سُحِق خجلاً بسبب صمت الكنيسة كلّها وتغيّبها عن هذه المأساة الكونية التي تجري أحداثها في فلسطين، وطنه بعينه، أجل لا أتردّد في الإعلان أنّ “طوفان الأقصى” سوف يسجّل بداية تبدّلات كثيرة وحاسمة، ستترجّع أصداؤها على نطاق مستقبل العالم بأسره، في ما يشبه التبدّلات التي حدثت قبل ألفي عام، في فلسطين بالذات.
رابعاً.
أخيراً أودّ أن أشير إلى أنه آن للعالم العربي حصراً، أن يستعين بحقيقة أساسية، ليس سواها يشكل ذاتيّته كلّها! والصحيح أننا هنا أمام عالم له امتداد جغرافي شاسع، ويملك طاقات لا حدود لها، على الصعيد البشري والموارد في آن واحد. ولذلك كان أبداً عرضة لمطامع لا تحصى، وسوف يبقى. ولذلك أيضاً من النافل، بكل معنى الكلمة، توقّع أي شيء إيجابي من القوى الغربية، أيّة كانت مسمّياتها، الغرب الأوروبي أو الأميركي، الشرق الأقصى، الصين، روسيا، إيران، فيما القوة الأخيرة، وهي إسرائيل، تتبدّى بكل وضوح أخطرها جميعاً، بما تملك من امتدادات لا تحصى، على الصعيد الإعلامي والسياسي، واللوجستي، والعلمي، والمالي، والمخابراتي الخ… سواء عبر العالم كله، أو داخل الدول ذاتها تحديداً.
إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة الأخذ بكل تحالف ممكن، مع هذا المحور أو ذاك، الذي “يسعى” لتحرير العالم كلّه من هيمنة الولايات المتحدة، الخارجة على كل ما هو إنساني، وفي احترام تام لكوكب الأرض، ولخصوصية كل دولة على حدة!
يترتّب إذن علينا أن نبحث في شجاعة، ولكن في منهجية، بأقصى قدر ممكن، عما يشكّل في عمق أعماقنا، هويّتنا البشرية حقاً، لا سيما على الصعيد الثقافي والسياسي.
وإنّ اللغة العربية، التي يشكّل القرآن القلب والجوهر منها، إنما هي فيها الجسر الروحي والإنساني والاجتماعي، القادر على ربط جميع خلايا هذا العالم الضخم. وإن التلاحم الإنساني والروحي، الذي يَسِم بعمق النسيج الإنساني الخاص بهذا العالم البادي التشرذم، هو معطى أساس، يجب الأخذ به، أيّاً كان الثمن، من أجل كل مشروع حاسم.
وهناك أيضاً واقع تاريخي بالغ الأهمية، وسم التطور العام لتاريخ الشعوب والديانات، داخل المجتمعات الإسلامية، بخلاف ما حدث في جميع المجتمعات الغربية، سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة، وكندا وأستراليا… وإنه لواقع تاريخي لا يمكن دحضه، وهو وليد عبقرية متميزة. إنه واقع التسامح الديني، الذي بلغ أعلى ذراه في الأندلس حتى عام (1492)، والذي حقق أيضاً أحد أشهر ثماره الثقافية، بل السياسية أيضاً، في ما كان يُدعى سورية الكبرى، بدءاً من منتصف القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا.
ولذلك، أجيز لنفسي أن أختم مقاربتي هذه، بالتذكير بأهمية الدور الحاسم، الذي يسع سورية الكبرى أن تلعبه في أزمنتنا هذه بالتحديد، وعلى صعيد هذا المشروع الحيوي، بعيداً عن جميع التقسيمات السياسية الراهنة، بوصفها القلب الروحي والثقافي للعالم العربي، على اختلاف الديانات السائدة.
باختصار، نحن مدعوّون لإبداع نمط جديد من الإحساس والتفكير والعيش، والعمل، بل والصلاة، سعياً وراء مشروع ليس فقط قابلاً للحياة، بل حيويّاً ومُحيِياً للجميع، بكل ما للكلمات من معنى، في احترام للحريات، وكذلك أيضاً للخيارات الشخصية، على صعيد الحياة السياسية والدينية، تحت طائلة موت بطيء، ولكن حتمي!
دمشق