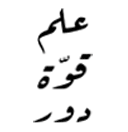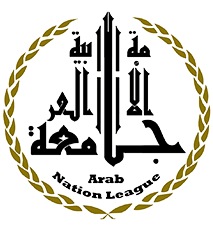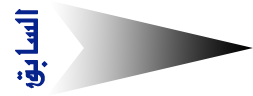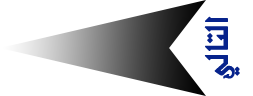الشعر:
حتى تخوم العصر الحديث وبداية الانتداب البريطاني لم تشكل فلسطين طوال العصور الإسلامية وحدة إدارية واضحة المعالم ثابتة الحدود، ولم تظهر فيها دولة تتخذ من إحدى مدنها عاصمة تستقطب النشاط الأدبي والعلمي أو تمهد لنشوئه في رعايتها. ويرى العلاّمة إحسان عباس[ر] «أن الفلسطيني هو من ولد في فلسطين، ومن هاجر منها وبقي لها حضور في نفسه كالحنين وما شابه، ومن هاجر إليها وشارك فعلياً في حياتها الثقافية، أما من هاجر منها وهو صغير فلا يعدُّ فلسطينياً حتى وإن كان نسبه المقدسي أو الغزّي..».
بناء على ذلك وبالرجوع إلى المصادر لم يظهر في فلسطين شاعر مهم قبل القرن السادس الهجري، حتى ظهور أبي إسحاق إبراهيم الغزّي[ر] الذي طاف في المدن والبلدان مادحاً الكبراء والعلماء شاكياً تبدل الأحوال حتى وافته المنية في مرو (524هـ/1130م)، وامتاز شعره بجزالة اللغة وتطويع العبارة وتوليد المعاني. ويليه في الأهمية الشعراء العسقلانيون السبعة (ابن أبي الشخباء والمعتمد والقاضي أمير الدولة وابن بلبل النحوي والمكربل وأبو الفتيان مفضل وابن قائد العسقلاني) الذين اتصلوا بالدولة الفاطمية ورجالها من دون أن يقطعوا صلتهم بعسقلان، وهم شعراء مترسلون قادرون على الشعر والنثر معاً، وهم في المقام الأول من شعراء المديح، يخالط شعرهم بعض الغزل. ويُلحَق بهم القاضي الفاضل[ر] الذي كان على صلة وثيقة بصلاح الدين الأيوبي واشتهر برسائله ذات الطريقة الجديدة في الإنشاء، والذي تميز أدبه شعراً ونثراً على حد سواء.
وفي عصر المماليك احتلت مدينة صفد مكانة مرموقة سياسياً وثقافياً؛ فبرزت فيها مجموعة من أسماء العلماء المدرسين والأدباء، مثل الشاعر نجم الدين الصفدي وصلاح الدين الصفدي الذي كان أقوى وأغزر شعراء عصره. يورد المحبي في كتابه «نفحة الريحانة» أسماء عدد كبير من شعراء القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين من مناطق القدس والخليل والرملة وصفد، أبرزهم محمد الصوفي العلمي وحافظ الدين العجمي ومرعي الكرمي وبشير الخليلي وخير الدين الرملي وأحمد الخالدي الصفدي وحسن الدرزي العيلبوني ممن كان لهم صولات وجولات في الشعر والنثر، على اختلاف مواهبهم، وحجم نتاجهم، وتنوع موضوعاتهم، إلا أن دراسة أعمالهم تشير بوضوح إلى تأثير الحكم العثماني السلبي في الثقافة العربية، وتدل على بداية تراجع لافت على مختلف الصعد، بلغ ذروته في عصر الانحطاط. وتجلى هذا التطور على نحو صريح في القرن الثاني عشر للهجرة حسبما يُستنتج من كتاب «تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر» لحسن بن عبد اللطيف الحسني وكتاب «سلك الدرر» للمرادي. ويرى إحسان عباس: «إن الشعر بعامة كان ضحية الإحباط لفقدانه لموضوعاته الصحيحة.. وهذا يصدق حقاً على العصر كله»، والحقيقة الصريحة: «هي أن المدن الفلسطينية منذ القرن الخامس حتى الثاني عشر للهجرة، لم تنجب شاعراً واحداً متفوقاً، يقف في صف واحد وشعراء بلاط سيف الدولة في حلب في القرن الرابع، أو يوازي شعراء المعرّة وحدها في عصر أبي العلاء... فهل نحمل ذلك على أن الفكر لدى أبناء تلك المنطقة كان أقوى دائماً من الخيال؟... قد يكون ذلك صحيحاً».
مع هبوب رياح التغيير القادمة من الغرب الأوربي نحو الشرق العربي منذ القرن الثالث عشر للهجرة (ق19م)، أي مع الامتيازات التي أحرزتها دول الغرب للتدخل في شؤون بلدان المنطقة، ومع انتشار المدارس التبشيرية، وبعض المدارس الحديثة تأثراً بما جرى في لبنان ومصر، بدأت ملامح شعر جديد تظهر في فلسطين، ولاسيما في القدس مركز النشاط التعليمي الجديد. وقد تأثر هذا الشعر بـ «حركة الإحياء» التي رادها في مصر محمود سامي البارودي[ر]، من حيث قوة العبارة وجزالة اللغة، لكنه اتخذ اتجاهاً دينياً بحتاً في فلسطين بسبب انتشار الطرق الصوفية ونفوذها، ولبقاء السلطان العثماني رمزاً لرابطة الجماعة الإسلامية، بما يعني أن فكرة القومية العربية والمصالح العربية كانت غائبة؛ فتطور شعر المديح في منحيين، المدائح النبوية كما في شعر الشيخ يوسف النبهاني (1350هـ)، والمدائح السلطانية عند بعض الشعراء الآخرين. ومع المتغيرات الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أحدثها دستور 1908 العثماني، ومعاناة الشعب العربي في كارثة «السفربرلك»، والحرب العالمية الأولى، ومحاولة العرب الانفصال عن الدولة العثمانية في ما سمي «الثورة العربية الكبرى»؛ أدخلت على الشعر بعض الموضوعات الجديدة على الصعيدين الاجتماعي والوطني، كما التفت الشعر إلى المخترعات الحديثة كالقطار والطائرة. وكان أبرز شعراء تلك المرحلة خليل السكاكيني وإسعاف النشاشيبي وأبو الإقبال اليعقوبي، مما يشير إلى أن حظ فلسطين من الشعر الصحيح آنذاك كان ضئيلاً.
ويمكن القول إن وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني قد غيّر الأوضاع على نحو جذري تقريباً، فقد صارت المواجهة آنذاك على جميع الأصعدة مع سلطة أجنبية طاغية ومتطورة تمهد الطريق بالسبل كافة لتحقيق المشروع الصهيوني، فحدثت انتفاضات عدة عفوية وغير منظّمة، خنقها الاستعمار بعنف، تلتها ثورة القسام عام 1936 وثورة الفلاحين عام 1939. والتغيرات التي طرأت على الحركة المجتمعية في ظل الاستعمار وفي إطار مواجهة صريحة معه فرضت على الشعر الفلسطيني موضوعات جديدة تندرج تحت مفهوم الشعر الوطني السياسي، الخطابي الحماسي. واللافت أن تصوير هذا الشعر للجوانب السلبية كان أوضح من تناوله الجوانب الإيجابية، كما هي الحال في معظم الشعر الوطني في البلدان العربية الأخرى، فندّد بسياسة الانتداب وتحيّزها إلى الصهيونية، وحذّر من خطر الهجرة اليهودية، وأشاد بالمقاومة الشعبية، وخلّد البطولات ومجّد الشهداء، وحضّ على الوفاق الوطني من أجل التحرير، كما ندّد بباعة الأرض وعملاء الاستعمار والانتهازية والصراعات الحزبية وغيرها من السلبيّات. وكان هدف الشعراء هو التوعية والوصول السريع المباشر إلى نفوس الناس. ومن حيث تطور الشكل الفني يمكن عد عام 1930 بداية لافتة مع قصيدة إبراهيم طوقان[ر] «الثلاثاء الحمراء» التي خلّد فيها الشهداء الثلاثة الذين شنقوا في تلك السنة، وفي قصيدة إسعاف النشاشيبي التي رثى فيها أحمد شوقي، فكانت أول قصيدة عربية تخرج من إسار القافية وعدد التفعيلات. إلا أن هاتين المحاولتين البارزتين لم تتركا أثراً واضحاً في سياق الشعر الفلسطيني لأنهما جاءتا أشبه بالمصادفة من دون استمراريّة. ومن شعراء تلك المرحلة إسكندر الخوري البيتجالي وبرهان الدين العبوشي ومحمد العدناني وعبد الرحيم محمود وعبد الكريم الكرمي[ر] ووديع البستاني وحسن البحيري ومحمود الأفغاني. لكن الدراسات لم تلتفت للأسف إلا إلى الكرمي وطوقان ومحمود، لذلك يصعب تقييم أشعار هؤلاء من الناحية الفنية، إلا أن المشترك بينهم جميعاً هو الموضوعات السابقة الذكر. وحسب إحسان عباس ليس بينهم من شاعرٍ سوى طوقان، «يتلوه أبو سلمى ولكن لا يدانيه».
كانت نكبة عام 1948 منعطفاً حاسماً في تطور الأدب الفلسطيني، فصارت شخصيّة «اللاجئ» بكل ما تعنيه من أبعاد إنسانية وسياسية محوراً رئيسياً في الشعر والنثر والمسرح. وقد استمرت حالة الانذهال بما حدث وبأصدائه في المهاجر العربية حتى الغزو الثلاثي لمصر عام 1956 وظهور شخصية «البطل المنقذ» جمال عبد الناصر في دعوته الوحدوية «التي كانت (خشبة الخلاص) في تصوّر الشاعر الفلسطيني»، والتي تحققت عام 1958. وعلى الرغم من انفصام الوحدة السورية المصرية، وخيبة الأمل بما كان معلقاً على الثورة العراقية، طغى على الفلسطيني شعور بأن العودة باتت في الأفق القريب، ما دام «المنقذ» قد جعل القضيّة الفلسطينية قضية العرب الأولى، وقضية دولية أيضاً.
وفي الوقت نفسه برزت مسألة انقسام الأدب الفلسطيني ما بين الداخل (الأراضي المحتلة) والخارج (المهاجر العربية والأجنبية)، فبينما كان أدب المنافي آنذاك مغرقاً في التشاؤم والاستكانة إلى الإنقاذ المرتقب، كان شعر الأرض المحتلة يمثِّل الإصرار على المقاومة، كما في قصائد محمود درويش. وفي أثناء هذه المرحلة تأثرت غالبية الشعراء الفلسطينيين بالموجة الشعرية الجديدة التي تجلت في قصائد نازك الملائكة[ر] والسّياب[ر] والبياتي[ر].
ومع النكبة الثانية عام 1967 تفرّقت سبل التعبير الأدبي في وجهات جديدة، رادها في الستينيات والسبعينيات توفيق زياد[ر] ومحمود درويش وسميح القاسم، وإضافة إلى يوسف الخطيب وهارون هاشم رشيد ومحمود سليم الحوت وتوفيق صايغ وجبرا إبراهيم جبرا وكمال ناصر ومعين بسيسو وسلمى الجيوسي، وغيرهم. وقد توزّعت الشعراء الفلسطينيين تيارات رئيسية ثلاثة، متعايشة ومتصاهرة، هي: الاتباعيون، والمخضرمون، والمحدثون. وأخذت دواوين هؤلاء وقصائدهم تنتشر على الصعيد العربي عبر دور النشر اللبنانية، وإذاعة فلسطين من دمشق. وكان غسان كنفاني قد نشر عام 1966 «أدب المقاومة في فلسطين المحتلة» وأعقبه عام 1968 بكتاب «الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 1948- 1968» وقد تميّز الشعر الفلسطيني في تلك الآونة بتأثّره بموجة الشعر الحر التي راجت في الشعر العربي المعاصر، وبالمزاوجة بين الشكلين التقليدي والحر، وبتعلقه بالتراث والتاريخ والأسطورة، وباستلهامه أفكار الواقعية الاشتراكية والقومية العربية مع أفول الرومنسية ونمو الرمزية، وبالتأثر على نحو لافت بأسلوبي لوركا[ر] وماياكوفسكي[ر]، وبالبحث المستمر عن شكل شعري جديد يستوعب الهزة الحضارية المستجدة بلغة قادرة على مواجهتها.
نشأ في الأرض المحتلة في السبعينيات جيل شعري جديد، وازاه جيل آخر خارجها في العواصم العربية المحيطة، وفي قصائد كلا الجيلين ثمة حساسية مرهفة مؤسَّسة على واقعية صلبة. ومن شعراء جيل الداخل على سبيل الذكر لا الحصر عبد اللطيف عقل وعلي الخليلي وميشيل حداد وليلى علوش وسميرة الخطيب وجمال قعوار وأنطوان شماس وفدوى طوقان ويعقوب حجازي. ومن شعراء جيل الخارج خالد أبو خالد ومي صايغ ووليد سيف ومعين بسيسو ومحمود صبح ويوسف الخطيب وناجي علوش وعز الدين المناصرة ومحمد القيسي وعصام ترشحاني وصالح هواري.
يرى الباحث محمود شريح أن الشعر الفلسطيني في الأرض المحتلة وخارجها، من حيث مضمونه، قد جرى «في خمسة مجارٍ رئيسية: فهناك المجرى الذاتي الغنائي، وفيه عبّر الشعراء عن مشاعرهم في قصائد غزلية ووصفية. وهناك مجرى وطني، وفيه عبّر الشعراء عن انتمائهم الفلسطيني. ومجرى قومي عبّر فيه الشعراء عن انتمائهم العربي. والمجرى الرابع أممي نادى الشعراء عبره بتأييدهم الثورة في كل مكان في وجه التعسف والاضطهاد والاحتلال. أما المجرى الخامس فإنساني قدّم الشعراء عبره نماذج وصوراً إنسانية».
وقد قامت المجلات المتخصِّصة، مثل «الكاتب الفلسطيني» التي صدرت في دمشق (1978-1980)، ومجلة «الكرمل» التي صدرت في بيروت عام 1981 ثم انتقلت إلى نيقوسيا، ومجلة «شؤون فلسطينية» التي صدرت في بيروت عام 1971، بدور المنبر الرائد لعيون الشعر الفلسطيني المعاصر وكانت إسهاماً فعلياً في نقده وتوجيهه. ومن الأسماء التي برزت في هذه المجلات، غير من سبق ذكرهم، مريد البرغوتي وأمجد ناصر وأحمد دحبور وخيري منصور وصخر. وسواء في ما نشر في هذه المجلات، أو الصحف في الداخل والخارج، أو في الدواوين، فقد تعددت موضوعات الشعر الفلسطيني المعاصر وتنوّعت، إلا أنها دارت جميعها ضمن محاور رئيسية هي: إحساس مؤلم بالمنفى وضياع الوطن وإخفاق الثورة، وعزم على التصدي لمأساة المنفى بالثبات والنضال، وبالتأكيد على الهوية الفلسطينية والاعتزاز بالقومية العربية وبمنجزات الثورة الفلسطينية، وبفهم واع ٍ لمراحل النضال وحدس تاريخي مرهف وتأريخ الواقع بهدف اختزان التجربة في الذاكرة. ويمكن تحديد سمات منجزات التجارب الشعرية الفلسطينية ما بعد نكسة عام 1967 بازدهار التيار الواقعي المتكئ على غنائية تستفيد من طاقات النشيد والقصة والخطاب والمسرح والرسالة، وباستخدام الأسطورة المحلية، ولاسيما منها التموزية في مجلة «شعر»، وبإثراء القاموس الشعري الحديث ورفده بمفردات نابعة من خصوصية التجربة الفلسطينية، وباللحاق بركب الشعر الحديث عالمياً من حيث تجديد القالب وتشكيله مع اقترابٍ من روح السريالية، وبعودة إلى وجدانية تهمس بالمألوف والمعاش لتوحي بالأمل، كما في بعض قصائد إبراهيم نصر الله ووليد سيف والمناصرة والقيسي.
كان محمود درويش أحد شعراء المقاومة البارزين في الأرض المحتلة؛ مما عرّضه لمشكلات متلاحقة مع سلطة الاحتلال، فحزم أمره وخرج عام 1971 ليستقر في بيروت حيث تابع عمله الصحفي، ولكن في مجلة «شؤون فلسطينية»، ثم في مجلة «الكرمل» الأدبية الفكرية التي احتلت مكانة متقدمة ومتميزة في الأوساط الثقافية العربية؛ لجرأتها ورصانتها وانفتاحها على أحدث التيارات العالمية المهمة. وعلى أثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وخروج المقاومة الفلسطينية، تنقَّل درويش بين قبرص وتونس وفرنسا والأردن إلى أن عاد إلى الأرض المحتلة واستقر في رام الله التي صيَّرها الإسرائيليون ميدان حرب عام 2002. وبعد مرحلة الشعر الصدامي التحريضي السياسي المقاوم أخذ شعره ينحو بالتدريج نحو الموضوعات الفكرية والتأمّل الفلسفي، فتراجع بريق شعره على الصعيد الجماهيري وتعمّق اهتمام النقد بمضامين قصائده الجديدة وتجلياتها على صعيد التعبير الفني. وهو من الشعراء الفلسطينيين القلائل الذين تُرجمت قصائدهم إلى لغات عدة، فتجاوز تأثيره النطاق المحلي إلى الأفق العالمي، وصار يُعدُّ بين كبار شعراء القرن العشرين. وقد حاز درويش كثيراً من الجوائز العربية والدولية.
وعلى صعيد تطورات الشعر الفلسطيني بعد اتفاقية أوسلو يحتاج الأمر إلى متابعة متأنية ورصد وافٍ للنتاج الشعري في الداخل والخارج، وكذلك على صعيد الدراسات النقدية التي تناولته وهذا ما لم يتوفر حتى اليوم بصورة كافية.
القصة:
قامت الصحف والمجلات في فلسطين ولبنان بدور مهم في التعريف بفن القصة والرواية عن طريق الترجمة من اللغات الروسية والفرنسية والإنكليزية منذ بدايات القرن العشرين، وكان الرائد على مستوى الترجمة والتأليف في فلسطين خليل بيدس صاحب مجلة «النفائس العصرية» التي أسسها عام 1908. ومن بعده ظهرت أسماء محمود الإيراني ونجاتي صدقي وعبد الحميد ياسين وجبرا إبراهيم جبرا وعارف العزوني وعلي كمال ونجوى قعوار فرح. وما يلفت النظر في المجموعات القصصية لبعض هؤلاء هو غلبة الأجواء الأوربية عليها من حيث التقاليد الاجتماعية، على الرغم من أن بعض شخصياتها يحمل أسماء عربية، مما يشي بالاقتباس عن أصول متفرقة. وقد كانت غاية الكتّاب دائماً الموعظة الأخلاقية والتثقيف. ويرى يعقوب العودات في كتابه «من أعلام الفكر والأدب في فلسطين» أن محمود الإيراني صاحب مدرسة حديثة في فن القصة القصيرة، كما عدَّه مؤرخو الأدب الفلسطيني المعاصر الرائد الأول للقصة الفلسطينية التي اسـتوحت موضوعاتها من الواقع المعيش بأسـلوب يراوح بين الطبيعية[ر] والواقعية، ويليه في الأهمية والتأثير نجـاتي صـدقي. ومع مجموعـة «عَـرَق وقصص أخـرى» (1956) لجبرا إبراهيم جبرا خَطَتْ القصة الفلسطينية خطوة فنية لافتة، إذ خرجت على مفهوم الدور التربوي المرشد للأدب إلى عدّ الفن غاية في ذاته، ولا يجوز أن يكون وسيلة، وإلا هبط مستواه. وقد عزف علي كمال كما جبرا على الوتر نفسه.
بعد نكبة 1948 صار للأحداث التاريخية تأثيرها في الواقع الاجتماعي وتطوراته، وهذا هو ما ظهر في القصص الجديدة، حيث تلمَّس النقد الأدبي نقلة نوعية نحو رؤية واقعية عميقة تربط بين الحركة الاجتماعية الاقتصادية وبين الممارسة السياسية لسلطة الاحتلال، وأثرها في حياة الإنسان الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها. وكان إميل حبيبي أول من طرح مأساة اللاجئ في قصته «لا حيدة في جهنم...!» (1948). ويعد أمين فارس ملحس رائد الواقعية الاشتراكية في القصة الفلسطينية، ولاسيما في قصتيه «مرزوق» و«صبرية» (1952). ومنذئذٍ تتالت المجموعات القصصية المتباينة المضامين والأشـكال لنبيـل خـوري في «كُـفر» (1952) ولمحمد أديب العامري في «شعاع النور وقصص أخرى» (1953) ولسميرة عزام في «أشياء صغيرة» (1954) و«الظل الكـبير» (1956) و«قصص أخرى» (1960). وكان إميل حبيبي قد نشر عام 1954 قصة ذات دلالة بالغة بعنوان «بوابة مَنْدلباوم» (المكان الوحيد الذي كان يُسمح للفلسطينيين عبوره إلى القدس في أثناء احتفالات عيد الميلاد) حيث يصور سلوك طفلة تتحرك بين جانبي البوابة من دون أن تدرك خطورة الحالة. وفي مجموعتها الرابعة «الساعة والإنسان» (1961) طرحت سميرة عزام أول مرة مسألة مخيمات اللاجئين ومآسيها. وفي العام نفسه أصدر غسان كنفاني مجموعته القصصية الأولى «موت سرير رقم 12»، تلتها عام 1963 مجموعة «أرض البرتقال الحزين» ثم «عالم ليس لنا» (1965) ثم «عن الرجال والبنادق» (1968). وعبر قصص هذه المجموعات يتطور فن القصة بين يدي كنفاني على صعيد المضمون والشكل معاً؛ إنه يعالج مأساة الفلسطيني منذ فجيعة النكبة الأولى حتى النكبة الثانية عام 1967 متتبعاً مختلف المصائر وأشكال العيش والبحث عن الهوية، هوية الذات والوطن، حتى الوصول إلى حل المقاومة والتمسك بالبندقية مَخْرَجاً من عذابات الاحتلال في الداخل وشتات المخيمات في الخارج. ويعتمد كنفاني في قصصه لغة مكثفة زخمة بالإيحاء والدلالة الغنائية، تنوس في تصويرها الحدثَ بين الواقعية الصارخة أحياناً والرومنسية المجنّحة أحياناً أخرى، راسماً إطار الحدث تارة بضربات سريعة من ريشة حاذقة، وغائصاً تارة أخرى، عند لحظات حساسة معينة، إلى أدق تفاصيل المشهد، مانحاً القارئ إمكانية مشاركته في الوصول معاً إلى الهدف المقصود من هذه القصة. وفي عام 1968 صدر في الناصرة لتوفيق فياض مجموعة «الشارع الأصفر» التي تجاوز الكاتب في قصصها «طابع السرد التقليدي ليصل إلى نوع جديد من التركيب الحديث مع تضمين القصة أبعاداً عدة واقعية ورمزية، تمزج بين الوطن والتراث، فتكتسب مضمونها الكفاحي والرمزي من دون أن تهمل القضايا الاجتماعية اليومية».
بعد نكسة عام 1967 أصدر إميل حبيبي «سداسية الأيام الستة» ذات البناء القصصي المحكم، فكانت تمهيداً قوياً لتجارب الكتّاب الشباب داخل الأراضي المحتلة وخارجها، ولاسيما في المجلات. وقد تنازعت هذه التجارب تيارات الواقعية والمثالية والرومانسية والرمزية، بل حتى الواقعية التسجيلية، واهتم الكتّاب على تنوع مشاربهم بنقل أوضاع الإنسان الفلسطيني في نضاله اليومي، وبتقديم أنماط من الصراع الاجتماعي في القرية الفلسطينية، وبتصوير أحوال المخيمات. وفي هذه المرحلة خسرت القصة القصيرة في الأراضي المحتلة جيلاً مهماً وذلك لخروج الكتّاب محمود شقير ويحيى يخلف ورشاد أبو شاور وخليل السواحري وغيرهم إلى البلدان العربية المجاورة حيث أخذوا ينشرون أعمالهم الجديدة في «الكاتب الفلسطيني» و«الكرمل» وغيرها، كما نشروا من ثم مجموعاتهم الخاصة. وفي الوقت نفسه اهتمّت بعض دور النشر بإصدار مختارات من القصص الفلسطينية مثل «27 قصة فلسطينية من المناطق المحتلة» و«ثلاثة أصوات» و«مختارات من القصة الفلسطينية في الأرض المحتلة» يمتزج فيها الهمّ الاجتماعي بالهمّ السياسي ويتعمّق تصوير النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما برز فيها التركيز على فئات الشعب الكادحة. وقد استفاد كتاب هذه المجموعات وغيرها من تقانات السرد والحوار و«المونولوغ» الداخلي وتداعي الأفكار والاسترجاع والرمز.
إن أكثر المجموعات القصصية الفلسطينية التي صدرت في أثناء السبعينيات في بيروت ودمشق وعمان والأراضي المحتلة كانت في المقام الأول رصداً لحياة الفلسطيني بعد عام 1967 في الداخل والخارج، ومتابعة تفصيلية لتطور أشكال المقاومة وانعكاساتها على الفرد والمجتمع معاً، في محاولة لتجاوز ذيول النكسة.
وفي أثناء الثمانينيات حتى توقيع اتفاقية أوسلو استمرت القصة تعالج الموضوعات نفسها التي سبق أن تناولتها منذ النكسة في ما يتعلق بالإنسان الفلسطيني وقضيته في الداخل والخارج العربي وعلى مستوى السياسة العالمية، فظهرت مجموعات قصصية متعددة لزكي العيلة وتوفيق فياض ويوسف ضمرة وأكرم هنيِّة وماجد أبو شرار وعلي حسين خلف وصبحي شحروري وإبراهيم العلم وسعيد الشيخ ومحمود علي السعيد وإبراهيم العبسي وغيرهم. وفي قصص هذه المجموعات كان الكتّاب يلجؤون أحياناً إلى لغة شاعرية مشبعة بالرمز ومثقلة بالحنين لتؤسطر صورة العودة إلى الوطن، كما لجؤوا في أحيان أخرى إلى الاستعانة بصور مشرقة من التراث بهدف بث الأمل.
الرواية:
إن معظم من خاضوا تجربة الكتابة الروائية في فلسطين قبيل عام 1948 لم يتجاوز إنتاجهم روايةً يتيمة، مثل «الوارث» (1920) لخليل بيدس، و«مذكرات دجاجة» (قبل 1948) لإسحق موسى الحسيني، و«في السرير» (1946) لمحمد العدناني. أما رواية «صراخ في ليل طويل» لجبرا إبراهيم جبرا فيرجِّح معظم النقاد أنها كُتبت بعد 1948. ولاشك في أن كثيراً من الأعمال الروائية قد ضاعت أو أُتلفت في أثناء أحداث النكبة. وفي أثناء الخمسينيات صدرت للكاتب راضي عبد الهادي روايات عدة مثل «الشهيد» (1950) و«البطل» (1950) و«فارس غرناطة» (1952) و«كوكو» (1957) وفي الفترة نفسها نشر عبد الحميد الأنشاصي «القيود واليقظة» و«اعترافات عاشق» و«من أجل المال» و«الوفاق الزوجي»، كما صدر للشاعر إسكندر الخوري البيتجالي رواية «الحياة بعد الموت»، وللكاتب الناشر يوحنا دكرت رواية «ظلم الوالدين» و«أصل الشقاء» التي أثارت ضجّة في الأوساط الدينية بسبب توجيه الكاتب إصبع الاتهام إلى رجال الدين. ويندرج معظم هذه الروايات في تيار الرومنسية المتسرِّب عبر أكثر الترجمات إلى العربية، بما فيها رواية جبرا التي ينبو سلوك شخصياتها عن الواقع العربي المعيش آنذاك، علماً أنه كتب صيغتها الأولى باللغة الإنكليزية، أما الصيغة العربية بقلمه فقد نُشرت عام 1955، وقد أرَّخت هذه الرواية لتحولٍ فني روائياً، ولتحولٍ اجتماعي أخذ يتسرب إلى بنية المجتمع العربي. أما روايات يوسف الخطيب وتوفيق معمر ومحمود عباس وعطا الله منصور وفهد أبو خضرة فقد عالجت البؤس الاجتماعي والفروق الدينية والقومية ضمن إطار واقع نكبة 1948 وما نتج منها.
أصدر جبرا روايته الثانية «صيادون في شارع ضيق» (1960) بالإنكليزية، وترجمت وصدرت لاحقاً بالعربية. ويصوّر فيها الكاتب الحياة الاجتماعية للشعب الفلسطيني على أثر النكبة، والحياة الاجتماعية في بغداد، حيث التجأ بطله الفلسطيني العائد من الدراسة في إنكلترا. وهي رواية فكرية في المقام الأول، ومحورها هو فكرة الضياع. أما رواية غسان كنفاني الأولى «رجال في الشمس» (1963) فتصور مشاق الرحلة الفلسطينية بحثاً عن الخلاص في الشتات العربي، وقد تحولت الرواية إلى فيلم مهم في تاريخ السينما العربية، وصدرت روايته الثانية «ما تبقى لكم» (1966) وكأنها تتمة للأولى على اختلاف استخدام الزمان والمكان في تأطير الحدث، فالرحلة عبر الصحراء لم تعد هنا مكاناً للموت المجاني بل ساحة مواجهة مع المحتل الإسرائيلي. لقد خلخلت روايتا كنفاني البنية الروائية التقليدية، واتضحت في الثانية تقنية تيار الوعي التي تأثر فيها بوليم فوكنر في «الصخب والعنف». أما بعد 1967 فقد كثرت الروايات الفلسطينية التي حاولت استيعاب الوقائع الجديدة، وكانت بوادرها في الأرض المحتلة «سداسية الأيام الستة» (1967) ذات البنية القصصية. واللافت هو أن الرواية الجديدة يسودها التفاؤل والفرح النابع من دخول البندقية إلى المخيمات. وثمة اتجاه آخر في الرواية بات يبحث في أسباب الهزيمة عربياً. تُقدِّم قصص أو لوحات «السداسية» تنويعات حول لحن واحد هو الحلم بالعودة واللقاء، وعلى الرغم من اختلاف النقاد العرب في تصنيفها شكلاً فقد أجمعوا على أنها إضافة مهمة إلى فن السرد العربي.
رأى أمين شنّار في روايته «الكابوس» (1968) أن سبب الهزيمة يكمن في هجر الناس للدين، ولا خلاص لهم إلا بالعودة إليه. أما كنفاني في «عائد إلى حيفا» (1969) فإنه يعيد إلى الأذهان فكرة «الماضي والمستقبل» في ضوء هزيمة 1967. وكان جبرا قد عالج الفكرة نفسها في «صراخ في ليل طويل» (1955) ثم في «السفينة» (1970). وتعد وقفة كنفاني في «عائد إلى حيفا» إطلالة جديدة على «رجال في الشمس» وعلى «ما تبقى لكم» وأول مرة يلتقي هنا الفلسطيني والصهيوني خارج ساحة القتال، فيتحاوران تحت سقف واحد.
وقد تزامن صدور رواية كنفاني «أم سعد» مع تصاعد العمل الفدائي، الأمر الذي جعلها تستمد أحداثها وأبطالها من المخيم الفلسطيني الذي أصبح بوتقة للكفاح المسلح. وهنا تتغير علاقات الناس وتتبدل نفسياتهم من خلال تعاملهم اليومي مع نقيض الهزيمة. ومن حيث الشكل الفني بنى كنفاني روايته من تسع قصص أو لوحات بطلتها أم سعد، والأحداث تنمو وتتطور بتتابع اللوحات لتقدِّم في النهاية عالماً متكاملاً. وثمة في الرواية عوامل كثيرة تقرِّبها من مفهوم البطل الإيجابي (القدوة) في الواقعية الاشتراكية.
صدرت رواية جبرا «السفينة» عام 1970 محمَّلة بالموضوع والذات معاً بلغة شاعرية وبنية فنية متينة، فعلى متن السفينة ثمة مسافرون عرب تتنازعهم مشكلات بلادهم، «وكلٌ من المبحرين يصعد إلى السفينة كالجسم، للخلاص من أدران الماضي الذي يسافر هرباً منه في سفينة يونانية تبحر من مرفأ بيروت إلى الغرب وسط تأمل رومنسي في (الخلاص)». تبعت «السفينة» في السبعينيات روايات كثيرة عالج أصحابها المشاغل نفسها، كل بحسب موقعه على خارطة الشتات الفلسطيني، كامتثال جويدي وعطية عبد الله عطية وهارون هاشم رشيد وهيام رمزي الدردنجي. وفي عام 1974 أصدر نبيل خوري «ثلاثية فلسطين» التي ضمّت «حارة النصارى» و«الرحيل» و«القناع»، ولم تكن الثورة فيها موضوعاً رئيسياً بل امتداداً للنكبة والرحيل، واستكمالاً لتأريخ المأساة الفلسطينية وانطلاقة الثورة، والصدام مع النظام في الأردن. وفي عام 1973 نشر رشاد أبو شاور رواية «أيام الحب والموت» ثم «البكاء على صدر الحبيب» (1974) وكان فيصل حوراني قد أصدر عام 1973 روايته «المحاصرون» حول أحداث أيلول (سبتمبر) في الأردن 1970، كما رواية أبو شاور الأخيرة. أما توفيق فياض فقد عبّر في روايتيه «المجموعة 778» (1974) و«حبيبتي ميليشيا» (1975) عن قضايا الثورة في الأرض المحتلة عقب نكسة 1967، وعن دور الميليشيات الشعبية في الأغوار ودور المرأة في العملية الثورية.
كان صدور رواية إميل حبيبي «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل» في حيفا صيف عام 1974 ثم في بيروت خريف العام نفسه مَعْلماً بارزاً في تطور الرواية الفلسطينية، بل العربية شكلاً ومضموناً. بنى الكاتب متن روايته من مجموعة رسائل وصلت إلى الراوي «المحترم» من نزيل في مستشفى الأمراض العقلية داخل السور في عكا، أي من البطل الروائي سعيد أبي النحس المتشائل (وهذا إدغام لصفتي متشائم ومتفائل). لكن حبيبي في صياغته الروائية استفاد من التراث الأدبي العربي ولاسيما من المقامة، وكان بارعاً في نسجها مع الأساليب الروائية المعاصرة على نحو شفاف غير مباشر ومفعم بالسخرية، حيث يتعرف القارئ تاريخ فلسطين وشعبها ومدنها وقراها منذ الاحتلال الأول عام 1948 حتى بدايات السبعينيات. وحجر الأساس في السرد هنا هو أسلوب تداعي الأفكار، مع تمسكٍ بالنكهة المحلية، مما يكاد يحوّل الرواية إلى سيرة شعبية تسكب المرارة في قالب السخرية الضاحك.
أما سحر خليفة في روايتها «الصبار» فقد عالجت مختلف القضايا التي تشغل الفلسطيني داخل الأرض المحتلة، وحلّلت البنية الاجتماعية، وعرّت المواقف السياسية والاجتماعية. وفي الجزء الثاني من الرواية «عبّاد الشمس» (1980) تناقش الكاتبة مشكلة المرأة في الأرض المحتلة. وفي عام 1977 صدر للكاتبة سلوى البنا رواية «الآتي من المسافات»، متَّخِذة من الحرب الأهلية في لبنان محوراً لها. وفي العام نفسه صدر لتوفيق المبيض رواية «أسطورة ليلة الميلاد» التي وظَّفَت بتوازٍ في البنية الروائية الأسطورةَ التاريخية والشعبية مع انطلاقة المقاومة الجماهيرية في غزة. وتتالت من ثم روايات أحمد عمر شاهين وأفنان القاسم وسميح القاسم في أجواء مقاربة، وأشكال فنية تنشد التجريب والتجريد.
بلغ جبرا إبراهيم جبرا ذروة إبداعه الروائي في «البحث عن وليد مسعود» التي صدرت في بيروت عام 1978، والتي عالج فيها جوهر تجربة الإنسان الفلسطيني المثقّف في غربته، في إطار تحليلي يسبر أغوار شخصيات الرواية من فلسطينيين وعراقيين في بغداد، مكان الأحداث في أوساط المثقفين والأكاديميين من كلا الجنسين. ولربما كانت هذه الرواية أكبر محاولة بذلها النثر الأدبي الفلسطيني إضافة إلى إنجازات كنفاني، بهدف تقديم عمل روائي يعبّر عن الشعور الفلسطيني في الطور الراهن من تطوره.
كان عام 1979 حاشداً بالإنتاج الروائي الفلسطيني، ففي أثنائه صدرت «شمس الكرمل» لنواف أبو الهيجاء، و«الفلسطيني الطيب» لعلي فودا، و«العصافير لا تموت في الجليد» وكذلك «الشوارع» لأفنان القاسم، و«بير الشوم» لفيصل حوراني، و«الطوق» لغريب عسقلاني. وفي عام 1980 صدرت رواية الشاعر سميح القاسم «الصورة الأخيرة في الألبوم: قصة من الأراضي المحتلة»، و«المفاتيح تدور في الأقفال» لعلي الخليلي، و«مدام حرب» لأفنان القاسم، و«تفاح المجانين» ليحيى يخلف. وفي بدايات الثمانينيات صدرت لسامي أبو النور روايته التسجيلية «يوم في حياة الشيخ صابر أيوب»، و«الطين الشوكي يصدر قريباً» لعبد الله التايه، و«نشيد الحياة» ليحيى يخلف. أما عام 1985 فقد صدرت لإميل حبيبي رواية «اخطيّه» في «صياغة متقنة لمفهوم الحنين في إطاره المكاني، وإعادة نظر في الحاضر في ضوء التراث، وكتابة جديدة للتاريخ الفلسطيني المعاصر بمداد الجرح ـ المأساة». وفي أثناء التسعينيات برز في عمان اسم الشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله برواياته «عَوْ» و«مجرد 2 فقط» و«براري الحمى» و«فضيحة الثعلب»، وفي دمشق حسن حميد بروايته «جسر بنات يعقوب».
المسرح:
يعود تعرّف الجمهور في فلسطين على المسرح إلى الزيارات التي قامت بها الفرق الشامية والمصرية المحترفة التي كانت تستنفذ جمهورها في مدنها فتبحث عن مصادر الرزق في مناطق بكر مسرحياً. وفي مرحلة الانتداب البريطاني كانت السلطات تفضِّل تقديم المسرحيات المترجمة عن المسرح العالمي على تقديم الأعمال العربية أو المؤلّفة محلياً، مثل أعمال نصري الجوزي وجميل بحري وغيرهما ممن نُشرت بعض أعمالهم وبقي الآخر مخطوطاً غير موثّق. وما يلفت النظر وجود أكثر من ثلاثين فرقة مسرحية في القدس وحدها. وعلى الرغم من تباين مستوياتها الفنية وإمكاناتها المادية فقد قدمت كثيراً من النصوص المحلية بالعربية الفصحى، ومنها لجميل بحري «الوطن المحبوب» و«الخائن» و«في سبيل الشرف» وغيرها كثير؛ أما نصري الجوزي فقدَّم لها إحدى عشرة مسرحية منها «العدل أساس الملك» و«الحق يعلو» و«تراث الآباء» إضافة إلى بعض مسرحيات الأطفال مثل «صور من الماضي». وإضافة إلى هذين المسرحييّن أسهم في حركة التأليف المسرحي كل من برهان الدين العبوشي ومحمد حسن علاء الدين ومحي الدين الصفدي ومحمود محمد وبكر هلال. واستمدّ هؤلاء الكتّاب موضوعات مسرحياتهم من التراث العربي التاريخي والديني، وكذلك من أحداث الواقع المعيش، وكان هدفهم المعلن استنهاض مشاعر العروبة ضد سلطات الاحتلال ومحاولات تهويد فلسطين. ولم تَسْلَم بعض هذه الأعمال المنشورة ذات الصبغة السياسية الواضحة من قمع سلطات الانتداب وتدخلها المباشر لمنع عرضها، خوفاً من تأثيرها المتوقّع.
وحينما توصلت الصهيونية العالمية إلى تحقيق مشروعها بإنشاء دولة «إسرائيل» أصيبت الحركة الفكرية الفنية في فلسطين، ومنها المسرح، بضربة قاصمة شتّتت عدداً من المثقفين والفنانين في الدول العربية المجاورة وفي المنافي القصية. وهاجر معظم المسرحيين إلى الأردن وبدؤوا هناك بتجديد فعاليتهم المسرحية المرتبطة بقضيتهم: اغتصاب الأرض وتهجير الشعب. وكذلك كان الأمر على صعيد من لجؤوا إلى سورية ولبنان. أما من بقوا في الأرض المحتلة فقد استعادوا نشاطهم بعد مرحلة كمون قسري، ووجدوا لهم مؤيّدين من بينهم يهود ناطقون بالعربية قادمون إلى «إسرائيل» من بلدان عدة عربية، ولاسيما من العراق ومصر، مثل «متاحو إسماعيلي» اليهودي المصري الذي ألَّف فرقة قَدَّمت بالعربية الفصحى مسرحية «تعويذة الهند» عن المهاجرين الشرقيين إلى فلسطين، ومثل فرقة اليهود العراقيين التي قدَّمت مسرحية أحمد شوقي «مجنون ليلى» بنجاح كبير.
ومنذ الستينيات بدأت تتألف مجموعة من الفرق المحترفة وشبه المحترفة، تناولت في عروضها قضايا الإنسان الفلسطيني داخل الأرض المحتلة في مواجهة السلطات الإسرائيلية، وقضية الهوية والانتماء، ومعاملة الفلسطينيين كأقلية منبوذة لا حقوق لها إلا بما يخدم الإسرائيلي المسيطر، إضافة إلى عروض فنية فولكلورية راقصة بهدف الحفاظ على التراث الفني الفلسطيني حيّاً في مواجهة عملية نهبه الحثيثة من قبل الإسرائيليين وتقديمه للعالم على أنه تراث يهودي عريق يبرر حقهم المزعوم بالأرض. ومن هذه الفرق المسرحية «بَلالين» التي انشق عنها بعض أعضائها وألفوا من الحروف نفسها اسم فرقتهم «بِلا-لين» احتجاجاً على توجّهات الفرقة الأصل. وفي أثناء المرحلة نفسها أُلفت فرقة «دبابيس» وفرقة «صندوق العجب» و«فرقة المسرح الفلسطيني». وفي السبعينات ظهرت فرقة «الحكواتي» التي أدت دوراً مهماً في الحركة المسرحية داخل الأرض المحتلة، عبر فعاليات متعددة، أولها تحويل صالة سينما محترقة إلى مكان للعروض المسرحية، واللقاءات والمحاضرات وغيرها من الأنشطة الفكرية الفنية، وقد رمَّمت الفرقة هذا المكان بجهودها وإمكاناتها الخاصة، وثانيها لجوء الفرقة إلى أسلوب التأليف الجماعي والارتجال حول قضايا تَهمّ الجمهور الفلسطيني في الداخل وتعرِّف العالم في الخارج، عبر الجولات، على مشكلة الفلسطيني، وثالثها كون الفرقة مؤلفة من فنانين وفنيين بانتماءات قومية ودينية مختلفة، وكذلك بمشارب فكرية متباينة. ومخرج أعمال الفرقة منذ بداياتها فرانسوا أبو سالم الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية مرات عدة وأغلقت مركز الفرقة ما يزيد على عشر مرات. وهناك من أعمال الفرقة «محجوب محجوب» و«ألف ليلة وليلة عن رامي الحجارة» و«جليلي يا علي»، وغيرها بإخراج راضي شحادة، مثل «عنتر في الساحة خيّال» و«تغريب العبيد» و«أريحا عام الصفر».
بعد انطلاقة الثورة الفلسطينية، أسّست حركة فتح في دمشق عام 1966 «جمعية المسرح العربي الفلسطيني» بهدف التوعية بالقضية وعرض تجارب الثورة على المسرح وإحياء التراث الثقافي الفلسطيني. وقدَّمت الفرقة منذئذٍ كثيراً من المسرحيات العربية والفلسطينية والأجنبية، وجالت بها عبر عواصم عدة عربية وشاركت بها أيضاً في المهرجانات المسرحية. ونتيجة لالتفاف العرب آنذاك حول القضية الفلسطينية، أسهم في أعمال هذه الفرقة عدد من المخرجين العرب مثل علاء الدين كوكش ووليد قوتلي وفواز الساجر السوريين، والعراقي جواد الأسدي. ومن مخرجيها الفلسطينيين نصر شما وصبري سندس وحسن عويتي وزيناتي قدسية الذي يعد من ممثليها المعروفين إضافة إلى عبد الرحمن أبو القاسم وتيسير إدريس والسورية ندى الحمصي.
لم تكتف الفرقة بتقديم الأعمال التي تتناول القضية الفلسطينية، بل تخطَّتها إلى النصوص ذات الروح النضالية والهمِّ الإنساني العام، فاتسع أفقها واغتنت تجربتها الفنية والفكرية، وكسبت جمهوراً عريضاً. لكن ما استجدّ على الساحة السياسية الفلسطينية منذ اتفاقية أوسلو، كان له بالغ الأثر في المسرح الفلسطيني عامة، ولاسيما خارج فلسطين، إذ ضاق أفق التعبير وانعدم الدعم المالي، وتباينت التوجّهات والمواقف الفكرية والسياسية مما يجري على صعيد «التسوية»، و«السلام» فتفرّق جمع المسرحيين وسكت صوت المسرح.
وفي لبنان أيضاً، وتحت جناح المنظمات الفلسطينية المختلفة أُلفت فرق مسرحية عدة، مثل «فرقة الإعلام الجماهيري» و«فرقة تل الزعتر» و«فرقة الإعلام الموحد» وغيرها، ولكن في خضمِّ الحرب الأهلية اللبنانية والاجتياح الإسرائيلي، وفي ظل التجارب المسرحية اللبنانية البارزة، لم تستطع هذه الفرق أن تقدم التماعات لافتة على صعيد فن المسرح.