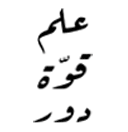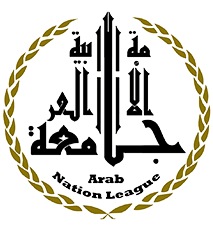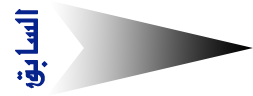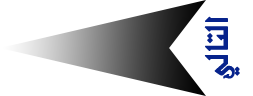الأضداد ظاهرة من الظواهر اللغوية التي أسهمت في نموّ الثروة اللفظية والاتساع في التعبير عند العرب. وقد عرّفها أبو الطيب اللغوي بقوله: «والأضداد جمع ضد، وضد كل شيء ما نافاه، وليس كل ما خالف الشيء ضداً له، ألا ترى أن القوة والجهل مختلفان وليسا ضدين، وإنما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم». وعرّفها ابن فارس الرازي بقوله: «المتضادان: الشيئان لا يجوز اجتماعهما في وقت واحد كالليل والنهار». ويلحظ في التضاد ضرب من المشترك اللفظي الذي يتجلّى في احتواء اللفظة الواحدة على معنيين مشتركين في النطق ولكنهما متباينان في الدلالة، فإذا ما وصل هذا التباين حدَّ التناقض والتعاكس عُدَّت اللفظة في الأضداد. واللغويون الذين سلكوا التضاد في جملة المشترك اللفظي نصّوا على أنه نوع أخصّ منه؛ من هؤلاء: سيبويه، وقُطرُب، والسجستاني، والمبرد، وابن الأنباري، وغيرهم.
ومن أمثلة التضاد: السُّدْفة، تدل على الظلمة وعلى الضوء، والصريم: لليل والنهار، والصارخ: للمغيث والمستغيث، والناهل: للعطشان، وللذي شرب حتى رَوِيَ، وأَمَم يقال: أمر أَمَمٌ إذا كان عظيماً، وأمر أَمَمٌ إذا كان صغيراً، والجُدُّ: البئر القليلة الماء، والكثيرة الماء.
وقد علَّلَ الدارسون ـ قدماء ومحدثين ـ وجود هذه الظاهرة اللغوية، أو أسباب نشأتها بعوامل أهمها:
1 ـ اختلاف اللهجات من قبيلة إلى أخرى في تقدير الدلالة اللغوية وتحديدها بدقة، وهو تعليل وجيه، إذ من غير المقبول أن يُسمّي القوم الذين يعيشون في بيئة واحدة الشيء باسم ذي معنى معيّن ثمّ يسموه بنقيضه. وقد أوضح ذلك صراحة ابن الأنباري حين قال: «إذا وقع الحرف (الكلمة) على معنيين متضادين، فالأصل لمعنى واحد، ثم تداخل الاثنان على جهة الاتساع». ولعلّ هذا الرأي من أكثر ما قيل في تعليل الأضداد سلامة بمعايير التحليل اللغوي القديمة والحديثة على السواء. وقد عزّزه ابن الأنباري بقوله أيضاً: «إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فمحال أن يكون العربي أوقعه عليهما بمساواة منه بينهما، ولكن أحد المعنيين لحيٍّ من العرب، والمعنى الآخر لحيٍّ غيره، ثم سمع بعضهم لغة بعض فأخذ هؤلاء عن هؤلاء، وهؤلاء عن هؤلاء».
2 ـ الخلط بين المعنيين بعدم مراعاة دقّة الدلالة اللغوية التي وضعت لكل منهما أصلاً، فمثل هذا الاتساع يؤدّي إلى التداخل، ثم يفضي إلى التضاد، كلفظة الظنّ التي صارت تعني الشك واليقين، في حين كانت تعني إدراك الشيء أو علمه. وكلفظة الصريم، لليل والنهار، وأصلهما من الصَّرْم، أي القطع أو الانتهاء، فكلٌّ منهما ينصرم عن صاحبه، ولذا لم يكن هذا عند بعضهم من الأضداد.
3 ـ التطور الدلالي الذي في ضوئه يمكن تعليل إطلاق معنى الطرب على الحزن والفرح وسلكه في الأضداد، في حين يرى ابن الأنباري أنه «ليس هو الفرح ولا الحزن، إنما هو خفّة تلحق بالإنسان في وقت فرحه وحزنه». وقد يُلحظ هذا ـ اليوم ـ في الحركات وضرب الراح بعضها ببعض وإطلاق النار في حالي الفرح والحزن مما يرجّح أن هذا أصل المعنى، ثم بالتطور اللغوي خُصّص للدلالة على ضدين. وقل مثل ذلك في المأتم الذي يدل على الضديّة في الحزن والفرح عند بعضهم، وإن كان يدل في الأصل على الجماعة، أو على جماعة النساء خاصة، في السرّاء والضرّاء. أي إن المعنى العام القديم تطور إلى معنيين متضادين.
4 ـ نقلُ المعنى عمداً من الحقيقة أو أصل الوضع إلى المجاز بقصد التفاؤل، أو التهكّم، وتجنّباً لما يخلّفه ذكر المعنى صراحةً من أثر في النفس، مما استدعى معاودة البحث عند العربي عن ألفاظ لا تُذكِّر بالتشاؤم أو بالكوارث، ثمَّ شاعت المعاني الجديدة وصارت بقوّة المعنى الأصل، نحو: «السليم» للديغ، و«البصير» للأعمى، و«المفازة» للمهلكة (البيداء)، و«القافلة» تفاؤلاً بقفولها، أي رجوعها، وإن كانت ذاهبة. ونحو ذلك لفظة «التقريظ» التي تُستعمل أصلاً لمدح الحي ويقابلها التأبين لمدح الميت، فهذه ذكَرَها ابن الأنباري وقطرب في معرض الذم، وتوجد في الأضداد بهذا المعنى التهكمي الجديد. وثمة من لا يعتد بهذا في الأضداد لأن مداره على نيّة المتكلم وحده، لا على الكلمة المفردة بصرف النظر عن دلالتها في التركيب.
5 ـ احتمال الصيغ الصرفية لمعنيين متضادين كأن تكون الصيغة بمعنى الفاعل والمفعول نحو: شكور، غفور بمعنى: شاكر، غافر، ورسول بمعنى: مُرسَل. وكذلك صيغة فعيل الدالة على الفاعل في: سميع وعليم وقدير، وعلى المفعول في: كحيل، وطريد، وجريح، وصيغة فاعل بمعنى مفعول في مثل قوله تعالى: فهو في عيشة راضية (الحاقة 21) أي مرضية، ومثل: خائف، وعائذ، وآمن، وكذا الصيغة الدالة على اسم الفاعل والمفعول معاً في مثل: المُحتلّ، والمختار، من مضعَّف الثلاثي وأجوف الرباعي، فكل هذا يدرجونه في الأضداد شريطة ألا يدخل على الكلمة تغيير، أو يجري في تصريفها اختلاف.
وأنكر الأضداد بعض اللغويين كابن درستويه، فقد نقل عنه السيوطي قوله: «النَّوْء: الارتفاع بمشقة وثقل، ومنه قيل للكوكب: قد ناء، إذا طلع. وزعم قوم من اللغويين أن النوء السقوط أيضاً، وأنه من الأضداد، وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك في كتابنا الذي عملناه في إبطال الأضداد». وممّن قال بوجود الأضداد ابن فارس وقد ردّ على القائلين بإبطالها فقال: «.. وأنكر ناس هذا المذهب وأنّ العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده، وهذا ليس بشيء، وذلك أن الذين رووا أن العرب تُسمّي السيف مهنداً والفرس طِرْفاً هم الذين رووا أن العرب تُسمّي المتضادين باسم واحد» وقال: «وقد جرّدنا في هذا كتاباً ذكرنا فيه ما احتجوا به وذكرنا ردَّ ذلك ونقضه».
وأشهر من ألّف في الأضداد محمد بن المستنير الملقب بقُطْرُب (206هـ)، والأصمعي (215هـ) وأبو عبيد القاسم بن سلام (222هـ) وأبو محمد عبد الله التُّوَّزي (بين 230 و250 هـ)، وابن السِّكِّيت (244هـ)، وأبو حاتم سهل بن محمد السِجستاني (248هـ)، وأبو بكر بن القاسم الأنباري (328هـ)، وأبو الطيب اللغوي (359هـ)، وأبو محمد سعيد المعروف بابن الدهان (569هـ)، وأبو الفضائل الحسن بن محمد الصَّغاني (650هـ). وتحسن الإشارة هنا إلى أن عدداً من اللغويين السابقين لهؤلاء قد قرن ذكرهم بالأضداد في ألفاظ رويت عنهم كأبي عمرو بن العلاء، ويونس بن حبيب، والخليل، والكسائي، والشيباني.. وإن لم يصطلحوا على التسمية، أو يؤلّفوا في الأضداد.