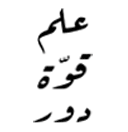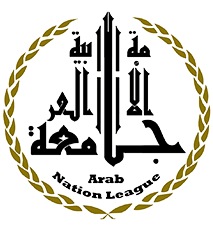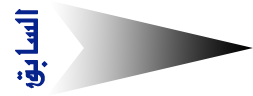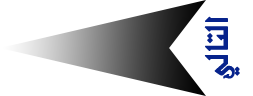يدلج العالم اليوم في ظلام لا أخلاقي، على الرغم من أنه يمتلك القوانين الأزلية التي يجب أن يستدعيها الإنسان كلما دعته الحاجة، وها نحن نحيا ونشهد انهياره أمام الثوابت التي تنعم بعقائد مختلفة، أهمها الروحانيات المتخفية بين أضلاع الأجساد الحيّة، وتلافيف عقولها تنجز ترانيم الظلمات الحالكة والأنوار المبهرة، هذه التي أنجزها دهاء الماضي بسلبياته وإيجابياته، مفصلاً تكوين شخوصه، ومبلوراً إياها بشكل مستمر، يسير إلى ملاجئه القاتمة التي ينجز فيها خياله وواقعيته، أيّ عالم من الازدواج المتداخل مع الفلسفة واللامنطق، ومن الخير والشر والحب والكراهية، لنرى الجميع يعاني بوجود الضوء أو باختفائه.
ها هو ذا يخضع الإنسان للنجاح والفشل، للإحباط والأمل، الارتباك العالمي ينتفض على الخلل الحاصل دون المس بالثوابت التاريخية، الأجيال الحديثة تسعى لامتشاق مصائرها، تمتلئ بأفكار إصلاحية، منها العفوية ومنها العلمية الفلسفية الحاملة للمنطق الذي تتناوب عليه المأساة والملهاة بقصد وبوعي، أو من دونهما، لأن حقيقة الناموس تجمع بين الخصوصية الفردية والتعددية الاجتماعية على اختلاف مشاربها المؤسسة من اثنتي عشرة عيناً، لنجد أن الوعي يختص في أوجه الفرادة الخاصة التي يتميز بها الأفراد المشكلون للمجتمع، وبالتالي نشأ التمايز بين المجتمعات، فغدا لكل منهم قيمه وأفكاره المتشابهة في الثوابت والمختلفة بالتطبيق.
ها أنا ذا أعتبره الفكرة التي تسيّر العالم، وهو وحده أي الناموس يشكل الرابط بين الفكر والمادة، وأي تطور حقيقي يحدث على كوكبنا الحي يتولد من فكر الإنسان، يكون نتاج شعور مسكون ضمنه، الذي يدفع به كما تندفع المياه من الينابيع، مشكلة السواقي والأنهار، وكما هي حرية الإنسان التي يتشوق إليها كل مخلوق كما يتشوق للآلهة في مسيرته الحية، وهذا الناموس يمنح الإنسان قدرات إنسانية هائلة، وأهمها الخيال الذي أعرفه بأنه قدرة العقل على تركيب أفكار يركبها من جزئيات مألوفة، ولا يمكن للعقل الإنساني خلق شيء من لا شيء، باستثناء العقل الكلي أو الكوني، ووجود الإنسان مذ صار إنساناً، كان تركيزه ودائرة اهتمامه الأولى هي ذاته، هذه التي لم تكتمل حتى اللحظة، لكونه يحاول الوصول إليها، فهي وحتى اللحظة غير واضحة المعالم، وهذا ما جعل الأنا الفردية تتفوق على الجماعية، وهو أي الإنسان لم يصل إلى قدرة ربط ذاته بذوات الآخرين، فإذا وصل إليها استطاع فهم الآخرين، وهذا يرينا السائد بين أفراد المجتمعات، أنه ومهما حصل من تآلف اجتماعي يعود المرء لفرديته وخصوصيته، يبحث عن الاجتماع من أجل الاستمرار، ومن ثم يعود للانقسام والتقسيم، بحكم أنهما حدا الحياة ولعبتها الدائمة بحسب المنطلقات التحريضية المسكونة بين الفكر الحياتي والفكر الديني، لأن فلسفة الناموس قامت على المعرفة التي أقسمها إلى قسمين، معرفة العلم والتعلم المستمر، وهذا ما يأخذه الإنسان من الحياة والآخر، ويمنحه للآخر، ويتساوى به المانح والآخذ ومعرفة الإيمان والتديّن، حيث يكون جزءاً من حقيقة الإنسان، لا تنفصل عنه، وتكون جزءاً من مقوماته الشخصية التي لم يخترها بإرادته، لكنه استشعر قداستها مع غيره من قوى النشاط الروحاني، فكان لها شأن خاص في الحياة، ومهما ابتعد عنها نجده يحتاج إليها، لأنها تبقيه على اتصال بآفاق الخفاء الهائل القائم من فلسفة الروح والولادة والموت، ومما لا جدال فيه أن استيفاء حياتنا يتطلب أن ننمي كل نشاط فينا، وهذا يشمل الجسد ورعايته، والفكر وصلابته، والعاطفة ورقتها، والروح وإيمانها، فغاية التكاثر البناء والتعلم والصلاة صلة ونقاء وتقوى والعمل والإتقان والإخلاص والوفاء والحب بالصدق لا بالنفاق والرياء.
أين النظرة النسكية المحبة للحياة؟ الإنسان يعجز عن اللحاق بظله مهما بلغ من قوة، لذلك نجده راح يبحث فيه وعنه، بعد أن كان للقوة الروحية والنفسية العلمية أمكنة مهمة في هذا الكون، وبينها يتحرك ناموس الحياة، يلسع فكره الحي، يدعوه لحكه، يدلك على أنه موجود لما هو حال البعوضة التي تلسع جلدك، فتجعلك تبحث عنها، وهي تشاغلك حينما تستمر في مشاغلتك لنفسك بطنينها المزعج، فهل يزعجنا ناموس الحياة الممتلئ من قضاياها التي تطالبنا بدراسة المعايير الأخلاقية وتقديمها على كثير من الاهتمامات الحياتية، رغم أن الإنسان هو المعيار الرئيس فيها، لأنه وحده القادر على معايرة أحداثها والتنبيه منها مع العواطف أو من دونها، فجميعها تخلق الفوارق الفردية، وتدوّن السير الذاتية، إلا أنها جميعاً تمتلك مفاهيم الناموس الحياتي، تجيّر بعضها لمصالحها الآنية، وتعمل ببعضها بحسب امتلاكها لنوافذ وأبواب العقل، تفتحها أو تغلقها، تدخل منها إلى مجتمعاتها، أو تغلقها عليها، هذه النوافذ التي تتوزع بين القيم الروحية والاجتماعية والوطنية والاقتصادية والسياسية، ولكل واحدة منها تعاريفها وتفاصيلها ومتطلباتها، وفي مجموعها تشكل القانون الأزلي الذي عرفه الإنسان وعززته التجربة، وننادي بها اليوم كحالة، بدلاً من أن تكون حقاً، وهنا أؤكد أن المسؤولية أهم أسٍّ من أسس ناموس الحياة المرتكز على وجود الزمان والمكان وعلاقة العقل بالمادة وأسرار شروق الشمس وغروبها في الغرب، وبينهما وجد القانون الذي يشكل حماية للإنسان من الإنسان، إلهياً كان أم وضعياً.
ناموس الحياة :يقوم على الوقائع والحقائق لا على الظنون والأوهام، لأن المادة ثابتة ملموسة ومشاهدة، لا يعتريها الشك، ولا يلم الباطل بتركيبها، وهي قائمة في مكان محدد، لذلك أجد أن تتبع الناموس وفهمه يؤدي إلى معرفة جديدة، هذه التي إن حدثت تضطرنا إلى فرد أفكارنا وأحلامنا وخواطرنا وتنقيحها ضمن مساحات حياتنا المعيشة أو المقدرة لنا، هنا أضيف قائلاً: إننا في العلم ندرك أن المعرفة ليست بالأمر الوحيد الذي نتمسك به، إنما يجب أن نسمح لأنفسنا بأن نتجه إلى العلم، ونبحث فيه أيضاً حتى نصل إلى التخصص بشيء ما منه، وأصل بهذا إلى أن المادة اليوم لا ينبغي أن توقفنا عن التفكير في حقائق الحياة المجردة، فهذه الحقائق غير ثابتة مهما بلغت من صلابة وجسامة، لأنها في النتيجة ترتد إلى أصولها، ألا يحدث كل هذا قشعريرة في الروح؟ تظهر على أجسادنا عندما نقف عند مفاهيم الناموس المختلطة بنظم الحضارة، أو عند البحث في الروح الكونية وأسباب توزعها بين الأجسام الحية، ألا تشكل هذه الأفكار تعباً وإرهاقاً جميلاً للفكر الإنساني؟ أم إن البعض يعتبرها شذوذاً ضخماً لا يجب الذهاب إليه؟ أليس حبّ الاستقرار خدعة كبرى يمارسها العقل البشري الممتلئ بالأسرار المخفية التي لم تدرك حتى اللحظة، والتي أخطّ بها لغتي المصرة والملحة والمتزاحمة كما يتزاحم النحل حول الملكة طلباً للنجاة؟ وهنا أشير إلى أنه لابدّ للإنسان في حال كان، من أن يعيش، رغم سؤاله الدائم البسيط والمعقد: لماذا أنا موجود وجمال الحياة أنها قائمة من مفردتي العمل والألم، هاتان اللتان تحطان بالأمل؟
يعتبر ناموس الحياة أهم عنصر من عناصر الوجود الإنساني، وهو أساس متين للارتقاء بواقع العلاقات الإنسانية ونظم العيش، ويجب أن يشتغل عليه وغرسه ورعايته في أفكار الأجيال من أجل الحفاظ على وجودها، وبه نجعلها أكثر قرباً من بعضها، وعاملة على فهم أسباب وجودها وضرورة تجذّرها، ومن ثم تحفيز البناء على أشكالها، فتتشكل معادلة الانتماء الإنسانية والهوية التراثية التي لا يمكن تجاوزها بسهولة، فهل بعد كل هذا يُحافَظ على الناموس الحياتي؟ أم سنبقى نعتبره بعوضاً "ناموساً" نطارده ونكافحه؟ فلا يبقى واخزاً للضمير يجبرنا على حكه، كي نعلم أنه موجود