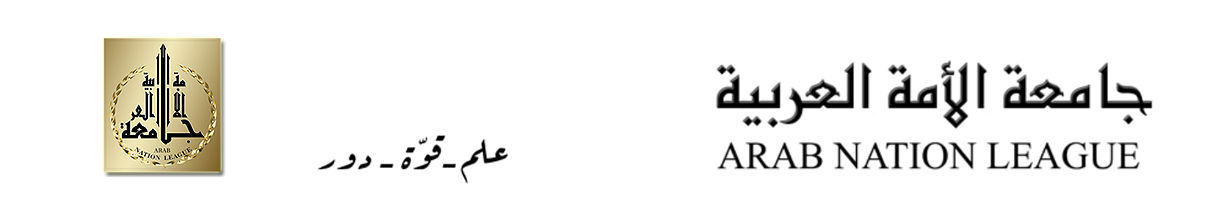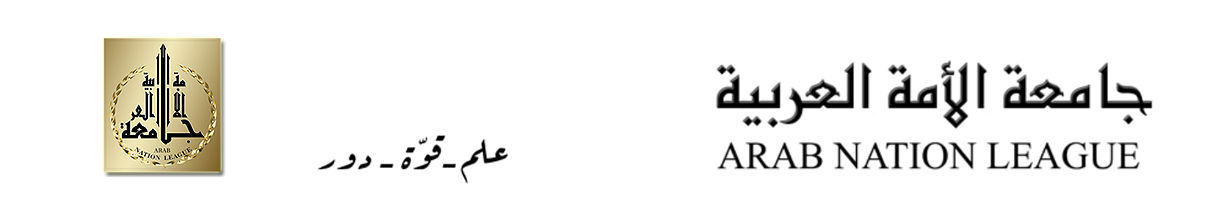يُعد مفهوم "الثقافة" من المفاهيم المحورية في علم الاجتماع، بصفة عامة، والأنثروبولوجيا الثقافية، بصفة خاصة. ويشكل مفهوم الثقافة أحد الأفكار الكبرى، التي ساعدت البشرية على إنجاز الكثير من التقدم العلمي والتطور الفكري؛ فالثقافة مفهوم يتميز بأنه ذا طبيعة تراكمية ومستمرة. فهي ليست وليدة عقد أو عدة عقود، بل هي ميراث انساني إجتماعي يعطي تصورا لتاريخ البشرية وتفاعل الانسان مع البيئة المادية والاجتماعية. لذلك، فإن محاولة تعريف هذا المفهوم تعكس جدل واسع وصراع طويل بين علماء الاجتماع؛ لأنه على الرغم من شيوع استعمال مصطلح الثقافة على ألسنة العامة من الناس، إلاّ أن المختص في دراسة العلوم الاجتماعية حينما يحاول تعريفه يصل الي تعريفات عديدة، في نطاق علمه والعلوم الأخرى، وكل تعريف منها يعكس وجهة نظر صاحبه، أو النظرية التي ينتمي إليها. كما يتداخل مفهوم الثقافة مع مفاهيم أخرى كالحضارة والمدنية .
الثقافة لغة:
ترجع كلمة ثقافة في قواميس اللغة العربية إلى مادة : (ث ق ف)، ثَقِف، يثقَف، ثَقَفاً؛ من باب فَرِحَ؛ ويعني صار حاذقًا فطنًا، وثَقِف الرجلَ في الحرب أدركه، وظفر به . ويجئ الفعل – أيضًا – من باب كَرُم؛ فيقال: ثَقُفَ الرجلُ: صار حاذقًا في علم أو صناعة، ومصدره "ثقافة"، وثاقفه، مثاقفة وثِقافًا: خاصمه وجالده بالسلاح إظهارًا للمهارة والحِذق. وثَقَّف الشيءَ أقام المعوج فيه وسوَّاه، وثقَّف الإنسانَ: أدَّبه وهذبه وعَلمه. و"الثقافة" لفظة محدثة؛ بمعنى أنها كلمة استعملها المحدثون في العصر الحديث، وشاع استعمالها في لغة الحياة العامة، وذكر في المعجم الوسيط: "أنها تعني العلوم والمعارف والفنون التي يُطلب الحِذق فيها"([1])
ووردت اشتقاقات هذه الكلمة في القرآن الكريم بمعنى الوجود والتمكن في بضع مواضع من سور القرآن الكريم ففي القرآن الكريم:} وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ {([2]) أي وجدتموهم؛ وفي تفسير الجلالين} إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُون { : أي إن يظفروا بكم في الحرب يتسلطوا عليكم بالقتل والضرب والشتم([3]) ؛ (ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا) ([4]): أي حيثما وجدوا ،(فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم) ([5]): أي فإما تجدنهم في الحرب وتظفر بهم فنكل بهم حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم . كذلك وردت اشتقاقات كلمة ثقف فيما ورد في الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تصف أباها سيدنا ومولانا أبا بكر الصديق ، حيث كان مما قالت فيه : (وأقام أوده بثقافه) : أي هذب نفسه بنفسه ، أو استخدم زاجره الداخلي وضميره في تقويم اعوجاجه وبناء ذاته الداخلية([6]). كذلك وردت اشتقاقات لهذه اللفظة في معلقة الشاعر الجاهلي عمرو بن أم كلثوم ، وذلك في قوله يخاطب الملك عمرو بن هند ويفاخر بقومه :-
فإن قناتنا يا عمرو أعيت * على الأعداء قبلك أن تلينا
إذا عضَّ الثقاف بها اشمأزت* وولته عشوزنة زبونا
عشوزنة إذا انقلبت أرنت * تشج قفا المثقف والجبينا
وهو في هذه الأبيات يشبه قناة قومه بعود الرمح القوي بحيث يستعصى على العامل الذي يقوم على تقويمه وتعديله؛ فيشجه على قفاه وجبينه. كذلك جاء في القاموس المحيط للفيروز أبادي :- ثقف: صار حاذقا خفيفا فطنا ، وثقف بن عمرو: صحابي من أهل بدر، وامرأة ثقاف :فطنة ، وثقفه:سوَّاه ، وثاقفه : غالبه فغلبه في الحذق([7]). كذلك جاء في قاموس لسان العرب لابن منظور : ثقف الرجل : صار حاذقا فطنا ، وثقفه تثقيفا : أي قوَّم عوجه ، وأصل ذلك للرماح ثم استعير فصار للتقويم الخلقي([8]) . وللكلمة في الثقافة الغربية تاريخ طويل؛ يقال فيه إن جذرها يرجع إلى اللفظ اللاتيني Culture ويعنى حرث الأرض وزراعتها، واستخدمه "شيشرون" Ciceron بمعنى زراعة العقل وتنميته، ويستعمل اللفظ Culture في الإنجليزية والفرنسية و Kulture في الألمانية ليعني "ثقافة"([9]).
الثقافة في الاصطلاح:
استعملت الثقافة في عصرنا الحديث هذا للدلالة على الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد والجماعات، "فالثقافة لا تعد مجموعة من الأفكار فحسب، ولكنها نظرية في السلوك مما يساعد على رسم طريق الحياة إجمالا، وهي الوجوه المميزة لمقومات الأمة التي تميز بها عن غيرها من الجماعات بما تقوم به من العقائد والقيم واللغة والمبادئ، والسلوك والمقدسات والقوانين والتجارب. "وإجمالا فإن الثقافة هي كل مركب يتضمن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات"([10]). ويرى أ.د. كمال محمد جاه الله الخضر، ان للثقافة ثلاثة مكونات(العنصر"القبيلة"، واللغة، والدين)، وبذلك تعد "موضوعا رئيساً من موضوعات الأنثروبولوجيا الثقافية، التي تهتم بالثقافات الإنسانية، وبطرق وأساليب الحياة في الثقافات المعاصرة أو المندثرة"([11]).
وإذا كانت الثقافة في أبسط صورة تعني "أساليب وطرق الحياة"، فإن التعبير عن تلك الأساليب والطرق يضحى أمرا يوافق أو يتعارض مع الآخر؛ مما يترتب على ذلك إما تعايش وتساكن أو تنافر واحتراب([12]). ولقد تطور مفهوم الثقافة حتي وصل الي مايعرف بالثقافة المركز(العولمة)، والتي يري الباحث ان الثقافة وفقا لهذا المفهوم هي عود الي بدأ- القرن الثامن عشر- عهد الثقافة الادني والثقافة الاعلي، كما سيلاحظ القارئ من خلال تتبع الباحث لتطور مفهوم اثقافة.
تطور مفهوم الثقافة:
إن كلمة culture * تعني في الأصل الزراعة والفلاحة. وقد تطور مدلولها، ابتداء من القرن السادس عشر، لتفيد معنى مجازيا هو "تنمية بعض القدرات العقلية بالتدريب والمران"، ثم لتدل بعد ذلك على "مجموع المعارف المكتسبة التي تمكن من تنمية روح النقد والقدرة على الحكم"([13]).
لقد تطور المصطلح إذا: من زراعة الأرض واستغلال خيراتها إلى تدريب الفكر وجني ثمراته، وأصبح يشير بصورة واضحة إلى تحسين أو تعديل المهارات الفردية للإنسان، لا سيما من خلال التعليم والتربية، ومن ثم إلى تحقيق قدر من التنمية العقلية والروحية للإنسان والتوصل إلى رخاء قومى وقيم عليا وسرعان ما وقع التأكيد على أن مدلولها في ميدان الفكر يجب أن ينصرف إلى فعل الإنتاج أكثر من الإلحاح على الإنتاج نفسه، بمعنى أن المقصود منها يجب أن يكون ما يكسبه العقل من قدرات على التفكير السليم والمحاكمة الصحيحة، بفضل المعارف التي يتلقاها، والتجارب التي يخوضها، لا ما يضمه الفكر بين طياته من معارف ومعلومات. "لقد ألح كثير من الكتاب الفرنسيين منذ عهد النهضة على هذا المعنى، ويكفي أن نشير إلى تلك التفرقة الشهيرة التي أقامها مونتني Montaigne بين ما سماه "الرؤوس المصنوعة جيدا" وما أطلق عليه: "الرؤوس المملوءة جدا" مفضلا الأولى على الثانية. ولعل الكثيرين منا سمعوا أيضا بذلك التعريف الطريف الذي أعطاه المسيو Herriot لـ"الثقافة" حين قال: إنها "ما يبقى لدينا بعد أن ننسى كل شيء"([14]).
و يستعمل علماء الأنثروبولوجيا، خاصة الإنجلوساكسون منهم كلمة الثقافة علي إنها تدل على"مختلف المظاهر المادية والفكرية لمجموعة بشرية معينة تشكل مجتمعا بالمعنى السوسيولوجي للكلمة([15]). يقول تايلور** Taylor في نص متداول بكثرة: إن الثقافة هي "ذلك المركب الكلي الذي يتضمن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات وأي قدرات وخصال يكتسبها الإنسان نتيجة وجوده عضوا في مجتمع". يعتبر "ادوارد تايلور Edward Tylor "واحدا من أول العلماء الناطقين بالإنجليزية ممن استخدموا مصطلح الثقافة بالمعنى الواسع والعالمى([16]).وفي عام 1870، قام إدوارد تايلور بتطبيق أفكار الثقافة الأعلى في مقابل الثقافة الأدنى في محاولة من شأنها اقتراح نظرية التطور الدينى. طبقا لهذه النظرية، يتطور الدين لدى الفرد، من شكل الشرك المتعدد إلى شكل التوحيد المطلق أعاد تايلور في هذه العملية تعريف الثقافة بأنها مجموعة متنوعة من الأنشطة المميزة لجميع المجتمعات البشرية. وبذلك مهدت وجهة النظر هذه الطريق لفهم الثقافة الحديثة([17]).
إن فكرة "الثقافة" التي نشأت في أوروبا إبان القرنين الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر عكست بدورها حالة من عدم المساواة داخل المجتمعات الأوروبية، والتي لاتخلو(حسب الباحث) في باطنها من الاستعلاء الثقافي، فكما ارتبطت الممارسات بأنماط الحياة البدوية، فإن كلمة "ثقافة" اتسمت بكل ما تعنيه كلمة "حضارة" من معني، ويعد الاهتمام بالفلكلور الشعبي هو من أهم ما يميز الحركة الثقافية، وهو ما أدى بدوره إلى تعريف كلمة "ثقافة" بين العامة من غير النخب([18]). وهذا التمييز يشبه ذلك التمييز الموجود بين علية القوم من الطبقة الاجتماعية الحاكمة وعامة الناس. ويرى توماس هوبس *Thomas Hobbes وجان جاك روسوو** Jean-Jacques Rousseau تناقضا بين مفهوم "الثقافة" و"حالة الإنسان الطبيعية"وبالنسبة إلى هوبز وروسوو فيرى كلا منهما أن سكان أمريكا الأصليين من الهنود الحمر والذين تعرضوا للغزو من قبل الأوروبيين بداية من القرن السادس عشر كانوا يعيشون بدافع الغريزة أو الفطرة، وقد تم التعبير عن هذا من خلال التناقض بين "المتمدنين " و"غير المتمدنين".ووفقا لهذه الطريقة في التفكير، فيمكن للمرء أن يصنف بعض الدول والشعوب على أنها أكثر تحضرا من غيرها، وأن يصنف بعض الناس على أنهم أكثر ثقافة من غيرهم([19])، بالرغم من عدم وجود معايير متفق عليها من قبل العلماء والباحثين ، يمكن أن تشكًل أساس لتقييم ثقافة مجتمع ما، وتحديد الطبقة التي يمكن ان تنتمي اليها..! ويرى الباحث، أن مصدر التناقض في ان معظم هؤلاء العلماء ينطلق في تحليله للثقافة من بيئته الثقافية، ومرجعه الاساسي في ذلك مدي استيعابه لواقعه الاجتماعي . ومن ثم أدى هذا التناقض إلى توصل "لويس هنرى مورغان Lewis Henry Morgan " إلى نظريته "التطور الثقافى"*.وعلى هذا النحو، فقد أشار بعض النقاد إلى أن التمييز بين الثقافات المتحضرة والمتخلفة يعزى في واقع الأمر إلى وجود حالة من الصراع بين الصفوة من الأوروبيين وغيرهم ممن هم ينتمون إلى طبقة اجتماعية أدنى، ومنهم "الناقد الإنجليزي ماتثيو أرنولد، اشار للخطر الذي سماه "الخلط بين الثقافة والفوضى" ، وقام أرنولد بتشخيص المجتمع البريطاني باعتباره يتكون من ثقافات عِدة قسمها بحسب التوزيع الطبقي الذي جعله من ثلاثة طبقات عامة أولاً : البربر (الطبقة العليا) ، وثانياً : الانتهازيون (الطبقة الوسطى) و ثالثاً : الرعاع (الطبقة العاملة)" ([20]). هذا كما أرجع بعض النقاد الفجوة بين الشعوب المتحضرة وغيرهم من الشعوب الغير متحضرة إلى الصراع القائم بين كلا من الإمبراطورية البريطانية من جهة وبين رعاياها من جهة أخرى. وقد وافق بعض من نقاد القرن التاسع عشر*، ممن اعقبوا روسو، على هذا الاختلاف بين ثقافة ما عرف بالأعلى والأدنى، ولكنهم في الوقت ذاته أقروا بأن محاولة التعديل والتكلف في صياغة قالب من الثقافة عالية المستوى على أنه افساد، بل ومحاولة تعديل في غير موضعه والذي من شأنه جلب المفسدة والتشوه لفطرة الله التي فطر الناس عليها.ويعتبر هؤلاء النقاد أن الموسيقى الشعبية أو ما يعرف بالفلكلور (والتي تنتجها أفراد الطبقة العاملة) تعبيرا صادقا عن شكل من أشكال الحياة .الطبيعية، في حين تبدو الموسيقى الكلاسيكية سطحية ومنحلة. وبنفس القدر، تصور وجهة النظر هذه الشعوب الأهلية على أنها "نبلاء بدائيون" حيث يعيشون حياة فطرية غير معقدة لا تشوبها شائبة، ولم تعبث بها أيدى أنظمة الغرب الفاسدة الطبقية الرأسمالية.
وعلى العموم إن كلمة "ثقافة" في الاصطلاح الأنثروبولوجي تعني ما نعبر عنه نحن اليوم بـ "حضارة"، إنها ليست البناء الفكري وحسب، بل إنها أيضا السلوك الفردي والمجتمعي وما يرتبط بهما من تقاليد وأعرافـ وأخلاق. وقد يضاف إلى ذاك كله أدوات العمل والإنتاج. وبحلول القرن العشرين، برز مصطلح "الثقافة" للعيان ليصبح مفهوما أساسيا في علم الانثروبولوجيا، ليشمل بذلك كل الظواهر البشرية التي لا تعد كنتائج لعلم الوراثة البشرية بصفة أساسية. وعلى وجه التحديد، فإن مصطلح "الثقافة" قد يشمل تفسيرين في الأنثروبولوجيا الأمريكية([21]):
التفسير الأول: نبوغ القدرة الإنسانية لحد يجعلها تصنف وتبين الخبرات والتجارب بطريقة رمزية، ومن ثم التصرف على هذا الأساس بطريقة إبداعية وخلاقة.
التفسير الثاني: فيشير إلى الطرق المتباينة للعديد من الناس الذين يعيشون في أرجاء مختلفة من العالم والتي توضح وتصنف بدورها خبراتهم، والتي تؤثر بشكل كبير على تميز تصرفاتهم بالإبداع في الوقت ذاته. وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية، صار لهذا المفهوم قدر من الأهمية ولكن بمعانى مختلفة بعض الشئ في بعض التخصصات الأخرى مثل علم الاجتماع، والأبحاث الثقافية، وعلم النفس التنظيمي، وأخيرا الأبحاث المتعلقة بعلم الإدارة.
وقد إعتمدت الحركة الاستعمارية في القرن التاسع عشر علي دراسات الانثروبولوجيين للمجتمعات المستعمرة، في ادارة هذه المجتمعات انطلاقا من الثقافة المحلية للمجتمع، ولقد ساعد ذلك علي تقليل التكاليف الادارية، وكفاءة جباية الاتاوات والضرائب واحتواء حركات التمرد (الثورات )علي السلطة المركزية([22]).
وعليه يري الباحث انه يمكن استخدام كلمة "ثقافة" في التعبير عن أحد المعانى الثلاثة الأساسية التالية:
• التذوق المتميز للفنون الجميلة والعلوم الإنسانية، وهو ما يعرف أيضا بالثقافة عالية المستوى.
• نمط متكامل من المعرفة البشرية، والاعتقاد، والسلوك الذي يعتمد على القدرة على التفكير الرمزي والتعلم الاجتماعي.
• مجموعة من الاتجاهات المشتركة، والقيم، والأهداف، والممارسات التي تميز مؤسسة أو منظمة أو جماعة ما..
اما في العصر الحديث، ذكرت سلوان داود "أن الشاعر ت .س اليوت من أشهر من اهتم بموضوع الثقافة منذ بدايات القرن العشرين , ومن اجل ادراك الثقافة وضع اليوت شروطا" ثلاثة اذا ما تحققت ,تم بها تحقيق الثقافة اولا" البناء العضوي , ويرى انه يساعد على الانتقال الوراثي للثقافة داخل ثقافة ومجتمع معينين . ثانيا" القابلية للتحليل ويرى وجوب ان تكون الثقافة (من وجه النظر الجغرافية ) قابلة للتحليل الى ثقافات محلية (البعد الاقليمي للثقافة ) .ثالثا" التوازن بين الوحدة والتنوع في الدين ويرى ان هذا الشرط مهم لأنه في الكثير من الثقافات لا يمكن افغال او تهميش عامل الدين . وفي هذا السياق اضاف اخرين الى ان الثقافة سياسة وتربية"([23]). وفي النسخة الالكترونية لكتابه "مفهوم الثقافة " ذكر،الدكتور خليل الحدري: "ان اليوت قال: إن ما أعنيه بالثقافة هو ما يعنيه الأنثروبولوجي وهي أنها طريقة حياة أفراد شعب معين يعيشون معاً في مكان واحد وتظهر هذه الثقافة في فنونهم وفي نظامهم الاجتماعي وفي عاداتهم وأعرافهم ودينهم"، ويرى الدكتور خليل، انها دلالات يختلط بعضها ببعض، وتتراوح الكتابة عنها بين: الموقف الجدلي، والموقف المثالي الطوبوي، والموقف الذي يفرضه منهج البحث الأمبيريقي؛ (منهج البحث في العلوم الطبيعية)؛ واورد مثال لذلك، محاولة "إليوت" إثبات أن الطبقة العليا "High Class" أو الأرستقراطية التي يتوارث أهلها الثروة والنفوذ شرط ضروري لازدهار الثقافة. وكذلك في تفكير اليوت بين الطبقة والنخبة، أي الصفوة "Intelligentsia"، والغريب أنه يرى أن الطبقة الأرستقراطية شرط ضروري لازدهار الثقافة بإطلاق، دون إيلاء أدنى اعتبار للظروف التاريخية لكل ثقافة، ودون ذكر للكفاءة الخاصة التي يجب أن يمتلكها أهل الطبقة الأرستقراطية، وإعمال هذه الكفاءة في الرقي الثقافي، وذلك حيث يقول عن وظيفة الطبقة الأرستقراطية "إنها ليست إلا المحافظة على مستويات الآداب الاجتماعية، وهي عنصر حيوي في ثقافة الفئة". ويذهب الي ان"ت.س. إليوت" كان يؤمن بوجود ثقافتين: إحداهما شعبية، والثانية نخبوية أرستقراطية؛ ليس لها من وظيفة إلا حماية مصالح الطبقة ذاتها. ومن شأن هذه الثنائية أن تحول دون "وحدة الثقافة" التي يتحدث عنها بعض الأنثروبولوجيين على أنها (الثقافة) ذات بنية "عضوية". ويرى آخرون أنها ذات بنية فوق عضوية Super-organic." ([24]).
وفي المحصلة نجد إجماع ضمني من علماء الانثروبولوجيا على أن الثقافة هي ذلك الكل المعقد الذي يتضمن المعرفة ، والمعتقد ، والفن ، والخُلق ، والقانون ، والعادات الاجتماعية وأية إمكانيات اجتماعية أخرى بل وطبائع اكتسبها الإنسان كعضو في مجتمعه." وبعدئذ دأب هؤلاء على تقديم العديد من التحسينات والتباينات على هذا التعريف العام لمعنى الثقافة ، لكن الأهم هو أن الجميع اتفقوا على أن الثقافة هي سلوك تعلمي كثيراً ما يتناقض مع السلوك الموهوب تراثياً.
ولكن، بالرغم من التطور الذي حدث لمفهوم الثقافة في الفكر الغربي، الا ان في اواخر القرن العشرين ظهر دعاة الثقافة العالمية الموحدة (العولمة)، بمعني ان نمط الحياة الغربي وما يحتويه من سلوك يعتبر الارقي والافضل وانه يجب علي كل المجتمعات ان تحذو حذوه.وكان علي رأس هؤلاء الدعاة، فرانسيس فوكوياما (ياباني الاصل امريكي الجنسية) في مقال، تحت عنوان "نهاية التاريخ " *والذي تنبئ فيه بنهاية "الحرب الباردة"** وسقوط "الاتحاد السوفيتي"**، وهيمنة الولايات المتحدة الامريكية علي مجريات الامور في العالم، ثم لاحقا صدر له كتاب "نهاية التأريخ والإنسان الأخير، End Of History and The Last man" والذي روًج فيه لفكرة ان ماوصل اليه الغرب يمثل نهاية الرقي البشري والحضارة الانسانية، وان ما سواه من ثقافات في طريقها الي زوال. ولقد تلاقحت الفكرة مع رغبة الغرب في الهيمنة الاقتصادية، والسياسية، والثقافية. وسُخرت الآلة الاعلامية والشركات عابرة للقارات، لتحقيق ذلك الهدف. أما المفهوم الاصطلاحي "للعولمة" في عمومه هو محاولة توحيد العالم في نمط واحد وربطه اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، واختزال العالم في مفهوم القرية الكونية والثقافة الواحدة بتأثير ثورة المعلومات والاتصالات .لكن هناك إجماع على أن المفهوم مازال في طور التبلور ، وأنها ظاهرة لم تكتمل بعد([25]). الا ان الفكرة وجدت انتقادات ومناهضة من قبل علماء وباحثين ونشطاء في الغرب نفسه، مما يعكس حالة من اختلاف الرؤى، وتعارض المصالح بين المجتمعات في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية.
ويرى الكثير من الباحثين والنقاد في دول العالم الثالث، أن "العولمة" تمثل تحديًا لدول العالم النامي، وأن "انها سلاح خطير؛ يرسِّخ الثنائية في الثقافات الوطنية، ويؤدي إلى انشطار الهوية الذاتية والوطنية، ويفضي إلى انفصام الثقافة الأصلية للشعوب عن النظام الاجتماعي القائم فيها. ويقال في شأن المعركة بين القوى الرئيسة الفاعلة في ظاهرة "العولمة" والدول النامية إنها ستكون معركة خاسرة؛ إذا لم تتسلح الشعوب النامية فيها بأدوات ثقافة العولمة ذاتها؛ تلك الأدوات التي تعتمد على أسس اقتصادية، وعلمية، وتقنية، وثقافية متينة([26]). وهذا ما اتاح لل "الانثروبولوجيا النقدية "* مرتعاً خصباً في دول العالم الثالث، كمدخل لتعزيز ثقافة الشعوب، في نفس الوقت الذي لم تجد فيه الاهتمام من العلماء في امريكا واوربا.
الثقافة في الادبيات العربية:
يري كثيرا من النقًاد والباحثين، ان مصطلح لثقافة لم بكن شائعا في الحضارة الإسلامية ولا اللغة العربية، من عهد النبوة والراشدين مرورا بالخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية وما تلاهما من ممالك إسلامية ، حيث كان يشار للدين بمعانيه المباشرة من كتاب وسنة ، ويشار لعلماء الشرع وفق الاختصاص من قراء ومفسرين ومحدثين وفقهاء وقضاء وإخباريين لعلماء السير والمغازي ، وكذلك لغيرهم من أهل العلوم فهذا طبيب وذاك فيلسوف وغيرهم من كاتب وشاعر ومنجم وهكذا ، وكان يشار لمن له إلمام عام بالعلوم بصفة الأدب كأن يقال الأديب الأريب وهكذا. واختلفت الآراء حول اول من استخدم مصطلح الثقافة من الكتاب العرب، منهم من ذكر ان "سلامة موسى " في مصر-أول من أفشى لفظ ثقافة مقابل "Culture"- وقد تأثر في ذلك بالمدرسة الألمانية في تعريف الثقافة، ربطها بالأمور الذهنية، حيث عرّف الثقافة بأنها هي:" المعارف والعلوم والآداب والفنون التي يتعلَّمها الناس ويتثقفون بها"، وميَّز بين الثقافة "Culture" المتعلقة بالأمور الذهنية والحضارة "Civilization" التي تتعلق بالأمور المادية. ولقد عرفت اللفظة العربية بنفس المضمون الأوروبي للمفهوم، مما شجع الدعوة إلى النقل والإحلال للقيم الغربية محل القيم العربية والإسلامية انطلاقًا من مسلمات الانتشار الثقافي والمثاقفة([27]).
وهناك من يرى ان أول من استخدم كلمة ثقافة هو الأديب المصري طه حسين ، وذلك في مؤلفه (مستقبل الثقافة في مصر) الذي صدر في1938م ، ومن ثم شاعت هذه المفردة في الاستعمال فكانت تدل على الاستنارة والعلم ، كما أصبحت تدل على نوع الأفكار أو القيم أو التقاليد أو الأعراف أو أسلوب الحياة الذي يغلب على مجتمع أو جماعة أو أمة بعينها ، ومن ثم كثرت التعاريف لهذه المفردة وفق هذا التعدد ، يقول الدكتور محمد عمارة في تعريف مفردة ثقافة بأنها: (جماع المهارات التي تثمر عمران النفس الانسانية وتسهم في تهذيبها وارتقائها على درب المثل والمقاصد والنماذج التي صاغتها وتصوغها العقائد والفلسفات التي يؤمن بها هذا الإنسان)([28]). وحسب تعريف أ.د. حسن مكي "فإن الثقافة تعني سبل كسب العيش ، أو بالأحرى الرؤية الروحية والفكرية لسبل كسب العيش وما فيها من ترقية للأوضاع"([29]). ونحن هنا نستطيع ان نحصل على مفهوم اوسع من خلال استعراض هذه الاراء، وان نجمع بين هذه الاراء وغيرها لنخرج بالنتيجة ، بان الثقافة هي استيعاب وفهم وهضم جميع الايديولوجيات الحاصلة في كل فترة زمنية سبقتنا ، ثم صبها في قالب مؤدلج، يخدم واقعنا الراهن، ويصب في قضايانا المصيرية مع الاخذ بعين الاعتبار ، افكار ورؤى من سبقونا وتسليط الاضواء عليها في لغة خاصة تتناغم ولغة عصرنا ([30]). ويمكن أن نخلص من كل ذلك إلى أن الثقافة هي : "الكل المركب الذي يتضمن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات"، والتعريف الثاني الأكثر بساطة هو يمكننا أن نقول أن الثقافة هي : (أسلوب الحياة) ، هذا الأسلوب الذي يمكن أن يميز فرد أو أسرة أو جماعة أو مجتمع أو أمة بعينها، وبالتالي يكون لهذا الأسلوب أوصاف معينه وأسباب ومصادر وخصائص ومقومات وما إلى ذلك.وفي مقال تحت عنوان"الثقافة مفهوم ذاتي متجدد" لخًص الدكتور،نصر عارف رأيه في مفهوم الثقافة في الادبيات العربية :
1- إن مفهوم "الثقافة" في اللغة العربية ينبع من الذات الإنسانية ولا يُغرس فيها من الخارج. ويعني ذلك أن الثقافة تتفق مع الفطرة، وأن ما يخالف الفطرة يجب تهذيبه، فالأمر ليس مرده أن يحمل الإنسان قيمًا-تنعت بالثقافة- بل مرده أن يتفق مضمون هذه القيم مع الفطرة البشرية.
2- إن مفهوم "الثقافة" في اللغة العربية يعني البحث والتنقيب والظفر بمعاني الحق والخير والعدل، وكل القيم التي تُصلح الوجود الإنساني، ولا يدخل فيه تلك المعارف التي تفسد وجود الإنسان، وبالتالي ليست أي قيم وإنما القيم الفاضلة. أي أن من يحمل قيمًا لا تنتمي لجذور ثقافته الحقيقية فهذه ليست بثقافة وإنما استعمار و تماهٍ في قيم الآخر.
3- أنه يركز في المعرفة على ما يحتاج الإنسان إليه طبقًا لظروف بيئته ومجتمعه، وليس على مطلق أنواع المعارف والعلوم، ويبرز الاختلاف الواضح بين مفهوم الثقافة في اللغة العربية ومفهوم "Culture" في اللغة الإنجليزية، حيث يربط المفهوم العربي الإنسان بالنمط المجتمعي المعاش، وليس بأي مقياس آخر يقيس الثقافات قياسًا على ثقافة معينة مثل المفهوم الإنجليزي القائم على الغرس والنقل.
4- وبذلك فإنه في حين أن الثقافة في الفكر العربي تتأسس على الذات والفطرة والقيم الإيجابية، فإنها في الوقت ذاته تحترم خصوصية ثقافات المجتمعات، وقد أثبت الإسلام ذلك حين فتح المسلمون بلادًا مختلفة فنشروا القيم الإسلامية المتسقة مع الفطرة واحترموا القيم الاجتماعية الإيجابية.
5- أنها عملية متجددة دائمًا لا تنتهي أبدًا:وبذلك تنفي تحصيل مجتمع ما العلوم التي تجعله على قمة السلم الثقافي؛ فكل المجتمعات إذا استوفت مجموعة من القيم الإيجابية التي تحترم الإنسان والمجتمع، فهي ذات ثقافة تستحق الحفاظ عليها أيَّا كانت درجة تطورها في السلم الاقتصادي فلا يجب النظر للمجتمعات الزراعية نظرة دونية، وأن تُحترم ثقافتها وعاداتها. إن الثقافة يجب أن تنظر نظرة أفقية تركيبية وليست نظرة رأسية اختزالية؛ تقدم وفق المعيار الاقتصادي -وحده- مجتمع على آخر أو تجعل مجتمع ما نتيجة لتطوره المادي على رأس سلم الحضارة([31]).
ان تحليل الدكتور نصر،للثقافة العربية فيه خلط واضح بين مفهوم الثقافة الاسلامية والعربية، فاذا كان بناء الثقافة علي الفطرة فان ذلك يجب ان يشمل كل الثقافات، لان كل مولود يولد علي الفطرة، والدليل علي ذلك تناوله لسلوك عند فتح الاندلس، والمعلوم ان للبيئة اثر علي ثقافة لفرد، لذلك نجد ان الثقافة العربية قبل الاسلام كان طابعها العنف، واظهار القوة والقهر، بالرغم من وجود قيم الجود، والكرم، والقرى.. خلاصة القول ان مفهوم الثقافة في الادبيات العربية علي علاقة عضوية مع مفهوم "culture " لدي الغرب، بل يتطابق المفهومان في كثير من خصائصهما.
محتوى أومكونات الثقافة:
ومن الحقائق المستقرة في الدراسات الأنثروبولوجية أن أي مجتمع متجانس يمكن تقسيم محتوى ثقافته إلى ثلاث فئات تعتمد على مدى اشتراك أعضاء المجتمع في كل من هذه الفئات الثلاث([32]) علي النحو التالي:-
1- العموميات Commons:
وتضم هذه الفئة المعتقدات الدينية والقيم الخلقية والمعارف الطبيعية والاجتماعية العامة التي يشترك فيها جميع أعضاء المجتمع البالغين العقلاء. وتشمل هذه الفئة – أيضًا – اللغة القومية، وانماط العلاقات داخل الأسرة (توزيع الادوار بين افراد الاسرة)، ونماذج المساكن، والمنشآت المختلفة، ونسق العلاقات الاجتماعية في السياقات والمواقع الاجتماعية المتنوعة .
2-الخصوصيات Specialties:
وتحتوي هذه الفئة على العناصر الثقافية التي يتقاسمها أعضاء جماعات معينة من الأفراد؛ وليست حيازة مشتركة لمجموع أبناء المجتمع؛ ولكنها تظفر باعتراف المجتمع واحترامه أوهي مجموع العادات والقيم والأنظمة والأساليب التي تختص بها جماعة محددة في المجتمع, وتعمل على ممارستها بشكل واضح دون غيرها من مكونات المجتمع الأخرى، كالبرامكة، فلهم طقوس محددة يحترمها مجتمع محلية زالنجي من غير ان يشارك فيها، مثلاً في حالة مخالفة طقوس شرب الشاي مثلاً يحكم علي المخالف، بعقوبة معينة او غرامة مالية، ينفذها الفرد عن رضى، ويمكن ان يُعزل إجتمعيا الشخص الذي يرفض تنفيذ الحكم ويُنْبذ.
3-البدائل / المتغيرات: Alternatives
وتضم المحتويات الثقافية لهذه الفئة الأفكار والعادات والممارسات غير الشائعة في المجتمع؛ وإنما تقتصر على فئة من فئات السكان المعترف بها اجتماعيًا. ويقال إن عناصر هذه الفئة من محتويات الثقافة متنوعة وممتدة في مجالات كثيرة، ولكنها تلتقي في قَسْمة واحدة؛ تميزها عما يطلق عليه العموميات أو الخصوصيات في عناصر الثقافة. وهذه النقطة الفارقة هي: أن هذه البدائل تمثل استجابات متباينة، أو ردود أفعال مختلفة، أو وسائل فنية أو تقنية لمثيرات أو احتياجات أو أوضاع واحدة في المجتمع. ومن أمثلة هذه البدائل ما يلي:
اختلاف ابناء الثقافة الواحدة في الاختيار بين التعليم المدرسي أوالخلاوي القرآنية، ايضا نجد هنا في "زالنجي" التباين في اختيارالغذاء ما بين "الدًامِرقا"(الدخن بعد التحميض)، و"الفَتَارِيت"(الذرة الحمراء). ومهما يكن من أمر العناصر الثقافية أعلاه، فإن أمرين هامين يحسن تأكيدهما:
أولاً: إن أي ثقافة تُعرف وتُميّز عادة بواسطة عمومياتها وخصوصياتها.
ثانياً: أن أسلوب النمو الثقافي أو اتجاهه يحدث كالتالي: تتحوّل البدائل بعد ممارستها لمدة كافية من بعض الأفراد إلى خصوصيات تميز طبقة أو فئة محددة في المجتمع. ومع مرور الوقت, يتبنى معظم الناس بعض الخصوصيات فتصبح عموميات يتفقون على صلاحيتها العامة, ويمارسونها في حياتهم اليومية"([33]).
ونتيجة لهذا تنحسر ممارسة بعض العموميات لدرجة تكون معها مختصة بفئة معينة.. وتتحول بعض الخصوصيات أيضاً إلى بدائل تروق لبعض الأفراد, حيث هي الأخرى تميل تدريجياً إلى التلاشي والاندثار بسبب تخلي هؤلاء الأفراد عنها مع الزمن.
ويستدرك علماء الأنثروبولوجي على هذا التقسيم لمحتويات الثقافة بملاحظة أن ثمة فئة رابعة من العادات والأفكار والاستجابات العاطفية المشروطة، توجد خارج الثقافة، وهي ذات أثر بالغ في تحريك الثقافة ونقلها إلى مستويات أرفع في المجالات المختلفة، ويقصد بهذه الفئة من العوامل "المزايا الفردية" Individual merits التي يحوزها بعض الأفراد في الثقافة سواء فيما يتصل بالعقائد أو المعارف أو المهارات أو العادات الجسدية أو العقلية أو الفنية والتقنية([34])..
مستقر الثقافة ومستودعها:
يرى د.سعيد ابراهيم ان، متابعة تصور "الثقافة" لدى علماء الأنثروبولوجيا – في الكتابات الغربية – يثير الحيرة لدى الباحث، تتمثل في نقطة البدء في دراسة الثقافة لمعرفة الصفات المشتركة بين افراد المجتمع، بما يسوِّغ الحديث عن نمط ثقافي؛ ويمكن التعبير عن هذه الحيرة بالتساؤل الذي يتردد طرحه: هل الثقافات كيان موجود فعلاً، ويمكن متابعة تأثيره في أبناء الثقافة؟ أم أنها تجريد عقلي يخلص إليه الباحثون من دراساتهم النفسية للأفراد؟([35])
وهذا السؤال يعني أن التساؤل دائر حول مستقر الثقافة ومستودعها. وقد حاول "رالف لنتون"* أن يجيب عن هذا التساؤل؛ فهو يرى: أن الثقافة شيء غير ملموس، وأن استيعابها عن طريق الإدراك المباشر أمر غير ممكن؛ حتى للأفراد الذين شاركوا في صنعها، وأن شكل الثقافات ومحتواها أمر لا يمكن استخلاصه إلا من السلوك الذي ينشأ عن هذه الثقافات "والسلوك" في نظره كلمة ذات معانٍ واسعة؛ تضم الأعمال اليومية العادية التي تمارس في جوانب الحياة المختلفة، كما تضم الأشياء المصنوعة التي تعتبر منتجات لأعمال الناس في المهن والحرف المختلفة. وهذا يعني أن الثقافة ظاهرة تقع خارج نطاق الظواهر الطبيعية، وأن إدراكها يكون بإدراك الآثار التي تحدثها في حياة الناس المادية والنفسية والاجتماعية. ويمكن القول إن مستقر الثقافة ومستودعها هو عقول أبنائها ووجدانهم بكل ما تحوي من: معتقدات، وأفكار، ومعارف، وقيم، وتوجهات، واتجاهات، وبما يتمثل في سلوكياتهم العملية من مهارات عقلية وفنية وتقنية مختلفة، وما ينتج عن هذه المهارات من منجزات متنوعة.
ومما يدعم هذه الفكرة؛ فكرة أن الثقافة مركب عقلي معقد ماثل ومستقر ومتجدد في نفوس الناس وعقولهم، ذلك الفرق الواضح بين "الثقافة" بوصفهـا تركيبًا عقليًا، و"مظاهر الثقافة"؛ فالمظاهر الثقافية لشعب ما تتمثل في أجهزة وأدوات ومنشآت ومؤسسات وتنظيمات ونظم وعادات، وطقوس تؤدي في مناسبات مختلفة... فلو فرضنا أن هذه المظاهر قد دمرت عن آخرها بفعل كارثة طبيعية أو بفعل نزعة عدوانية عنصرية، على النحو الذي مارسته ولا تزال تمارسه بعض قوى الطغيان في العالم... هنا نقول: إن بعض مظاهر الثقافة قد دُمر أو أبيد، ولكن الثقافة ذاتها باقية في عقول ووجدانات آلاف الأفراد الذين ينتمون إلى الثقافة، ولن ينقضي وقت طويل حتى يستعيض هؤلاء الأفراد ما دمر من مظاهر ثقافتهم؛ بفضل جوهر الثقافة الماثل في عقولهم، والذي ينتقل من جيل إلى جيل. ([36]) والتفرقة بين الثقافة ومظاهر الثقافة قد تفسر لنا مظاهر الضعف الثقافي التي تطرأ على بعض الثقافات عبر الأحقاب الزمنية؛ لعوامل مختلفة، ثم استرداد الثقافة لعافيتها ما دام أبناؤها تتوفر لديهم الإرادة في بعث ثقافتهم، وماداموا قادرين على توفير وسائل النهوض والتمكين لبعث ثقافتهم، خير مثال لذلك، قدرة الالمان في اعادة بناء دولتهم بعد الحرب.
الثقافة – إذن – تمثل روح الجماعة أو الأمة، وهي القدر العقلي والوجداني المشترك بين أبناء الثقافة، الذي ييسر لهم التعايش، والتكافل والتناصح، والاعتماد المتبادل في كثير من شئون الحياة، يحدث هذا على الرغم من تباين ما يحوزه الأفراد في المجتمع من محتويات ثقافتهم، والثابت أن الثقافة – حتى في أبسط أشكالها – تضم محتويات لا يستطيع عقل فرد واحد أن يستوعبها بصورة كاملة؛ وإن يكن أبناء كل ثقافة قادرين على الإلمام بعدد من عناصر ثقافتهم، وإن لم يستطيعوا التعبير عنها؛ لأن هذا ليس مطلوبًا منهم.
خصائص الثقافة:
علي الرغم مما يظهر بين الثقافات من اختلاف أو تباين فهناك بعض الخصائص العامة لجميع الثقافات هذه الخصائص التي تستند إلي المفهوم العام الشامل للثقافة ومن هذه الخصائص العامة([37]) :
الاولى:- الثقافة ذات خاصية مادية ومعنوية معا : ثقافة المجتمع تحدد نمط وأسلوب الحياة في هذا المجتمع، والعناصر المادية هي عبارة عن تلك العناصر التي أتت نتيجة للجهد الإنساني العقلي والفكري وفي نفس الوقت لا تكتسب الثقافة وظيفتها ومعناها إلا بما يحيطها من معاني وأفكار واتجاهات ومعارف وعادات هذا فضلا عن أن العناصر المادية تؤثر بدورها في مفاهيم الأفراد وقيمهم واتجاهاتهم وعلاقاتهم أي أن الإحالة متبادلة بين العناصر المادية واللامادية داخل البناء الثقافي ومن ثم فإن البناء الثقافي يشمل العنصرين معا في آن واحد .
الثانية:- الثقافة عضوية :- هنالك علاقة عضوية، بين كلا من العناصر المادية وغير المادية، كل عضو يؤثر في غيره من العناصر، كما يتأثر به، فالنظام الاقتصادي يتأثر بالنظام السياسي والعكس صحيح كما أن النظام التعليمي يتأثر بالنظامين معا ويؤثر فيهما ومن جهة ثانية فإن العادات والتقاليد تؤثر في نظام الأسرة من حيث طريقة الزواج والعلاقة بين الكبير والصغير وإذا تغير أي عنصر من هذه العناصر فإنه سيتبعه تغيرا حتميا في النظم الأخرى أضف إلي هذا أن التغير في أساليب المعيشة يتبعه تغييرا في القيم والعادات ومن ثم فإن عناصر الثقافة يرتبط بعضها بالبعض ارتباطا عضويا يتسم هذا الارتباط بالديناميكية وليس بالاستاتيكية .
الثقافة مكتسبة :- الثقافة ليست فطرية في الإنسان بل يتعلمها الأفراد وينقلونها من جيل إلي جيل ويخطئ من يذهب إلي اعتبار الثقافة فطرية في الإنسان يكتسب الثقافة منذ سنواته الأولى حتى تصبح جزءا من شخصيته كما يصبح هو عنصرا من عناصر هذه الثقافة .ولقد اكدت الثقافة الاسلامية هذه الخاصية .*
الثقافة تراكمية : تتميز بعض عناصر الثقافة بالتراكم ذلك أن الإنسان يبدأ دائما من حيث انتهت الأجيال الأخرى وما تركته من تراث وبتراكم الجوانب المختلفة تتطور بعض جوانب الثقافة وتختلف درجة التراكم والتطور من عنصر إلي آخر فمثلا تتطور اللغة تراكمي يأخذ طريقا غير تراكم القيم وغير تراكم التطور العلمي والتكنولوجي ومعنى هذا أن الإنسان لا يبدأ حياته الاجتماعية والثقافية من العدم وإنما يبدأ من حيث انتهت الأجيال التي ينتمي إليها ومن التراث الاجتماعي الذي يعبر عن خبرات الأجيال السابقة .
إمكانية انتقال عناصر الثقافة بالاحتكاك : فكلما زاد الاحتكاك والتعامل بين مجتمع وآخر كلما زادت درجة الانتقال الثقافي بين هذين المجتمعين ولكن المجتمع ذو الثقافة الأقوى والأفضل يؤثر بدرجة أكبر في المجتمع ذي الثقافة الأقل نجاحا وقوة وبالتالي فالثقافة ديناميكية متغيرة. ومن ذلك يمكن ان نستنتج ان "الثقافة" إنسانية أي خاصة بالإنسان فقط فهي من صنع الإنسان وتشبع حاجاته، و إنها مكتسبة، و قابلة للانتقال والانتشار من خلال اللغة والتعليم ووسائل الاتصال الحديثة وتنتقل من جيل إلي جيل من فرد إلي فرد في المجتمع، وهي تطورية ومتغيرة فهي في نمو مستمر وتغير دائم،وانها تكاملية(تتكامل فيها العناصر المادية مع المعنوية)، و تنبئية (تساعد في التنبئ بسلوك الفرد في المجتمع)، وايضا نجد ان التراكمية في الثقافة تساعد في ظهور انساق جديدة .
وظيفة الثقافة:
إن القيمة الحقيقية للثقافة المحلية في أي مجتمع من المجتمعات تكمن في كونها ترتبط بالحياة اليومية للناس فتضع لهم الضوابط والقيم وتحدّد العلاقة في ما بينهم وترسم لهم الرؤية والسلوك الذي يستهدف خير المجتمع والدولة. ومتى نجحت الثقافة في القيام بهذه المهمة حق لأهلها الحفاظ عليها والتمسك بها، والاستماتة في الدفاع عنها. فتقدم الأمة أو تأخرها مرتبط إلى حد كبير بنوع ما فيها من ثقافة([38]). وجاء في موسوعة مقاتل الالكترونية :" تحدد ثقافة أي مجتمع أسلوب الحياة فيه، سواء من ناحية وسائل الإنتاج والتعامل والأنظمة السياسية والاجتماعية، أو من ناحية الأفكار والقيم والعادات والتقاليد وآداب السلوك، وغير ذلك"([39]). وتُعبّر عناصر الثقافة في أي مجتمع عن خلاصة التجارب والخبرات، التي عاشها الأفراد في الماضي، مشتملة على ما تعرضوا له من أزمات، وما حددوه من أهداف، وما استخدموه من أساليب، وما تمسكوا به من قيم ومعايير، وما نظموه من علاقات. وبهذا المعنى تُعَد الثقافة أساساً للوجود الإنساني للفرد والمجتمع الذي ينتمي إليه.
ومن وظائف الثقافة المتعددة، إذ توفر للفرد، صور السلوك والتفكير والمشاعر التي ينبغي أن يكون عليها، وسائل إشباع حاجاته العضوية البيولوجية والسيكولوجية الاجتماعية. تقدم تفسيرات جاهزة لطبيعة الكون وأصل الإنسان، ودوره في هذا الكون، وتعطي المعاني والمعايير التي يميًز في ضوئها بين الأشياء والأحداث؛ فهي التي تحدد له الجميل والقبيح، الأخلاقي وغير الأخلاقي، كما انها تحدد الاتجاهات والقيم ما يساعد الفرد في تكوين ضميره الذي يتواءم به مع جماعته، ويعيش متكيفاً معها، وما يشعره بالانتماء لجماعته، و يربطه بسائر أفرادها لتميزهم عن سائر الجماعات الأخرى([40]).
إنتشار الثقافة:
تمتاز الثقافات بقدرتها على الانتقال من منطقه لمنطقه نتيجه لإتصال المجتمعات ببعضها البعض ، عن طريق الغزو أو بالهجره و طرق سلميه اخرى، مثل التبادل التجاري، ولقد جدت طرق انتشار "الثقافة" الاهتمام من علماء الأثار و الانثروبولوجيا، و يعتبر "اليوت سميث Elliott Smith" و" وليام جراهام سمنر William Graham Sumner" من أهم علماء المدرسة "الإنتشارية Diffusion’s School" الذين حاولوا ان يبرهنوا على انتشار الثقافه المصريه القديمه لمناطق كتيره فى العالم ، و حاول ثور هيردال Thor Heyerdahl عملياً إثبات إمكانية إنتشار الثقافه من منطقه لمنطقه بعيده عبر المحيط، ووصول الثقافه المصريه القديمه الي مكسيك االتي عرفت الأهرامات ايضا، و فى ثقافتها عناصر تشبه عناصر الحضاره المصريه القديمه مثل التحنيط([41])". "يفترض دعاة هذا الاتجاه أن الاتصال بين الشعوب المختلفة قد نتج عنه احتكاك ثقافي وعملية انتشار لبعض السمات الثقافية أو كلها وهو ما يفسر التباين الثقافي بين الشعوب. وينطلق دعاة هذا الاتجاه من الافتراض بأن عملية الانتشار تبدأ من مركز ثقافي محدد لتنتقل عبر الزمان إلى أجزاء العالم المختلفة عن طريق الاتصالات بين الشعوب، وبما أن نظرية الانتشار الثقافي تسعى إلى الكشف عن حلقات لربط الثقافات معاً نتيجة تفاعلها جغرافياً وزمنيا فإنها تلتزم أيضاً بالمبدأ التاريخي في علاقات الثقافات بعضها بالبعض الآخر. وقد ظهرت في أوروبا مدرستان للانتشار الثقافي. كان فريدريك راتزل رائداً للمدرسة الأولى وتبني منهجاً تاريخياً-جغرافياً بتأثير المدرسة الجغرافية الألمانية وركز على أهمية الاتصالات والعلاقات الثقافية بين الشعوب ودور تلك العلاقات في نمو الثقافة. أما هاينرينج شورتز فقد أبرز فكرة وجود علاقات ثقافية بين العالم القديم (اندونيسيا وماليزيا) وبين العالم الجديد (الأمريكتين). وقد طور ليو فروبينيوس فكرة انتقال الثقافات عبر المحيطات بادعائه حدوث انتشار ثقافي من اندونيسيا إلى أفريقيا. بهذا يكون ليو فروبينيوس أول من أدخل مفهوم "الدائرة الثقافية" في الاثنولوجيا وهو المفهوم الذي نال تطوره اللاحق في أعمال جرايبز فكرة أحادية منشأ الثقافة الإنسانية مفترضاً وجود عدة مراكز ثقافية أساسية في جهات مختلفة من العالم.. وبفعل التقاء الثقافات نشأت دوائر ثقافية وحدثت بعض عمليات الانصهار وبرزت تشكيلات مختلفة وهو الأمر الذي يفسر الاختلافات البادية في الثقافات الأساسية([42]).
ويرى ب.حسن مكي ،ان انتشار اثقافة العربية والاسلامية في دارفور ارتبط بطريق الحج، حيث ذكر ان قوافل الحج كانت تمثل حراكاً سكانياً فكأنها مدن مهاجرة فيها الأمراء وقواد الجيش والفقهاء والنساك والنساخ والفعيلة وأهل الصناعات والتجار وطالبوا المغامرة وكسب العيش والصوفية ، فكانت مدناً متحركة وطنت الفقه المالكي والطريقة التيجانية وكثيراً من ثقافات ما يسمى بالإسلام الأسود المختلط بالسحر والتعاويذ في هذه المنطقة، ومثل "طريق الحج طريق التمكين لهذه الثقافة حيث كان الحجاج المسلمون يأتون من تمبكتو وما جاورها ثم يمرون بكانو ثم بأرض تشاد الحالية عبر هضبة أبشي ثم إلى دارفور ثم ينتشرون في السودان"([43]) ويرى الباحث، أن حسن مكي في هذا يؤكد ما ذهب اليه علماء الانثروبولوجيا الغربيين في فهمهم لطرق انتشار الثقافة.
إنتـــــقال الثقافــــــة:
تتكون المجتمعات الإنسانية من مجموعات منظمة من الأفراد هم غالباً من الجنسين ومن مختلف الأعمار ، ولهم منظومة من القواعد السلوكية التي تنتقل من جيل إلى جيل آخر. هذا الكلام ينسحب على مناح أخرى من الحياة حتى يصل إلى الكائنات غير الحية مثل العديد من الحيوانات ومن ضمنها ثدييات وحشرات ، فهذه لها أيضاً مجتمعات ، إلا أنّ طريقتها في نقل السلوك الاجتماعي تختلف في أساسها عن طرق المجتمعات البشرية تلك. الحشرات تنقل سلوكها الاجتماعي بالوراثة البيولوجية.
يتم تعلم السلوك الإنساني إما كلياً أو يتم تعديله تعديلاً جذرياً عن طريق التعلم الاجتماعي. وحتى هذه المناحي البيولوجية القوية ، أو الغرائز مثل الجنس والجوع يتم تعديلها وتطويرها بالثقافة، فمثلاً نجد ان نسق "الحلال والحرام taboo system " يقوم بتقنين السلوك الجنسي عملياً باستخدام تعبيرات تعكس دلالات العيب الاجتماعي في كل المجتمعات الإنسانية، بل وربما يرفض الناس الجياع الطعام الذي ينتهك حرمتهم الدينية (ما يعتبر عيباً دينياً) مثل أكل لحوم الكلاب والقطط الشائع بين شعوب جنوب شرق أسيا، أو لحم الخنزير الشائع بين شعوب أوروبا وأمريكا اللاتينية ، أو ينتهك قوانين الحمية الغذائية، أو ينتهك ما يعتبرونه بغيضاً لثقافتهم كأكل الضفادع وبعض الحشرات الأخرى.
ومن هنا يمكنني القول بأنه صار ممكناً ، في الأغلب ، اعتماد البشرية على السلوك التعليمي وذلك بمظاهر بيولوجية نادرة للإنسان بوصف هذا الإنسان نوعاً بيولوجياً. وحيث أن البدايات في أي أمر مهمة للنجاح ، نرى أن وجوب الاهتمام الشديد بدورة الحياة الطويلة نسبياً للطفل والفترة الممتدة لنموه ، وهى التي يكون خلالها الطفل البشري معتمداً على والديه ، ومتعلماً منهما ومن من حولهم من بالغين آخرين([44]). وهذا يعني ان فكرة الفرد عن نفسه وعن الاخر تبدأ من التنشأة، إما ان يكون الاخر الثقافي مقبلولاً لديه وتنشأ علاقات التعايش عن رضا، او مرفوضاً فتنموا معه دوافع الصراع الاجتماعي، ويرى الباحث انها يمكن ان تمثًل كوابح لتقدم المجتمع وتطوره. ولقد اكدت هذا الاتجاه، الاستاذة نوره الحمودي في نقدها لنظريتي "انتقال الثقافة الفرعية" و"الارتباط المتغاير"* - نظرية الاختلاط التفاضلي- " أن هذه النظرية تعتبر بحق أول نظرية اجتماعية ذات منهج علمي واضح وفرضيات علمية محددة في مجال تفسير السلوك الإجرامي والمنحرف كسلوك اجتماعي يمكن أن يتعلمه الفرد ، والحقيقة أن موضوع تعلم السلوك الاجتماعي بوجه عام والسلوك الإجرامي بوجه خاص سبق أن تناوله الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي "تارد" من خلال نظريته في التقليد حيث يرى تارد أن جميع أنماط السلوك تتكون بتأثير مثال يحتذى وفعل يندفع الناس إلى النسج على منواله، والتقليد عند تارد يتم وفق قوانين ثابتة وهذه القوانين الثلاثة هي:
1- يقلد الناس بعضهم بعضاً كلما كانت صلاتهم أكثر عمقاً.
2- ينتقل التقليد من الأعلى إلى الأسفل ومن الأدنى إلى الأعلى أي يقلد الصغير الكبير والفقيرالغني.
3- قانون الاندماج أو قانون تداخل الموضات والعادات وتزاحمها وحلول بعضها محل البعض الآخر فالقتل بالسكين كان عادة عرفها أكثر الشعوب وحين ظهرت موضة القتل بالسلاح الناري والبنادق الآلية زاحمتها وصارت أكثر انتشاراً منها.
وذكرت ان "تارد" يعتقد أن السلوك الإجرامي لا يشكًل سمة أو مرضاً ينتقل إلى الإنسان بالوراثة بل هو مهنة يتعلمها الإنسان من خلال اختلاطه بالآخرين وتقليده لهم وذلك حين يختار لنفسه مثلاً معيناً يحذو حذوه، و هذا الرأي يؤيده كذلك العالمان ميرتون و دور كايم([45])
التخلف الثقافي:
يرى عامر"ان التغيير الذي يحدث في المجتمع قد يتم بخطوات وئيدة فيكون نموا ، وقد يكون متدرجا فيكون تطورا ، وقد يكون في قفزات كثيرة فيكون ثورة أو انقلابا أو طفرة ، ولا يلحق التغيير بكل عناصر المجتمع ، وإنما قد يكون أكبر وأعمق في العناصر المادية منه في العـناصر المعـنوية ، والفجـوة الناجـمة عن ذلك قد يترتب عليها ما يعرف بالتخلف الثقافي" ([46]) . لذ تحمل التقانة معها خصائص الثقافة التي طورت فيها أول مرة . وعندئذ تبدأ الثقافة التقليدية التي يصفها البعض بالجمود والسكون تشهد عمليات تباين واسعة النطاق تؤدي إلى تغيرها لكي تتقرّب من النموذج الغربي، فعملية التحديث هي عمليةٌ تحتل في اكتساب واستيعاب المجتمعات التقليدية النامية لقيم وتنظيم المجتمعات الحديثة، ويتوقع أن يفرز هذا التغير البطيء المتدرّج الذي يتم عن طريق تحديث الأبنية الاجتماعية بعض المشكلات من مظاهر التناقض بين القديم والجديد، ومن مثل ما عبر عنه "أوجبرن"* بالهوة الثقافية التي تنتج عن اختلاف سرعة تغيّر العناصر المادية وتغيّر العناصر المعنوية. وحسب اوجبرن، كلما ازدادت دائرة التغير وتكيف المجتمع للتغير اتساعا، ضعفت هذه المشكلات وزال أثرها . ومن هنا يظهر أثر العوامل الداخلية حيث تختلف المجتمعات في مقدرتها على تطوير عناصر محلية تعمل على خفض التوتر الناتج عن استيراد الأنظمة، والمؤسسات الحديثة ، وتطوير وسائل تضاعف من سرعة عملية التكيف مع الجديد ، لترجع حالة التوازن الى البناءات الإجتماعية. لذلك عُرف "التخلف الثقافي عجز أقسام ثقافية بعينها عن مواكبة التغيرات التي تحدث في أجزاء أخرى مرتبطة بها. "وكان وليم ف. أوجبرن أول من استخدم هذا المصطلح في عشرينيات القرن العشرين لاحظ أوجبرن أن التقدم التقني قد أحدث تغيرات سريعة في الثقافة المادية بما فيها السكن والآليات والعمليات الصناعية، ولكنه لاحظ أن الثقافة غير المادية بما في ذلك الأفكار والقيم والنظم الاجتماعية، تكون في الغالب متخلفة عن الثقافة المادية، ويرى أوجبرن أن مشكلات اجتماعية كثيرة تنجم عن التخلف الثقافي، فالاختراعات الحديثة، مثلاً قد تحل محل الكثيرين من العمال، واذا اخذنا مجتمع زالنجي كمثال: نجد بالرغم من التطور الذي حدث في المؤسسات العدلية (القضاء،الشرطة، النيابات،..وغيرها)، الا ان الجودية لا زالت تلعب دور محوري في تسوية النزاعات والمشكلات الاجتماعية..!، وفي ظل وجود معتمد للمحلية(كوظيفة دستورية حديثة)، الا ان الادارات التقليدية (نظام الادارة الاهلية)، بيدها مقاليد الامور في الكثير من القضايا الإجتماعية والسياسية والأمنية في المحلية.
مفهوم التنمية الاجتماعية
إن دراسة المجتمع كانت ولا تزال المحور الأساسي لمختلف الأبحاث والدراسات من طرف المفكرين والباحثين ولعل من أهم القضايا التي تركز عليها هذه الدراسات هي قضية التخلّف خاصة في دول العالم الثالث نتيجة تعقد واتساع مشكلات الحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية وحتى الثقافية المعاصرة. والتنمية، بصفتها مفهوماً نظرياً وتطبيقياً عملياً، على ساحة الفكر العالمي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين؛ نتيجة لمتغيرات عدة، أهمها: تزايد حركات الاستقلال الوطني من ناحية، واتساع حركة المد الاشتراكي. وأصبحت شعاراً للطموح والجهد والإنجاز، على المستويَين: القومي والعالمي. ثم اكتسبت القضايا المرتبطة بالتنمية مزيداً من اهتمام الباحثين والمخططين وتركيزهم؛ حتى إنهم اختلفوا في غاياتها وأهدافها، فتعددت وتباينت أنماطها ومستوياتها. من ثَم، أصبح ضرورة لكلّ منهم، قبل الخوض في موضوعاتها، أن يحدد المستوى الذي يعمل في إطاره، ومدلول التنمية الذي يستخدمه. لذا، امتنع ساندرز عن تعريف مفهوم التنمية، وآثر تركه ليعني ما يعنيه، وفقاً لمقصد كلّ باحث، في أيّ بلد من بلدان العالم.
مفهوم المجتمع :
المفهوم الشائع للمجتمع أنه مجموعة من الأفراد والجماعات تعيش في موقع جغرافي واحد وتربط بينها علاقات اجتماعية وثقافية ودينية.ومن ذلك نجد أن العناصر التي تكّون المجتمع تتمثل في:
• إدراك أفراد المجتمع وشعورهم بأنهم يكوّنون وحدة واحدة.
• نطاق جغرافي يجمع أفراد المجتمع وجماعاته.
• وجود نظام يسمح لأعضاء المجتمع بالتعبير عن آرائهم.
• تمكّن المجتمع من إشباع الاحتياجات الأساسية لأفراده إلى حد ما.
• وجود سلوكيات اجتماعية داخله مثل التعاون، التكافل والصراع.
• بناء اجتماعي خاص به. ([47])
التنمية لغة:
لفظ التنمية مشتق من نمى بمعنى الزيادة، يقال نمى ينمي نميا ونميا ونماء، زاد وكثر، ومنه نميت النار تنمية إذا ألقيت عليها حطبا وذكيتها به([48]). وأما لفظ النمو مشتق من نما نميا ونماء، ويعني أيضا الزيادة ومنه نما الشيء نموا زاد وكثر، يقال: نما الزرع ونما الولد، ونما المال([49]). فالنامي ما يزيد، والنماء يعني أن الشيء يزيد حالا بعد حال من نفسه لا بإضافة إليه. [ولا يقال لمن أصاب ميراثا، أو أعطي عطية أنه قد نما ماله، وإنما يقال: نما ماله: إذا زاد في نفسه([50])، النمو ازدياد حجم الجسم بما ينضم إليه ويداخله ويطلق مصطلح النماء عند الفقهاء على نفس الشيء الزائد من العين كالزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات ونحوها([51]). وأما لفظ التنمية فيقصد به في اللغة تبليغ الكلام على وجه الإفساد والنميمة، يقال نمَّيت الحديث أنميه تنمية، وإذا خفف الفعل يراد به رفع الحديث على وجه الإصلاح يقال: نميته([52]). ونخلص من ذلك بأن التنمية لغة تعني الزيادة المضطردة والاكثار كماً ونوعاً والمدفوع بسبب ما.
التنمية اصطلاحا:
ينبغي التأكيد أن مفهوم التنمية الاجتماعية، مثل غيره من المفاهيم الأخرى في العلموم الاجتماعية، لا يوجد اتفاق على تعريفه وعليه فمن الصعوبة بمكان التوصل إلى تعريف جامع مانع لهذا المفهوم. مع الاخذ في الاعتبار أن وجهة النظر الاجتماعية بالنسبة للتنمية ،"لم تنصب على جانب واحد وٕانما تعددت النظرة إليها. وقد أكد (هوبهاويس Hobhouse) على دارسة العلاقات الاجتماعية، فالتنمية في نظره هى تطور البشر في علاقاتهم المشتركة وهذا ما يسميه بالتوافق في العلاقات الاجتماعية، فتغير البناء الاجتماعي لا يعنى شيئا بالنسبة له مالم يحدث تغيير في طبيعة العلاقات الاجتماعية، ولهذا ينظر إلي التنمية الاجتماعية على أنها تنمية علاقات الإنسان المتبادلة ولقد وضع "هوبهاوس: أربعة معايير تستند إليها" التنمية العالية" على حد قوله ويعنى بها التنمية المتواصلة الشاملة، ويذهب إلى أنه من أجل تقدم المجتمع يجب توافر هذه المعايير الأربعة وألا فستكون التنمية منقوصة غير كاملة، لو تخلف أحد هذه الشروط وهذه المعايير"([53]) هى:
١- الحجم السكان Scale
٢- الكفاية Efficiency
٣- الحرية Freedom
٤- المشاركة Mutuality
ويقصد بالحجم عدد السكان، والكفاية يعنى بها تخصيص وتنسيق الوظائف في خدمة البيئة، أما الحرية فيعنى بها مجال الفكر والشخصية والمبادرة من جانب أعضاء المجتمع، وأخيرا مشاركة الأفراد. ولقد ذكر الدكتور ثروت الهيتي، ان البعض يرى ان التنمية الاجتماعية تعني الجهود التي تبذل لإحداث سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع وذلك بزيادة قدرة أفراده على استغلال الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق اكبر قدر من الحرية والرفاهية لهؤلاء الأفراد بأسرع من معدل النمو الطبيعي.ويرى روب Roupp أن التنمية الاجتماعية هي عبارة عن تغير من " مواقف غير مرغوب فيها إلى مواقف أخرى مرغوب فيها وذلك عن طريق استخدام الموارد البشرية من اجل إعطاء هذا التغيير مظهرا منطقيا لغرض تحقيق الأهداف المتوخاة " ، فالتنمية الاجتماعية بوصفها مفهوما تشير إلى عمليات مخططة وموجهة يتم بواسطتها إحداث تغير اجتماعي مقصود ومرغوب في أبنية المجتمع ووظائفه وفي مواقف الأفراد والجماعات نحو أنفسهم ونحوالمجتمع([54]).
ووفقا للدكتور الطاهر، ان هناك من يرى أن التنمية من المنظور الاقتصادي الاجتماعي، تعني العمليات التي يقوم بها المجتمع لزيادة استخدام راس المال والخدمات المختلفة بهدف زيادة إنتاج السلع والخدمات التي من شانها أن ترتفع بمستوى المعيشة كنتيجة لارتفاع الدخل القومي للمجتمع وارتفاع متوسط نصيب الفرد، وما يصاحب كل ذلك من عمليات للتنمية في المجالات الاجتماعية المختلفة التي تتجه إلى الارتفاع بمستوى حياة الأفراد اقتصاديا واجتماعيا، فالنتيجة الاقتصادية والاجتماعية إذن هي رفع المستوى الاقتصادي للدولة لكي تتمكن من الوفاء باحتياجات أفرادها، ويصاحب ذلك عملية تغيير في العادات والتقاليد السائدة في المجتمع بما يتماشى والوضع المستهدف ([55]). وبناء على ذلك يرى الباحث أن التنمية الاجتماعية تعتبر الكل الذي يتكامل مع التنمية الاقتصادية. وعليه يمكن القول بان التنمية الاجتماعية تعني التحسين المستمر للأمور والتي تؤدي إلى حياة أفضل للسكان وهي تأخذ مكانها جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية ويعتمد أحدهما على الآخر ، ولذلك نلاحظ أن الاقتصاديين بدءوا مؤخرا يهتمون بالعوامل الاجتماعية كمعدل النمو السكاني وتركيب العائلة والفرص التعليمية والاختلافات المهنية والطبقية واتجاهات أو تيارات التحضر ولم يقتصروا على تعريف التنمية بالعامل الاقتصادي فقط. "ويرى بعضهم أن هناك بوجه عام منظورين لمفهوم التنمية: الأول: اقتصادي تقاني يركز على نواحي الاستثمار والإنتاج ، وان تطرق إلى الجوانب الاجتماعية التي تحدد هاتين التاجيتين من النشاط المجتمعي.
أما المنظور الثاني: فهو في الأساس حضاري واجتماعي وسياسي وان لم يهدر الجانب الاقتصادي ، ويرى أن النواحي الاقتصادية هي من الوظائف الاجتماعية المهمة وليست بالضرورة أهمها ، فهي تابع للكيان الحضاري وللبنى الاجتماعية السياسية تتكيف بها أهدافا وفعالية في عملية تاريخية تستهدف ترقية الرفاه الاجتماعي للبشر في مجتمع متخـلف بصورة جوهرية."([56])
وهناك من يعرف التنمية بمفهومها الشامل بأنها " الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط اجتماعي معين بقصد تحقيق مستويات أعلى للدخل القومي والدخول الفردية ومستويات أعلى للمعيشة والحياة الاجتماعية في نواحيها المختلفة كالتعليم والصحة والأسرة والشباب... ومن ثم الوصول إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهيةالاجتماعي.
وبناء على ما تقدم فان التنمية الاجتماعية لا تعطي الرفاه المادي الأولوية وان لم تهمله إلا إنها تضع الإنسان وتمتعه بالحرية والمساواة وغيرها من القيم الإنسانية في مصاف الغايات الأسمى فهي تعد الناس بشرا وليسوا آلات ، فالناس وان كانوا أداة التنمية إلا أنهم بوصفهم بشرا ينبغي أن يكونوا غاياتها ، وبذلك تكون التنمية أسلوبا من أساليب النهوض بالمجتمعات، وعلى هذا الأساس فهي لا تعد غرضا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق أغراض معينة يبتغيها المجتمع ، إذن فالتنمية الاجتماعية ليست مجرد تقديم نوع معين من أنواع الخدمات بل هي عملية تغيير للأوضاع الاجتماعية القديمة وإحلال أوضاع اجتماعية جديدة محلها ، أي بمعنى أدق تغيير الأبنية الاجتماعية القديمة التي أصبحت غير قادرة على مسايرة أنماط الحياة العصرية وإقامة أبنية اجتماعية جديدة مختلفة كل الاختلاف عن الأبنية الاجتماعية القديمة ويتبع ذلك ظهور ونشوء علاقات وقيم اجتماعية جديدة تحقق لأفراد المجتمع كل ما يصبون إليه من إشباع لحاجاتهم المادية والمعنوية. إن ذلك يعني أن التنمية الاجتماعية ما هي إلا عملية تغيير لأنماط السلوك والعادات والتقاليد والقيم ضمن حركة إرادية هادفة ومستندة إلى تخطيط علمي مسبق مستمد من دراسات موسعة وشاملة لمعرفة البدائل المناسبة واختيار أمثلها تحقيقا لحياة أفضل وأحسن .
وبذلك نستطيع القول إن التنمية الاجتماعية ليست مجرد عملية تقديم بعض الخدمات الاجتماعية وإنما هي تتجاوز ذلك لتصل إلى تغيير البناء الاجتماعي القائم وإحلال بناء اجتماعي جديد قادر على مسايرة متطلبات العصر الحديث وقادر على إشباع حاجات ومطالب الأفراد. اذا فالتنمية الاجتماعيةهي: "عملية إرادية مخططة هادفة وبناءة تطمح إلى تفعيل الطاقات والإمكانات والموارد المادية والبشرية واستنفار جهود الدولة وقطاعها العام والجماهير وقطاعها الخاص من اجل إحداث تغييرات في المجالات الاجتماعية كالنظم، والمواقف ، والقيم والمعتقدات دون إهمال الحاجات الأساسية والخدمات والمستوى المعاشي أي العمل على توفير كل ما من شانه خدمة الإنسان ورفاهيته ورفع مستواه المادي والروحي حاضرا ومستقبلا". ووبناءاً عليه فان التنمية الاجتماعية تمتد إلى عدة مجالات تتشعب وتتفاعل مع بعضها ضمن هذه المجالات كالتعليم، والصحة، والإسكان والضمان الاجتماعي ، كذلك فإنها تهتم بالنظم، والقيم، والتقاليد، والعادات والاتجاهات والمورثات الاجتماعية حيث تعمل التنمية الاجتماعية على تشجيع وتفعيل ما هو مثمر منها من وجهة نظر المجتمع وإزالة ومعالجة ما يقف منها عقبة في سبيل التطور والتقدم.
الاتجاهات النظرية في دراسة التنمية الاجتماعية:
في متابعته لتطور مفهوم التنمية ذهب د. يوسف الي انه "يمكن البحث عن الجذور الأولى لمفهوم التنمية في المحاولات المبكرة التي قام بها الإنسان الأول لمعرفة التغييرات التي تجري من حوله. لقد ارتبطت تلك الجذور بالمشاهدة الحية والتأمل في التغييرات التي تحدث في الموجودات كفصول السنة والنبات والإنسان والحيوان، حيث أوحت بأن هذا الكون في حركة مستمرة وتغير دائم. وكانت نتيجة تلك المشاهدات والتأملات بروز جدل فلسفي متواصل حول ماهية الأشياء وطبيعة المتغيرات التي تحدث فيها"([57]). كما ارجع د.يوسف ، الفضل في اثارة الإسئلة، والجدل ووتحليل الاوضاع الاجتماعية، ومحاولة فهم اسباب والظواهرالاجتماعية، وما يطرأ عليها، الي الفلاسفة اليونانيين. ولكن يرى الباحث ان جل إجتهادات الفلاسفة اليونانيين، كانت حول الدولة ونظم الحكم واصل الانسان، والقيم، كما انها كانت تعطي تصورا لرؤية الفلاسفة للنظم الاجتماعية المثالية دون توضيح كيفية تحقيق ذلك(المدينة الفاضلة للافلاطون). في المقابل نجد ان د.ادم احمد،في تناوله لتطور مفهوم التنمية افاد "بان الثابت لدي علماء الاجتماع ان مصطلح التنمية ظهر عقب الحرب العالمية الثانية وتحديدا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي حيث نال معظم بلدان العالم الثالث إستقلالها السياسي من المستعمر الغربي وقد تناوله بالحديث الصفوة من أبناء وبنات بلدان العالم الثالث، من أساتذة الجامعات ورجال الإقتصاد والقانون والإجتماع والسياسة، لما رأوه من تطور وتقدم في البلدان المتقدمة والفجوة الواسعة بين تلك المجتمعات ومجتمعات العالم الثالث في كافة مناحي الحياة . وكذلك تناول موضوع التنمية رواد الإستقلال (الذين تحقق على أيديهم الإستقلال ) و كانت خطاباتهم لشعوبهم ذات مغزى تنموي بالدرجة الأولى"([58]). بمعني ان هذه المقارنة من نخب العالم الثالث جاءت نتيجة للاحتكاك بالمجتمع الغربي، وذلك لان معظم النخب التي ظهرت ابان فترة الاستعمار كانت اما انها تلقت تعليمها(الجامعي،وفوق الجامعي) في الغرب نفسه – "الصادق المهدي"* و"حسن الترابي"** في السودان مثلاً، و"كوامي نكروما"*** في غانا- أودرسوا محليا وفق المنهج الذي وضعه المستعمر، ضمن سياسة موجه من المستعمر للإدارة شئون المستعمرات بابنائها، مثل مشروع "سودنة الوظائف في السودان"، وعليه يرى الباحث أن هذه النخب بالرغم من ميولها الوطني الا انها لم تستطيع تحويل التحصيل النظري الي برنامج عملي يمكن ان يحقق تنمية في تلك الدول. وهذا ما وصفه الدكتور منصور خالد، بـ" تصدع الذات، الذي يقود بطبعه الي فجوة بين الفكر والممارسة؛ بين ما يقول المرء وما يفعل، بين التصالح مع الواقع السلبي في المجتمع والإدانة اللفظيًة لهذا الواقع" ([59]).ونجد ان مفهوم التنمية في تلك الحقبة في بعده النظري يعني "التحديث".ومن ابرز نظريات نموزج التحديث كانت نظرية مراحل النمو لـ "روستو"*
اتجاه التحديث:
و "لقد نشا وتطور هذا الاتجاه في الخمسينيات وبداية الستينيات من هذا القرن على ايدي عدد من علماء إلاجتماع والاقتصاديين لا سيما مجموعة من الباحثين إلامريكيين وابرزهم من المعاصرين بارسونز وقد أكد اغلبهم القيم وإلاعراف التي تؤثر في المجتمعات الحديثة والتقليدية وفي انظمتها الاقتصادية والأجتماعية ، وكما فعل دور كايم وفيبر قبلهم ، إذ يرى اكثرهم ان التحول من العلاقات الاقتصادية المحدودة للمجتمع التقليدي إلى المؤسسات الاقتصادية التجديدية المعقدة للمجتمع الحديث يعتمد على تغيير مسبق في قيم ومواقف واعراف الناس "([60]). وذهب احمد سيد، الي ان إلاهتمام بالتنمية من هذا المنظور هو اهتمام بالتغير إلاجتماعي وبالتحضر ، ويرى ليرنز ان نمو المراكز الحضرية الجديدة في العالم الثالث هو نقلة تقدمية، تشجع الفردية وتقلل من شان عائق التقليدية، ويدعى ان التحضر هو قوة لزيادة مستوى المشاركة في المجتمعات، فالسكان يصبحون اكثر مشاركة كلما تطورت لديهم المواقف الجديدة وإلأنفتاح الجديد والمناقشة التي تشجع قابلية التحول النفسي ، فضلاً عن ذلك فان متطلبات الحياة الحضرية تشجع تطور بعض جوانب الحياة مثل القراءة والكتابة كذلك فان إلافكار الجديدة لهذه البوتقة الحضرية تتسرب إلى المناطق الريفية والتي بدورها تصبح اكثر انتاجية لأدراك الفلاح للطلب المتزايد على السلع الغذائية من سكان المدن ، ولذلك تنمو المدينة والريف معا نتيجة لتبادل السلع المادية والحضارية. الا ان الدكتور ادم احمد، نموزج التحديث والذي يعني "ان التحديث من الناحية التاريخية هو عملية التحول نحو تلك إلأنماط من إلأنظمة الأجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تطورت في اوربا الغربية وامريكا الشمالية بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر" قد فشل من واقع التطبيق، وذلك لانه محاكاة لأوربا التي نهضت بالصناعة لأنها كانت تملك مقومات الصناعة (الإنسان المدرب والمؤهل ,رأس المال الضخم,التكنولوجيا ,مراكز البحث العلمي والأسواق) في حين تفتقر معظم بلدان العالم الثالث لمعظم هذه العوامل ([61]).وحسب الباحث، ادي ذلك الي الهجرة من الريف الي المدن، والتي ادت بدورها الي الضغط علي الخدمات في مناطق الاستقبال، وانتشار البطالة ، بسبب عدم قدرة الصناعة في استيعاب كل العمالة الوافدة من الريف، وظهور المناطق العشوائية حول المدن، والاعمال الهامشية، او مايسميه علماء الاجتماع بـ "ترييف المدن"وارتفاع معدلات الفقر في الريف وفي المدن.
اتجاه التبعية او التخلف.
ظهر اتجاه التبعية في الستينيات من هذا القرن، حيث يري غازي ان "التبعية هي ظرف موضوعي تشكًل تاريخياً ، ينطوي على مجموعة علاقات اقتصادية وسياسية ومالية وعسكرية وثقافية ، حيث يتم بمقتضى علاقات التبعية هذه، توظيف موارد المجتمع التابع لخدمة الدولة المسيطرة عليه، فالتبعية إذن - في ظروف العولمة الإمبريالية والصهيونية الراهنة – هي الحاق مجمل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول الفقيرة أو ما كان يعرف بـ-العالم الثالث- أو البلدان المتخلفة عموما وبلداننا العربية خصوصا باقتصاد النظام الامبريالي المعولم"([62]). ويستمد هذا الاتجاه افكاره من تحليلات النظام الاقتصادي الراسمالي التي وضعها ماركس، وان كان اصحاب هذا الاتجاه يرفضون فرضية الامبريالية لدى الماركسبه القديمة او الكلاسيكية التي ترى ان التوسع العالمي للرأسمالية يمكن ان يكون مدمرا للنظام قبل الرأسمالي، على الرغم من انه سيساعد في ايجاد مجتمع جديد اكثر انتاجية([63])، وقد نشأت نظرية التبعية، كردة فعل لفشل و قصور النظريات الاجتماعية و الاقتصادية الأخرى التي حاولت تفسير التخلف، في أمريكا اللاتينية .. بصفتها أقرب الشعوب معاناة من محاولات النمو الاقتصادي القائم على التكامل الاقتصادي الذي كان يصب في مصلحة الدول الرأسمالية الاستعمارية"وأسهمت اللجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ECLA التابعة للأمم المتحدة في بلورة هذا الإدراك من خلال النقد الذي وجهته لنظرية التبادل الدولي ( الذي تقوم على أساس أن كل دولة لها ميزة نسبية و من الأفضل لها أن تتخصص فيما تتميز به ) فمثلا السعودية لديها ميزة في انتاج النفط الخام فمن الافضل لها لتحقيق اكبر المكاسب ..في تجارتها الدولية ( التبادل الدولي ) أن تتخصص في انتاج النفط وتصديره و تكتفي باستيراد ماتحتاجه من الدول الاخرى ذات "الميزة النسبية"* في أشياء اخرى([64]). واصحاب هذه النظرية يرفضون اراء وافكار اتجاه التحديث التي تؤكد ضرورة انتشار خصائص المجتمعات الغربية وتبنيها من قبل المجتمعات النامية او إلاقل تقدما ويرى اغلب دعاة هذا الاتجاه ان التنمية يمكن ان تحدث فيما اذا اتيحت الفرصة المناسبة للبلدان النامية، ولكنها مادامت تابعة فان تخلفها وفقرها سيستمران ولا يمكن ان تنمو وتتطور إلا اذا تحررت سياسيا واقتصاديا وخرجت من دائرة التبعية . ولقد " قدمت رؤية شاملة للنظام الدولى ولطبيعة العلاقات بين العالم المسيطر والعالم التابع، تجمع بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما طرحت تفسيرا أكثر شمولية من نظريات غربية عديدة لقضية التخلف فى العالم الثالث يقوم على مزج التحليل المعاصر بالتطور التاريخى لعلاقات السيطرة والتبعية" ([65]) ، فيما يرى انصار هذه النظرية، ان التنمية تعني شيئا اكثر من مجرد النمو مهما كان حجمه نسبة الى إجمالي الناتج القومي، فهي تتضمن تحسينا حقيقيا في المستوى العام للحياة، عن طريق التغذية الكافية وإلاسكان والرعاية الصحية والتعليم.... الخ، فيما يتعلق بجميع السكان وتقليل التفاوت الهائل في توزيع الثروة والدخل، والتوسع في خلق الفرص الاقتصادية، والتنموية، لجميع السكان والمناطق، بشكل عادل.
نخلص من ذلك الي ان دعاة اتبعية يدعون الي فك الارتباط بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث، واعطاء المجتمعات النامية الفرصة للنهوض انطلاقا من الاعتماد علي الذات، وبما أن فك الارتباط نهائيا اصبح شبه مستحيل في عالم القرية الواحدة- عالم اليوم- فقد وجهت لهذه النظرية الكثير من الانتقادات.
اولا: وقعت في نفس الخطأ الذ وقعت في النظريات الغربية لتفسير التخلف،عندما اختزلت اسباب التخلف في العوامل الداخلية لدول العالم الثالث، فنجد ان نظرية التبعية اختزلت اسباب التخلف في العوامل الخارجية.
ثانيا: التبعية إذ ترجع التخلف إلى سبب انتزاع البلدان المتقدمة للفائض المتحقق في البلدان المتخلفة على أساس التبادل اللامتكافىء للمنتجات، القائم على تخصص لا متكافىء للعمل, فإنها تفسر التخلف بصورة اقتصادية, فالتخلف مسألة أعقد بكثير من أن تفسر بآلية اقتصادية محددة أو بآليات اقتصادية متعددة، معزولة عن الآليات السياسية والثقافية التي بالضرورة ترتبط بها الآليات الاجتماعية العامة([66]).
اتجاه التنمية المستقلة(الذاتية):
التجربة الانسانية تعكس لنا الي أي مدى استطاعت بعض المجتمعات ان تحقق التنمية الشاملة والتطور بإلاعتماد على الذات من خلال توظيف الموارد المحلية بشكل عقلاني راشد وعلمي، والاستفادة باقصى ما يمكن مما لديها من الموارد الطبيعية والبشرية ، وبذلك استطاعت قطع شوط التطور بشكل مستقل عن الخارج – بالطبع الاستقلال هنا لا يعني فك الارتباط نهائيا مع العالم الخارجي،بقدر ما يعني اقامة علاقات علي درجة من التكافؤ،والعدالة - ولنا في المجتمعين الياباني والسوفياتي (سابقا) مثالان لتحقيق التنميةالشاملة بشكل مستقل اعتمادا على الذات ،على الرغم من اختلاف الفلسفة الأجتماعية التي استند إليها كل منهما في تطوره ، فقد نمى الاول نمواً رأسمالياً ، وتبنًي المجتمع الثاني الفلسفة إلاشتراكية خلال نموه([67]). وفي عرضه لوقائع بحوث ومناقشات "الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ،بعنوان: التنمية المستقلة في العالم العربي"، تناول مصطفي العبدالله الكفري، مشاركة الاستاذ "نادر الفراني"، حيث اورد في عرضه :"ويحاول الأستاذ نادر الفرجاني أن يضع تصوراً للتنمية المستقلة في الوطن العربي. ويشير إلى (أن التنمية المستقلة هي عملية تاريخية أكثر منها حالة). لذلك فإن تعريف وتحديد ملامح التنمية المستقلة يتم من خلال منظور طويل الأجل. مع إمكانية تحديد مستوى التطور وحالة التنمية المستقبلة لبلد ما، عند نقطة زمنية محددة. ويضيف الأستاذ الفرجاني (ليست التنمية المستقلة في تقديري سمة توجد أو لا توجد، وإنما يحتمل تصورها أن توجد بدرجات متفاوتة. وعلى هذا لا يصح في نظري، بغض النظر عن مشكلة القياس، القول بأن مجتمع ما قد حقق التنمية المستقلة، بينما لم يتمكن من تحقيقها مجتمع آخر. وإنما المقبول أن نحاول تحديد موقع مجتمع ما على متصل يتراوح بين الصفر والمائة مثلاً، يعبر عن مدى الاستقلال التنموي، ثم يحدد الأستاذ الفرجاني أبعاد التنمية المستقلة وفقاً لما يلي :
1- أهداف التنمية المستقلة هي : تحقيق أعلى درجة من الرفاه المادي والمعنوي لكافة المواطنين مع ضمان تطوره باستمرار.
2- مضمون التنمية المستقلة الأساسي هو : الاعتماد على الذات وبناء القدرات الإنتاجية التي تضمن الوفاء بالحاجات الأساسية للمواطن.
3- ووسيلة التنمية المستقلة في الوطن العربي هي : تنمية القدرات البشرية، وتأطيرها، ومشاركتها الفاعلة في الإنتاج واتخاذ القرار.
4- والوعاء الوحيد الكفيل بتحقيق درجة عالية من التنمية المستقلة في الوطن العربي هي كافة الموارد والإمكانيات التي يملكها الوطن العربي، ووحدته الحضارية، واتساع سوقه "([68]).
والجدير بالذكر هنا، ان العالم العربي يمتلك الموارد الطبيعية والبشرية التي يمكن ان تحقق معجزة تنموية ان صح التعبير، ولكن هناك معوقات ثقافية تحول دون تحقيق ذلك وفقا لدراسة قام بها أ. د. عبد الله عبد الدائم (1989)*، هذا مع الاخذ مع الأخذ في الاعتبار، غياب نظم الحكم الراشد في الدول العربية وهي ايضا قضية ذات بعد ثقافي، وتعريف الكاتب عثمان الجوهري، للتنمية المستقلة يؤكد ما ذهب اليه الباحث حيث انه ذكر:"أن التنمية المستقلة تعنى قدرة البلد على اتخاذ القرار المستقل فى مجال التصرف بموارده الاقتصادية واختيار الأسلوب الأمثل للتنمية"،ثم أرجع أسباب فشل بعض الأنظمة في تحقيق التنمية المستقلة، الي غياب الحكم الراشد، عندما قال: " ولقد أثبتت تجارب الحكم الدكتاتورى فشلها فى تحقيق الإستقلال التنموى على الرغم من أنها تسعى لتحقيقه، إلا أن قمعها للحريات وتسلط الفرد الحاكم تعوق اتخاذ القرارات الهامة؛ مما يشكل أحد أوجه الإهدار فى الموارد الاقتصادية مما قد يدفع لفقدان استقلال الدولة الاقتصادى، ثم أن فك الارتباط بين الدول المتقدمة يعنى اختيار أفضل السبل التى من خلالها يمكن استمرار التعامل مع العالم الخارجى وتلعب الموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة فى البلد دورا هاما فى التأثير على إمكانية هذا الاستقلال التنموى والسياسات المتبعة وتمثل هذه الإمكانيات عاملا موضوعيا ومؤثرا"([69]). وهذا قد يفسًر اسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان بعد انفصال الجنوب في (2011م)، وأعمال الشغب التي عمت بعض المدن، بعد قرار الحكومة القاضي برفع الدعم عن المحروقات، في(22سبتمبر2013م).
ولكن في اتجاه التنمية المستقلة فان الافكار تختلف بالمقارنة مع الاتجاهين "الرأسمالي"* و"الإشتراكي"*[70] في نواح عديدة ، فانصار هذا الاتجاه يرون مثلا ان مستقبل التصنيع والتطور الحضاري والتنمية في العالم الثالث يمكن تحقيقه بغض النظر عن إلايديولوجية التي تحكم المجتمع رأسمالية كانت أم اشتراكية ، والمهم في الامر ان تتم هذه التنمية بإلاعتماد على الموارد المحلية الذاتية وبشكل مستقل عن الدول الغنية ، لذلك فان "تيبورمند Tibormende " يرى انه اذا ما ارادت الدول النامية الخروج من دائرة التبعية للدول الغنية واستعادة الهوية المفقودة واحترام الذات ، فانها ينبغي ان تتبع الخطوات الآتية:
1- تغيير التوجيه السياسي للتنمية الاقتصادية ، فبدلا من تطلعها للخارج فانها يجب ان تتجه إلى الداخل وتهتم بالمشكلات التي يمكن ان تطرأ نتيجة الاتصال بالعالم الصناعي.
2- التخلص من علاقات المساعدة المؤدية إلى الفساد ، وان تنتهي كل الظواهر السلبية كالتبعية وإلأندماج في السوق العالمي وإلاعتماد على رأس المال إلاجنبي وكل التفكير الاقتصادي الذي يؤكد ثبات العلاقات بين الشمال والجنوب.
3- على كل قطر ان يكتشف طريقه إلى التنمية ، اذ ينبغي ان يكون هناك تجريب لاستخدام الطرائق المحلية وإلاعتماد ايضا على المصادر المحلية.
4- ان تمهد التغيرات البنائية الاساس للمشاركة الشعبية في اعمال البناء ، وجهود إلادخار الاكثر والاستثمار الرشيد في الأولويات الضرورية.
5- ان لا يكون هناك تردد في دفع ثمن هذا إلأنعزال.
وايضا يعد (بول باران) رائدا في الدعوة إلى تحقيق التنمية بمفهومها المستقل من خلال تحليل التطور الحاصل في المجتمع الهندي في كتابه "إلاقتصاد السياسي للتنمية" اذ ربطها بالسيطرة على الفائض الاقتصادي واستغلاله افضل استغلال ممكن، ولكن في البداية يجب قطع قنوات استنزافه الخارجية وصولا إلى ربطه بمصلحة الطبقات الأجتماعية المنخفضة الدخل والتي تمثل الغالبية الكبرى من افراد المجتمع ، وأكد وجوب القضاء على إلاستهلاك الترفي المقلد للاستهلاك في الدول الرأسمالية المتقدمة، والذي يعد من ابرز مظاهر التبذير للفائض الاقتصادي، ومن جهة اخرى ركز على العوامل الخارجية في احداث التبعية والتخلف، وحدد معالجاته بقطع اوتار هذه العوامل، واقترح وجوب اتخاذ الطريق والأنموذج اللارأسمالي لتحقيق الاستقلال والتنمية([71]).
ولكن نجد ان الدكتور نصر عارف، في تناوله لقضية التنمية الذاتية، ذهب الى :"إن جوهر الإشكالية يكمن في البنية المعرفية لمفهوم التنمية الذي يتم الحديث عنه، أو ما يمكن أن نطلق عليه "أبستمولوجيا التنمية"، هو تلك المنظومة من المسلمات والمفاهيم والغايات والأهداف المؤطرة برؤية معينة للإنسان والكون والحياة. ولتحليل هذه البنية تحليلاً يتسم بالدقة والأمانة والاستقامة العلمية لا بد من تناول القضايا الأساسية التالية"([72]):
1- حيادية أم معيارية الزمن:إن التعامل مع إشكالية مفهوم الزمن هو في جوهره تعامل مع العمق الفلسفي لإشكالية التنمية. حيث ذكر، ان الناظر في مجمل المنظومة المفاهيمية للتنمية يجد أنها جميعًا تنطلق من اتخاذ الزمن معيارًا محددًا للحركة المجتمعية، ولأبعاد عملية التنمية ومستوياتها وغاياتها وأهدافها القصيرة والبعيدة. فمفاهيم التقدم والتخلف، الحداثة والتقليدية، المعاصرة والرجعية... إلخ. جميعًا تستبطن دلالة معينة لمفهوم الزمن، هذه الدلالة توضح بجلاء أن حركة الزمن للأمام دائمًا هي حركة إيجابية، وأن الأحدث دائمًا هو الأفضل وأن الأقدم دائمًا هو.. الأسوأ، وكأن المجتمعات البشرية على مر تاريخها لم تشهد سوى التقدم المطرد وأن انهيار الحضارات شيء لم يحدث أو أنه كان حركة تقدمية وتغير نحو الأحسن بدوره، وليس مؤشر على فشل ما في التعامل مع الواقع، وانتهي الي ان كل تلك فرضيات لا تقوم على حقيقة واقعية أو دلائل موضوعية، وإنما تنهض في أساسها على مسلمة فلسفية ترى بمعيارية الزمن على إطلاقه، أي معيارية الحركة التاريخية الكلية للعالم.
2- مفهوما الثقافة والتحضر: قد يجد البعض أنه ليس من الضروري استدعاء مفهومي الثقافة والحضارة (أو بالأحرى "التحضر" بالمعنى القيمي) عند تحديد ماهية التنمية المستقلة، وواقع الأمر أن لهذين المفهومين أوثق العلاقة وأكثرها مباشرة بمفهوم التنمية المستقلة، وذلك أن رواد نظرية التنمية تعاملوا في كتاباتهم مع "إشكالية التنمية على أنها ظاهرة ثقافية، بل تداعوا من أجل تحقيق التنمية انطلاقًا مما أطلقوا عليه "الثقافة المدنية"، حيث اعتبروا أن وجود هذه الثقافة شرط ضروري لتحقق عملية التنمية برمتها. ومن ناحية أخرى فإن الحضارة سواء في سياقنا هذا أم في أدبيات التنمية عمومًا هي الإطار الذي يؤطر عملية التنمية، وهي الهدف الذي تسعى التنمية لتحقيقه، فما لم يكن هدفها صياغة نموذج حضاري أو اللحاق بالركب الحضاري، أو التحضر، أو اكتساب بعض صفات الحضارة فماذا يكون؟.
اي نموزج، يؤكد وجود المجتمع ككيان في حقبته التاريخية، يكون الشاهد فيها إرثه المادي والمعنوي.
وجوده ويرى "نصر" انه يمكن تحديد الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المستقلة في العناصر التالية:
تحديد نموذج التنمية المنشود ووجهة المجتمع : لكل مجتمع بشري وجهة هو موليها، هذه الوجهة هي بؤرة تستقطب طاقاته وجهوده وتستلهم روحه وتدفع إبداعاته وتفجرها، وكثيراً ما تتمظهر هذه الوجهة في صورة مشروع قومي، أو مشروع حضاري. هذه الأفكار هي تجسيد واقعي لروح مطلقة هي وجهة المجتمع.وهذه الوجهة ينبقي ان تنبثق من الواقع، لا ان تستلهم من ما انتهي اليه الاخرين.
إعادة التوازن بين الدولة والمجتمع.. متوالية الاستقلالية:
إذا كانت فكرة الاستقلالية في التنمية تقوم على تحقيق استقلال الدولة والمجتمع عن الدول والمجتمعات الأخرى، فإن هذه الفكرة أيضاً لا تتحقق إلا بتحقيق متوالية من الاستقلالية. وحيث إن مفهوم الاستقلالية لا يعني انقطاع العلاقة أو إنهائها، وإنما يعني في جوهره توازن هذه العلاقة؛ لأنها تقوم بين أطراف مستقلة تدخل في علاقة طوعية، وتستمر فيها بمحض إرادتها. فإن جوهر مفهوم الاستقلالية هو التوازن. ومن هنا فإن الحديث عن متوالية الاستقلالية يعني ابتداء تحقيق توازن طوعي أو إرادي بين الدولة والمجتمع من ناحية والدول والمجتمعات الأخرى من ناحية أخرى. وهذه مرحلة من مراحل تحقيق التنمية المستقلة؛ إذ تتلوه مراحل أخرى لعل أهمها تحقيق الاستقلالية أو التوازن في علاقة الدولة بالمجتمع بحيث لا يحدث تغول وتسلط الدولة على المجتمع وتقوم بإفلاسه وإحصاء قواه لصالح تضخيم قوتها وتعظيم سيطرتها.
الاستقلالية في تحديد الحاجات.. استقلالية الذوق الاستهلاكي:
خلق النموذج الغربي ما سُمِّي ثورة التوقعات، فالأحلام تم تصميمها على النمط الغربي، والتنمية هي تحديد الحاجات، وتحديد الاحتياجات يجب ان لايكون معياره النمط الغربي، بل يجب ان يكوان علي درجة عالية من الواقعية والموضوعية ، التي تحقق التوازن ما بين الموارد المتاحة واحتياجات المجتمع.
الاستقلالية في توظيف الموارد والإمكانات..
استقلالية الإنتاج:
التنمية المستقلة ليست مرادفاً للانغلاق والتقوقع على الذات، كما قال نصر، بل على العكس هي حالة من الفعالية والتفاعل من موقع الفعل لا الانفعال، و الاستقلالية في توظيف الموارد والإمكانيات هي بداية تحقيق الاستقلال الحقيقي بالخروج من الاستعمار الهيكلي الذي فرض على مجتمعات العالم الثالث خلال القرون الثلاثة الأخيرة.
الخطوة الثانية هي إعادة اكتشاف الموارد الوطنية التي لم يتم التركيز إلا على ما يحتاجه الاستعمار منها. فالدول التي صنفت على أنها دول نفطية لديها من الموارد الأخرى ما يجعل إنسانها فاعلاً قادراً، وليس إنسانًا ريعياً مستهلكاً. ([73])
ولقد تناول الباحث اراء، د.نصر عارف باسهاب لانها تمثل في كثير من تفاصيلها جوهر عنوان البحث، وهذا بالاضافة الي انها اجابت علي الكثير من الاسئلة المثارة، حول اسباب فشل التنمية الذاتية في ثير من الدول التي حاولت النهوض انطلاقا من الذات، كما انها تشكل مفتاح للتحليل الموضوعي للكوابح الثقافية للتنمية (ونقصد بها هنا، المنطلقات الفكرية للنخب الحاكمة في الدول النامية، التي بناءا عليها تتخذ من استراتيجيات الكبت والقهر والقاء الحريات سبيلاً للمحافظة علي السلطة. دون السعي للوصول الي رضي المواطن عبربوابة التنمية الاجماعية، والتي وصفت بانها تعني في بعدها "الشامل الحرية" *.
التغير الإجتماعي: المفهوم والتوجهات النظرية:-
التغير جزء لا يتجزأ من طبيعة الكون الذي نعيش فيه ، ولهذا يقولون أن التغير هو الحقيقة الوحيدة الثابتة التي "لا تتغير"... والتغير يطرأ على كل أشكال الوجود الجامد والحي ، الطبيعي (الفيزيقي) والإنساني، والمتأمل لتاريخ البشرية يدرك مدى التغير الكبير الذي طرأ على الإنسان وعلى النظم الاجتماعية التي ابتكرها لتيسير حياته.ومن البديهي أن التغير الاجتماعي Social Change يؤدى إلى تغير الظروف والأوضاع التي أقيمت النظم الاجتماعية لإشباع الحاجات في ظلها ...
ذكر "نعيم": أن "علماء الاجتماع والايدو لوجيا عرفوا التغيير الاجتماعي بانة تغير في بناء ووظيفة النسق الاجتماعي بما يشملان من مكانات وادوار اجتماعية"([74])، ومنهم من يضيف النظم الاجتماعية او البناء الاجتماعي او انماط الفعل والتفاعلات في المجتمع دون الوظيفة . اما "فرو جرز" راى بان التغير الاجتماعي يشير الى العملية التي يتم من خلالها تعديلات في بناء ووظيفة النسق الاجتماعي . ويتكون البناء من مختلف الجماعات والافراد الذين يشكلون هذا البناء، والعنصر الوظيفي ضمن البناء هو الدور او سلوك الفرد في مكانة معينة، وعليه؛ التغيير لدى روجرز عملية وليس حالة وطالما هي عملية فليس لها بداية او انها نهاية وهو مستمر عبر الزمن وقد اتفق علماء اخرون مع روجرز في اعتبار النسق الاجتماعي موضوعا للتغيير الاجتماعي ومنهم (ميريل و بارسونز باربر والن وكوزر وماير ) ([75]). إلا ان الاستاذ راحل حجيلة له راي آخر: اذ يرى ان الكثير من الكتابات السوسيولوجية الحديثة تكاد تجمع علي ان علماء الاجتماع يفتقدون نظرية شاملة متكاملة في التغير الاجتماعي، بل ويذهب الي ان العلماء لا يعانون من قلة النظريات المفسرة للتغير الاجتماعي، بقدر ما يعانون من كثرتها وتعددها، وان اخطر المشكلات التي تواجه الدراس للتغير الاجتماعي بوجه عام، هي تلك التي المشكلة التي تنشأ حين تحقق في تحديد وحدة التغير،اي الجنس البشري باكمله، ام مجتمع بعينه، ام نظامي اجتماعي محدد، ام مجموعة من العلاقات الاجتماعية، ويضيف ان علينا بعد ذلك تحديد العناصر التي تتغير، وايضا المشكلات التي تنشأ عند محاولة قياس معدل التغير وتحديد اتجاهه، وينتهي الي ان موضوع التغير الاجتماعي يعتبر ظاهرة معقدة، والتعقيد لا يحيل عن الغموض بل علي الطابع المركب لعناصر الظاهرة، لأن كل ظاهرة هي مركبة وعلي العالم ان تحليلها وعرضها كبنية من العناصر البسيطة([76]). اما الدكتور عزت، يفرق ما بين مفهوم التغير والتغيير، ويكتب:" نحن إذاً أمام فكرتين أَو اصطلاحين وهما التغير والتغيير وفرق كبير بيَنهما،وإن كانا مرتهنين لأصلٍ لغو ي واحد،ولكن هذا الاختلاف اختلاف في الجهة والتعلق والآلية وليس في المادة لأن المادة واحدة وهي الأصل اللغوي الواحد. وإذا كان التغير آلية مجتمعية تلقائية والتغيير فاعلية بشرية إرادية، وإذا كان علم التغير حديثاً فإ ن علم التغيير ما زال غضاَ ربما لم تكتمل ولادته بعد، ومجالات تطبيقه خصبة، والآفاق أمامه مفتوحة، والإمكانات المتاحة أمامه هائلة([77]).وسأعرض تعريفاً توفيقياً بين وجهات النظر المختلفة وهو: أن التغير الاجتماعي ظاهرة تلقائية عامة ومستمرة تحدث تدريجياً وتصيب البناء الاجتماعي للمجتمع - القيم، والثقافة-. ومن هنا يتضح أن التغير الاجتماعي يتصف بالتالي:
أنه ظاهرة تلقائية ، أي لاإرادية.
أنه ظاهرة عامة، أي تصيب جميع المجتمعات على وجه الأرض.
أنه ظاهرة مستمرة، أي لا تتوقف.
أنه ظاهرة تحدث تدريجياً، أي بطريقة غير ملحوظة، ولذلك ينتج عنها عنصر المفاجأة.
أنه ظاهرة تصيب البناء الاجتماعي ، أي القيم والثقافة السائدة في المجتمع.
وغالباً يكون للتغير الاجتماعي آثاراً مترتبة عليه، قد تكون سلبية، وقد تكون إيجابية، وقد تكون الاثنان معاً، ومن ثم يصاب المجتمع بحالة من عدم الاتزان، فتحدث القماومة لذلك التغير سواءً كان إيجابياً أو سلبياً. وهناك أسباب تؤدي الي مقاومة التغير، اهمها: أن التغير يتضارب مع القيم والثقافة التي سادت المجتمع لعقود طويلة. ولذا تحدث المقاومة لأن الأفراد غير مهيئين لتقبل الجديد، فبتالي لابد من التغيير ، وهنا يصبح لدينا مصطلحاً آخر وهو التغيير . وبالتالي فهناك فرق بين التغير والتغيير.
فالتغير كما قلنا سابقاً ظاهرة تلقائية لاإرادية، أما التغيير فهو عملية مقصودة الهدف منها أمرين رئيسيين هما:
الامر الاول او الوظيفة الاولي: تهيئة الأفراد وإقناعهم بتقبل الجانب الإيجابي، وذلك من خلال توضيح الفوائد والمنافع التي ستعود عليهم من الأمر الجديد . ولا نتوقع أن هذه التهيئة تحدث في يوم وليلة. وخير مثال لذك الآلية التي اتبعها الشًارع في تحريم الخمر في عهد الرسول(ص).*
الأمر الثاني أو الوظيفة الثانية: علاج المشكلات المترتبة على التغير ، والتي تمثل الجانب السلبي([78]).
ومن ثم يمكننا الخروج بخلاصة مفادها أن كل تغير لابد أن يتبعه تغيير، سواء كان ذلك التغير إيجابياً أم سلبياً، أنه متى وجد التغير لابد من التغيير، حتى ولو كان التغير إيجابيا، حيث يتطلب الأمر تهيئة الناس لاستقبال الجديد الذي أتى به التغير، للتقليل من الفجوة الثقافية التي يمكن ان تنشأ، وعليه يرى الباحث ان التنمية الاجتماعية ذات ربط عضوي مع التغيير الاجتماعي، لتتطابق الخصائص والاليات والوظائف التي يتمتازان بهم.
وبالله التوفيق
المصادر
________________________________________
[1] - المعجم الوسيط
[2] - البقرة آية 191
[3] - سورة الممتحنة آية رقم 2، http://quran.v22v.net/tafseer-5152-60.html
[4] - سورة آل عمران 112
[5] - سورة الأنفال 57
[6] - http://islam.sudanforums.net/t4-topic
[7] - القاموس المحيط للفيروز أبادي
[8] - قاموس لسان العرب لابن منظور
[9] - الدكتور خليل الحدري ( مفهوم الثقافة ) ، ورقة علمية، جامعة ام القري
[10] - ويكيبيديا الموسوعة الحرة
[11] - أ.د. كمال محمد جاه الله الخضر (مكونات الثقافة في السودان، هل من دور في أزماته؟) مجلة قراءات افريقية العدد الثالث عشر رجب - رمضان 1433هـ ، يوليو - سبتمبر 2012،الرباط ص1
[12] - أ.د. كمال محمد جاه الله الخضر مصدر سابق،ص1
* تعود جذور الكلمة الإنجليزية إلى اللفظ اللاتيني "Culture" ويعني حرث الأرض وزراعتها، وقد ظلت اللفظة مقترنة بهذا المعنى طوال العصرين اليوناني والروماني. وفي فترة لاحقة، استخدمها المفكر اليوناني "شيشرون" مجازًا بالدلالات نفسها، حين أطلق على الفلسفة "Mentis Culture" أي زراعة العقل وتنميته، مؤكدًا أن دور الفلسفة هو تنشئة الناس على تكريم الآلهة. وفي عام 1871م، قدم إدوارد تيلور تعريفًا لهذا المفهوم في كتابه "Primitive culture"، حيث اعتبره "ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بصفته عضوًا في مجتمع".وبانتقال مفهوم "Culture" إلى "Kultur" الألماني اكتسبت الكلمة مضمونًا جماعيًا، فقد أصبحت تدل على التقدم الفكري الذي يحصل عليه الفرد أو المجموعات أو الإنسانية بصفة عامة. بناءً على ذلك، عالج المفكرون الألمان العلاقة بين علوم الـ "Culture" والعلوم الطبيعية.من ناحية أخرى اتجه المفكرون الإنجليز إلى النظر في التطبيقات العملية لمفهوم Culture في المسائل السياسية والدينية، لذلك عرّفها كلايد كلوكهون بأنها: مجموعة طرائق الحياة لدى شعب معيّن في الميراث الاجتماعي التي يحصل عليها الفرد من مجموعته التي يعيش فيها.
[13] - مصدر سابق
[14] - محمد عابد الجابري(مفهوم الثقافة وقاموس الخطاب العربي)،مقال http://chajaraa.blogspot.com/2011/12/blog-post_9509.html
[15] - مصدر سابق ص1
* ادوارد برنت تايلور (1832-1917)عالم إنسان بريطاني أصبح أستاذاً لعلم الإنسان في جامعة أكسفورد منذ عام 1896 وظل بها حتى تقاعده في عام 1913. أسهم إسهاماً كبيراً في دراسة الثقافة وكان أحد رواد الاتجاه التطوري، وقال بالنظرية البيولوجية، وأسهم في تطوير الدراسات المقارنة للأديان.
يرى تايلور أن الثقافة تطورت من الشكل غير المعقد إلى الأشكال المعقدة مبدياً اتفاقه مع مورغان بشأن مراحل التتابع الثقافي من الوحشية إلى البربرية فالمدنية. وكان كتابه "أبحاث في التاريخ المبكر للبشرية وتطور المدنية" في عام 1869 والذي أعقبه كتابه"المجتمع البدائي" في عام 1871 قد انطلقا من وجهة نظر تطورية واهم كتبه "الثقافة البدائية".. http://hamdisocio.blogspot.com/2012/12/1832-1917.html
[16] - مصدر سابق ص1
[17] - مصدر سابق ص1
[18] - مصدر سابق ص1
* توماس هوبز Thomas Hobbes (5 أبريل 1588 – 4ديسمبر1679 )كان عالم رياضيات وفيلسوف إنجليزي،ويعد توماس هوبز أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر بإنجلترا وأكثرهم شهرة خصوصا في المجال القانوني حيث كان بالإضافة إلى اشتغاله بالفلسفة والأخلاق والتاريخ، فقيها قانونيا ساهم بشكل كبير في بلورة كثير من الأطروحات التي تميز بها هذا القرن على المستوى السياسي والحقوقي.كما عرف بمساهمته في التأسيس لكثير من المفاهيم التي لعبت دورا كبيرا ليس فقط على مستوى النظرية السياسية بل كذلك على مستوى الفعل والتطبيق في كثير من البلدان وعلى رأسها مفهوم العقد الاجتماعي . كذلك يعتبر هوبز من الفلاسفة الذين وظفوا مفهوم الحق الطبيعي في تفسيرهم لكثير من القضايا المطروحة في عصرهم ، واشتهر بأعماله في الفلسفة السياسية. ولقد وضع كتابه الصادر عام 1651 تحت اسم "لوياثان" الأساس لمعظم الفلسفة السياسية الغربية من منظور نظرية العقد الاجتماعي.
* جان جاك روسو (28 يونيو 1712، جنيف - 2 يوليو 1778، إيرمينونفيل) هو كاتب وفيلسوف جنيفي، يعد من أهم كتاب عصر العقل، وهي فترة من التاريخ الأوروبي، امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين. ساعدت فلسفة روسو في تشكيل الأحداث السياسية، التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية. حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب والسياسة.
[19] - مصدر سابق ص1
* لويس هنري مورغان (1818-1881) محام وعالم إنسان أمريكي اهتم في بداية حياته بدراسة أمريند الايروكيز وغيرهم من سكان الشمال الشرقي الأمريكي الأصليين. حاول مورغان إعادة تركيب صورة المجتمعات الإنسانية وتصنيفها بغية التعرف على تاريخ المجتمع الأوروبي والمراحل التي مرَّ بها وصولاً إلى ما هو عليه في عصره. وقد تأثر مورغان بكتاب باخوفن "حق الأم" وبأبحاث لافيتو.
وافترض مورغان عدداً من المراحل التطورية الاجتماعية ، وربط كل مرحلة من تلك المراحل بنمط معين طبقاً لمراحل التطور الثقافي، أي أن كل مرحلة تميزها علاقات ثقافية تتمظهر في أشكال من النظم بحيث تتوافق مع المراحل الفرعية. وافترض مورغان أن جميع المجتمعات الإنسانية تخضع في تطورها لقانون واحد طالما أن تاريخ الجنس البشري واحد "وحدة أصل الإنسانية وتوحد الحاجات الإنسانية على الدرجة نفسها من التطور وذلك حين تكون العلاقات الاجتماعية على الدرجة نفسها من المساواة".هكذا يرى مورغان أن الثقافة الإنسانية انتهجت في تطورها مساراً أُحادياً، أي أنها تنتقل عبر التاريخ وفق سلسلة متتابعة الحلقات، بمعنى وجود مراحل محددة وحتمية لا بدَّ أن تمر بها كل ثقافة من الحالات الدنيا إلى الحالات الراقية فالأكثر رقياً. وافترض مورغان وسعى إلى إيجاد علاقة عنصرين كبيرين في مرحلة ما قبل التاريخ هما: مرحلة التوحش ومرحلة البربرية وقسم كل مرحلة منها إلى مراحل فرعية دنيا ووسطي وعليا قبل الوصول إلى مرحلة المدنية. وبذلك استعاد التاريخ البدائي تلاحماً شاملاً وعمقاً... د. أسامة عبدالرحمن النور ود. أبوبكر يوسف شلابي"الانثروبولوجيا الاجتماعية 2"أركماني" مجلة الاثار والانثروبولوجيا السودانية .. http://arkamani.net/ar/index.php/2013-
[20] - الأستاذ الدكتور / سعيد إبراهيم عبد الواحد "مفهوم الثقافة"http://www.arabworldbooks.com/Articles/articles50.htm،مقال
* في كتابه "أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة" الطبعة الأولى عام 1884ابدي فريدريك أنجلز، ما اسماه بالملاحظات الانتقادية لآراء مورغان جاء فيها: "حسب المفهوم المادي، يشكل إنتاج و تجديد إنتاج الحياة المباشرة، في آخر تحليل، العامل الحاسم في التاريخ. و لكنه هو ذاته، مع ذلك، ذو طبيعة مزدوجة، فمن جهة، إنتاج وسائل الحياة: سلع التغذية، الألبسة، المسكن، و الأدوات الضرورية لهذا، و من جهة ثانية، إنتاج الإنسان نفسه، مواصلة النوع. و إن النظم الاجتماعية التي يعيش في ظلها أهل عهد تاريخي معين و بلد معين يشترطها مظهراً الإنتاج: درجة تطور العمل من جهة، و درجة تطور العائلة من جهة ثانية. فبقد ما يكون العمل أقل تطوراً و كمية منتوجاته، و بالتالي ثروة المجتمع، أضيق حدوداً، بقدر ما تتجلى تبعية النظام الاجتماعي للعلاقات العشائرية بمزيد من القوة. هذا مع العلم أن إنتاجية العمل تتطور أكثر فأكثر على الدوام في نطاق بنية المجتمع هذه، والقائمة على علاقات العشائرية، و معها تتطور الملكية الخاصة، و التبادل، و الفوارق في الممتلكات، و إمكانية الاستفادة من قوة عمل الغير، و يتطور بالتالي أساس التناقضات الطبقية: العناصر الاجتماعية الجديدة التي تحاول على مر الأجيال أن تكيف النظام الاجتماعي القديم للظروف الجديدة إلى أن يؤدي، في آخر الأمر، التنافر بين القديم و الجديد، إلى انقلاب تام" ...ص3 ayman1970.files.wordpress.com/.../d8a3d8b5d984-d8a7d984d8b9d8a7d8apdf
[21] - مصدر سابق ص1
[22] - د.الطاهر حاج النور احمد (المداخل التقليدية لفض الزاعات في افريقيا- مناقشة - ،سايكلوجية ما بعد الحرب وأهمية الادارة الاهلية )، محاضرة، قاعة المؤتمرات جامعة زالنجي ،2013م
[23] - سلوان داود"معني الثقافة"مقال http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=345978.0
[24] - د.الطاهر حاج النور مصدر سابق
* في عام 1989 قرأ العالم في مجلة ناشنال انترست National Interest مقالة بدلت تاريخ النظريات السياسية الحديثة، عندما نشر فرانسيس فوكوياما مقاله "نهاية التاريخ)" قائلا إن نهاية تاريخ الاضهاد والنظم الشمولية قد ولى الى الابد دون رجعة مع انتهاء الحرب الباردة وهدم سور برلين، لتحل محله الليبرالية وقيم الديموقراطية الغربية. وما لبث ان شرح فوكوياما نظريته المثيرة للجدل بعدئذ متمما في كتاب صدر عام 1992 وهو(نهاية التاريخ والإنسان الأخير). وقد عارض فوكوياما فكرة نهاية التاريخ في نظرية كارل ماركس الشهيرة (المادية التاريخية)، والتي اعتبر فيها أن نهاية تاريخ الاضهاد الانساني سينتهي عندما تزول الفروق بين الطبقات. والواقع ان فوكوياما تأثر في بناء نظريته بأراء الفيلسوف الشهير (هيغل) واستاذه الفيلسوف (آلن بلوم)، حيث ربط كلاهما بين نهاية تاريخ الاضهاد الانساني واستقرار نظام السوق الحرة في الديمقراطيات الغربية.
* *الحرب الباردة:مصطلح اطلق علي التنافس في مجال العلوم والتكنولوجياوسباق التسلح والسيطرة علي الموارد، الذي كان بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي، بعد الحرب العالمية الثانية، والذي نشطت فيه والاجهزة الاستخبارية والمعلوماتية بين البلدين، وانتهي بسقوط الاتحاد السوفيتي عام (1990م).والذي في جوهره كان صراعا بين النظام الاشتراكي(بقيادة،الاتحاد السوفيتي،اوروبا الشرقية) والنظام الراسمالي(بقيادة الولايات التحدة الامريكية واوروبا الغربية).
* **اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية دولة دستورية شيوعية سابقة شملت حدودها أغلب مساحة منطقة أوراسيا في الفترة ما بين عامي 1922 وحتى 1991. ولد الاتحاد السوفيتي من رحم الإمبراطورية الروسية التي أصابها الضعف والوهن مما حل بها من أحداث سياسية مثل الثورة الروسية التي قامت عام 1917 وتحولت فيما بعد إلى الحرب الأهلية الروسية والتي دامت أربعة أعوام كاملة فيما بين 1918 وحتى 1921.
[25] -د. امال فرفار،(واقع ثقافة التواصل في ظل تحولات المجتمع الدولي المعاصر - جدلية ثقافة المركز والهامش)، جامعة تبسة – الجزائر pdfص3
[26] -د. مصطفى صالح باجو(هل العولمة قدر محتوم؟ ،شبكة المعرفة الأحد, 12 يوليو 2009 http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id =
* الأ نثروبولوجيا الناقد" Critical Anthropology" فرع من فروع المعارف البينية، يهتم بتجميع التحليلات الخاصة بالنمط الثقافي لحياة شعب معين، وتستقصي من خلال هذه التحليلات تأثيرات النظام السياسي والاقتصادي، وأنساق الضبط والتحكم التي تمارسها سلطات الدولة القومية National ، وكذلك التأثيرات التي يفرضها النظام العالمي على الشعب في الدولة المعنية. وتمثل الاستقصاءات والتحليلات حصيلة خبرات واهتمامات وبحوث أنثروبولوجية نقدية موجهة – في الأغلب – بمبادئ وفلسفة "الماركسية الجديدة" وبمبادئ النقد الأدبي الحديث، وبفلسفة وأنثروبولوجية ما بعد البنيوية Meta-structuralism.
[27] - د . نصر عارف -أستاذ مشارك-جامعة جورج تاون-مقال (الثقافة مفهوم ذاتي متجدد) http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/takafah.htm
[28] - انظر، سامح عسكر(تعريف الثقافة في اللغة العربية)، مقال 323-topic http://azhar.forumegypt.net/t
[29] - أ.د. حسن مكي محمد أحمد (الواقع الثقافي في السودان)، دراسات افريقية،(النسخة الألكترونية) ص10
[30] -داود سلمان الكعبي (مفهوم الثقافة) مقال الحوار المتمدن-العدد: 2755 - 2009 / 8 / 31
[31] - د . نصر عارف مصدر سابق، ص1
[32] - الأستاذ الدكتور / سعيد إبراهيم عبد الواحد "مفهوم الثقافة"http://www.arabworldbooks.com/Articles/articles50.htm،مقال
[33] - ب.محمد حمدان،(ثقافة المجتمع آليات نموها ضمينها للمدرسة والمنهج)، دارالتربية الحديثة، 1983،http://www.hamdaneducation.com/arabic/articles
[34] - ب.محمد حمدان،مصدر سابق
[35] - الأستاذ الدكتور / سعيد إبراهيم عبد الواحد مصدر سابق
رالف لنتون (فيلادلفيا 27 فبراير 1893 - نيو هيفن، كونيتيكت 24 ديسمبر 1953) كان مواطن أمريكي قدير وعالم في مجال الأنثروبولوجيا في منتصف القرن العشرين، عرف رالف خصيصا لكتاباته The Study of Man (1936) وThe Tree of Culture (1955). من المساهمات الكبيرة التي ساهم بها رالف في علم الأنثروبلوجيا كان تعريف التميز بين الحالة والدور، درس الأنتربولوجيا في جامعة كولومبيا ثم في يال ،و قد قام بدراسات أنتربولوجية في جزر المركيز و في مدغشقر.... الموسوعة الحرة...
[36] - الأستاذ الدكتور / سعيد إبراهيم عبد الواحد مصدر سابق
[37] - ¬ ¬ د.طارق عبد الرؤوف عامر،(الثقافة ..مفهومها،عناصرها ومحتوياتها)، مقال،أفاق علمية وتربوية، htt//al3loom.com/?p=459
جاء في الحديث، قال(ص) "ما من مولود الا ويولد علي الفطرة ، فابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه..."
[38] - ¬ ¬ د. عزيزة المانع،(وظيفة الثقافة)،مجلة عكاظ،( الإثنين 27/04/1428هـ ) 14/ مايو/2007 العدد : 2157http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/.htm
[39] - موسوعة مقاتل من الصحراء ¬ - http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/Culture/sec01.doc_cvt.htm
[40] - موسوعة مقاتل من الصحراء مصدر سابق
[41] - الموسوعةالحرة http://arz.wikipedia.org/wiki/%D
[42] - اركماني(مجلة الأنثروبولوجيا السودانية- العدد الثاني) http://arkamani.net/ar/index.php/
[43] - ب.حسن مكي مصدر سابق ص13
[44] - الأستاذ الدكتور / سعيد إبراهيم عبد الواحد مصدر سابق
* نظرية الاختلاط التفاضلي أو الارتباط المتغاير تشكل تطويراً منهجياً آخر لشرح كيفية انتقال السلوك الإجرامي بطرق التعلم من الآخرين أو من خلال الاختلاط بالمجرمين وتعلم الأنماط الإجرامية والبواعث والمبررات التي تشجع على ارتكاب الجريمة من خلال علاقات شخصية وثيقة وحميمة وقد ظهرت أولى فرضيات هذه النظرية في كتاب مبادئ علم الإجرام للأستاذ الأمريكي "سذرلاند" منذ عام.
[45] - نورة الحمدي (قراءة نقدية في نظريتي انتقال الثقافة الفرعية والارتباط المتمايز من كتاب الجريمة والقانون والمجتمع ص 113 ــ 131) ، اجتماعي، فيراير2011م 33640http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=
[46] - عامر بن محمد بن عامر العيسري (أثر التغيرات الاجتماعية والثقافية على المناهج الدراسية) ورقة عمل مقدمة للقاء التربوي الرابع مسقط 4 / 2004م
* عالم الاجتماع الأمريكي "وليم اوجبُرن" William Ogburn (29يناير1886- 27 ابريل 1959)،ولد في بتلر بولاية جورجيا،كان خبيرا احصائيا واكاديميا، حصل علي درجة الليسانس في جامعة لينسر والماجستير والدكتوراه من جامعة كولمبيا، وهو اول من طرح.مصطلح.." الهوة ثقافية" Cultural Lag في كتابه "التغير الاجتماعي.
[47] - د.الطاهرعبدالله احمد،(مناقشة موضوع السلام الاجتماعي والتنمية الاجتماعية)،جامعة زالنجي ،مارس2013م
[48] - ابن منظور، لسان العرب، ج: 6، ص: 724
[49] - المعجم الوسيط ج:2، ص:956.
[50] - الفروق في اللغة، أبو هلال العسكري، ص: 95. الكليات، أبو البقاء الكفوي، ص: 353
[51] - معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيد حماد، ص: 278
[52] - ابن منظورمصدر سابق ص725
[53] - د.ثروت محمد شلبي(التنمية الاجتماعية)،جامعة بنها،برنامج الدراسة المفتوحة، ص14
[54] - د.عبد الرازق الهيتي،(التنمية الاجتماعية Social Development مع بعض المفاهيم القريبة)،مقال،اجتماعي،26/5/2008م http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=8270
[55] - د.الطاهرعبدالله احمد،(مناقشة موضوع السلام الاجتماعي والتنمية الاجتماعية)،جامعة زالنجي ،مارس2013م
[56] - د.عبد الرازق الهيتي،مصدر سابق
[57] - د. يوسف مكي،( تـطـــور مفـهــوم التنـمـيـــــة)،مقال، جريدة المؤتمر31-7-2008م، http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=200814946
[58] - د.ادم احمد(مناقشة موضوع النوع والفقر والتنمية)، جامعة زالنجي، ابريل 2013م
* الدراسة في كلية القديس يوحنا بجامعة أوكسفورد (1954- 1957م): امتحن الصادق المهدي لكلية القديس يوحنا عام 1953م وقبل لدراسة الزراعة ولكنه لم يدرسها، بل ذهب لأكسفورد في عام 1954م وقرر دراسة الأقتصاد،والسياسة، والفلسفة، في أكسفورد على أن يدرس الزراعة بعد ذلك في كاليفورنيا.وفق في نيل شهادة جامعية بدرجة الشرف في الاقتصاد والسياسة والفلسفة، ونال تلقائيا درجة الماجستير بعد عامين من تاريخ تخرجه، حسب النظام المعمول به في جامعة أكسفورد.
* * درس الترابي الحقوق في جامعة الخرطوم منذ عام 1951 حتى 1955، وحصل على الماجستير من جامعة أكسفورد عام 1957، دكتوراة الدولة من جامعة سوربون، باريس عام 1964. يتقن الترابي أربع لغات بفصاحةوهي العربية،والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية.
* ** ولد"كوامي نكروما" عام 1909، تخرج بدار المعلمين في أكرا، وعمل أستاذا إلى أن التحق عام 1935 بجامعة لنكولن في الولايات المتحدة وفي عام 1945 بمدرسة الاقتصاد في لندن ببريطانيا، وكان قد نشط في العمل الطلابي فترة وجوده في أميركاوبريطانيا.
[59] - د.منصور خالد،(النخب السودانية وإدمان الفشل)، ج الاول ،1993، ، ص18
* االاقتصادي و. و. روستو W. W. Rostow والذي يعد من ابرز دعاة هذا الاتجاه ، فيرى في كتابه الموسوم "مراحل النمو الاقتصادي" بان المجتمعات كافة تقع ضمن احدى المراحل الخمس: المجتمع التقليدي، ومرحلة التمهيد للأنطلاق، ومرحلة إلأنطلاق، ومرحلة السير نحو النضج، واخيرا مرحلة إلاستهلاك الجماعي العالي المستوى ، وقد اشتق هذه المراحل الخمس من تحليله للثورة الصناعية في بريطانيا وهو يرى ان مرحلة إلأنطلاق هي بمثابة الحد الفاصل في حياة المجتمعات الحديثة عندما تزول العوائق من طريق النمو الاقتصادي لا سيما مع توسع القوى الفاعلة من اجل التقدم الاقتصادي التي تسيطر على المجتمع بأسره ، وفي هذه المرحلة ترتفع نسبة الاستثمار الفعال وإلادخار إلى 10% من الدخل القومي السنوي او اكثر من ذلك ، وتتوسع الصناعات الجديدة بسرعة وتدر ارباحا كبيرة ويعاد توظيف نسبة كبيرة من ارباحها في مشاريع جديدة .
[60] - احمد السيد كردي، (الاتجاهان النظرية في التنمية الاجتماعية) http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/140355
[61] - د.ادم احمد(مناقشة موضوع النوع والفقر والتنمية)، جامعة زالنجي، ابريل 2013م
[62] - غازي الصواراني، (في تعريف التبعية وخطرها علي الشعوب العربية)، صحيفة عدسة اليمن الالكترونية،
http://adsah-y.com/?p=