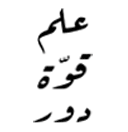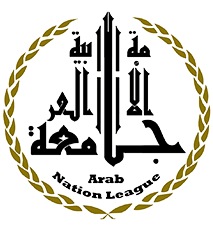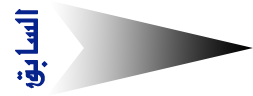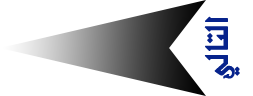تبدو الكتابة عن حرب حزيران، في ذكراها الخمسين، محفوفة بالمخاطر والمحاذير التي قد لا يكون أولها التساؤل الاستنكاري، قل الاستخفافي عن جدوى استحضارها في معمعان التطورات العاصفة للحرب على سورية وعلى غير دولة من الدول العربية، وهو تساؤل يخفي أو يتجاهل صلة، قد تبدو للبعض مثل الظل الأبكم في رواية الياس خوري، ظل يعكس شيئاً موجوداً لكنه غير ملموس وهي صلة تجعلنا نعتقد بأن ما يجري الآن وهنا لا يعدو أن يكون النسخة المعدلة والمزيدة من حيث الوسائل، والموحدة من حيث الأهداف، لما جرى في 5حزيران.
من المخاطر أو المحاذير تلك المتعلقة بالسؤال عن ما يمكن أن تضيفه الكتابة عن حرب حزيران، وقد سال حبر كثير في "الخمسون" المنصرمات حولها بحثاً وتحليلاً، هجوماً أو دفاعاً، نقداً أو تبريراً. فضلاً عن ما قد يستجلبه نمط الكتابة في أي من هذه المواقع من تهمة "الخشبية" التي قد يرميه بها الموقع المضاد.
مع ذلك، فإن هذه الحرب، أو النكسة أو الهزيمة أو النكبة وكل تسمية هنا لها دلالاتها وحمولتها الأيديولوجية التي أريد منها ولها أن تحفر عميقاً في ذهن المتلقي، مازالت تثير شهوة الكتابة عنها، حيث المغريات قارّة في عمق الحدث، ومن الصعب مقاومتها.
إلا أن المفارقة أن نمط الكتابات مازال، تقريباً يراوح مكانه منفرط عقده إما على محاولات انكارية/ تبريرية ما تبرم مذ ذاك تحاول دفع تهمة التقصير، بحق أو بغير حق، عن من يرمى بها، ويتناسل عن هذه المقاربة محاولات التخفيف، أو التقليل، من شأن نتائج هذه الحرب.
تخطّ مقاربات أخرى نمطاً مغايراً يحمل اتهاماً للشعوب العربية "وحكوماتها طبعاً" بما تتصف به من سمات سيكولوجية تجعلها بالطبيعة "الجوهرانية" محلاً للهزائم، تعينت هذه المقاربات تحت عنوان "النقد الذاتي للهزيمة" لصادق العظم، وما نسج على منواله من تحليلات تستبطن صيغها لجلد الذات "المتخلفة" و "المنحطة" اعجاباً مضمراً بالآخر "العدو هنا" المتفوق المنسجم نفسياً والمتقدم حضارياً في صيغة معدلة لمتلازمة استوكهولم.
هناك أيضاً نمط قارّ ما فتئ يعمل على تحميل الأنظمة العربية القومية، ولا أحد غيرها، أيضاً بحق أو بغير حق، مسؤولية ما حدث، لا يقتصر الأمر على كيل التهم وحصر المسؤوليات، حيث تحضر مصر وسورية فقط، وتغيب الأردن دائماً، بل يصل الأمر إلى درجة الشماتة، يشترك في ذلك ماركسيون "متلبرلون"، أو ليبراليون "بالوراثة والفطرة"، ها هو حازم صاغية (قبل يوم في صحيفة الاتحاد الإماراتية) يستمر كعادته في تحميل "الأنظمة العسكرية الراديكالية" التي "حطمت مجتمعاتها" المسؤولية الحصرية عن الهزيمة، فهي بافتقارها للديمقراطية كانت السبب في ما حصل وهي بالتالي تستحق ما حصل لها وربما أكثر ، سابقاً وبالتأكيد الآن، بينما الأنظمة الملكية القروسطية التي يرفل بنعيم دولاراتها بريئة تماماً من تلك الآثام.
رائحة الشماتة تنضح بنتانة أفصح في كتابات الإسلاميين لتلك الحرب التي هزمت فيها "الجيوش العربية بزمن قياسي" (لا تثريب هنا على الصحف الأجنبية عندما تصفها بالحرب المعجزة) وفقاً لعبد الرحمن خيزران من جماعة العدل والإحسان الذي يسمي شهداء الحرب "قتلى" واصفاً إياها بأنها أنهت "بطراً ناصرياً" لوح بالقوة العسكرية في وجه إسرائيل (تباً له) ومحتفلاً بإنجازاتها التي تسببت بـ "اندحار" الأيديولوجية القومية وما رافقها من إرادات "واهنة" و"واهمة" "تقتات من الشعارات، فبفضل تلك الحرب "ودعنا القومية" بعد أن أصابتها في "مقتل" ما أفسح المجال واسعاً "لتجذر الصحوة الإسلامية" بهذا المعنى كانت 5حزيران "خيراً للأمة" التي لا يريد لها الإسلاميون "نصراً تحت راية أيديولوجية مزيفة وعميّة" أبعدت الشعوب عن الدين، السبيل الوحيد برأيهم للانتصار ودحر العدو، فالإيديولوجية الدينية لا تحارب إلا بمثلها وهذه كانت إحدى الأساطير أو الأوهام التي راجت عن طبيعة الصراع عبر اختزال الصهاينة إلى "يهود" يجب بالتالي أن يحاربهم "مسلمون". يظل من الصحيح هنا أن أحد أخطر تداعيات حرب حزيران كانت في انكفاء وانكسار المشروع القومي لصالح صعود الأيديولوجيات الإسلامية، عبر تضافر عوامل ذاتية وموضوعية في آن معاً.
إلا أن كل ما سبق من تحليلات ومقاربات ليست سبباً للهزائم، أو الانتصارات، في عرف العلوم العسكرية، فلا الخصائص النفسية، ولا الافتقار إلى الديمقراطية ولا الابتعاد عن الدين ولا نظرية المؤامرة يمكن أن تفسر لوحدها ما حدث.
في الوقت نفسه، لا يعني ما سبق على الإطلاق التقليل من خطورة تلك الحرب أو تبعاتها على الدول العربية عموماً، والمعنية خصوصاً، التي خسرت فيها أراض تعادل أربعة أضعاف ما خسرته الجيوش العربية في حرب 1948.
ولا يعني بأية حال تبرئة تلك الدول من التقصير في الاستعداد الدائم للحرب بالتخطيط والتسليح والتدريب والإعداد المعنوي وتأهيل القيادات، إذ لا ريب أن حرب حزيران مثّلت منحىً خطيراً في مسار الصراع العربي الصهيوني وكان لها آثارها وتداعياتها على الأوضاع السياسية والعسكرية والمجتمعية بحيث باتت أحد العوامل التي أثرت، لا بل رسمت، مساراً جيوسياسياً مختلفاً عما قبل، وعدها كثيرون "ولادة ثانية" لإسرائيل التي كانت بحاجة إلى حرب أخرى غير حرب 1948 لجعل النخب العربية تتقبل فكرة وجود إسرائيل وفقاً لبن غوريون.
ونظراً لهول الصدمة التي أحدثتها تلك الحرب بمجمل مجرياتها الخاطفة وغير المسبوقة، فقد جرى تحميلها ما لها وما ليس لها، فليس صحيحاً، على سبيل المثال، ما ذهب إليه عزمي بشارة (في محاضرته الافتتاحية لمؤتمر حرب حزيران – الدوحة- أيار 2017) من أنها "فككت الصف العربي المقاوم للاحتلال" على العكس، يمكن بوضوح تلمس ما أنتجته من عزيمة على الاستمرار في مقاومة العدوان تجلت في حرب استنزاف مصرية طويلة، وفي لاءات الخرطوم الثلاث، حتى آن أوان الثأر لذلك الجرح الغائر في حرب تشرين 1973، التي يمكن عد أيامها الستة الأولى الوجه المقابل لحرب الأيام الستة الحزيرانية، ولولا ما بات معروفاً من تدخل داعمي الكيان الصهيوني بجسرهم الجوي ومن حسابات "تحريكية" للسادات، لربما كان لتلك الحرب قول آخر.
أكثر من ذلك، يمكن القول أن حرب حزيران كانت آخر الحروب التي تنتصر فيها إسرائيل نصراً كاملاً بشكل مباشر عبر جيشها، فمنذ 6 تشرين ونصرها "الناقص" و "المسروق" ابتدأ مسار آخر، احتاج إلى 17 عاماً إضافية (أيار 2000) لمحو صورة الهزيمة والاحساس بالعجز المرافق لها، عندما تكحلت العيون بمرأى الانسحاب الذليل "للجيش الذي لا يقهر" تحت ضربات المقاومة، تضافرت مع هذا المسار وهذه المشهدية، حرب تموز 2006 وغزة 2008 لتجعل من إمكانية الانتصار "واقعاً متحققاً" لولم يكن كلياً وشاملاً.
وفي مفارقة صارخة مع ذلك (كما هي مصادفة توافق الذكرى الخمسون لهزيمة 5حزيران مع 10رمضان يوم انتصار 1973) أنتج انتصار تشرين اتفاقيات سلام / استسلام ثلاث (كامب ديفيد ووادي عربة واوسلو).
أثبتت الأيام أنها لم تؤسس لسلام حقيقي في المنطقة، سلام عبّر عن الافتقار إلى فرص حقيقية له "آرون ميلر" من مركز (وودرود ويلسون الدولي) في مقال كتبه لمجلة "ذي اتلانتيك" بهذه المناسبة (ميلر كان مستشاراً في المفاوضات العربية الإسرائيلية للسلام في أعقاب حرب حزيران).
في مفارقة ثانية، أو ثالثة، خسرت إسرائيل بعد انتصارها في حزيران "مصداقية السردية" التي حاكتها بعناية فائقة عن الدولة "الضحية" التي تتربص بها كثرة كاثرة من "الذئاب العربية" المحيطة بها، رغم أنها عملت جاهدة على رتق ثقوبها بدأب مذ ذلك وحتى الآن.
هكذا، ومنذ أن تدحرجت كرة الثلج بدءاً من حرب تشرين مروراً بالانتفاضات الفلسطينية ووصولاً إلى تموز 2016 وغزة 2008، أيقن الكيان الصهيوني أن زمن "حزيرانه" قد ولى، وأن أدواته التقليدية لم تعد قادرة على إنتاج انتصارات مماثلة، آن إذن أوان تغيير التكتيك: حروب بالوكالة بأدوات داخلية ودعم خارجي "من الخلف" لإضعاف الدول العربية وتفكيكها من الداخل، لتحقيق الهدف الذي بدأت حرب حزيران بالعمل عليه، عبر خلق وقائع جديدة وإشغال الدول التي كانت رأس حربة في المطالبة باستعادة ما احتل عام 1948 بمطالب جديدة لاستعادة أراضيها "هي" وليس أرض فلسطين، التي بدت وكأنها مؤجلة إلى ما بعد ذلك، على أمل أن تنسيها المطالب المستجدة مطالبها القديمة، وبما يضمن استنزاف قدراتها بحيث تتم المصادرة على أي إمكانية لنهوضها أو استكمال تحقيق مشروعها الوطني ذي المضمون العربي والبعد التنموي المستقل (مصر وسورية تحديداً هنا).
نعم، لقد نجحت الحروب التي أشعلها "الربيع العربي" المصنع والمبرمج على الاستفادة من كعوب أخيل في البنية الداخلية لتلك الدول، نجحت في ما لم تنجح به حرب حزيران إلى الدرجة التي يمكن عدّ ذلك "الربيع" نكبتنا الجديدة، بالنظر إلى ما عمل عليه من شيطنة الجيوش العربية، وحركات المقاومة لإسرائيل، واستنزافها، كما نجح في تغييب الصراع العربي الصهيوني الرئيسي والمحوري لصالح صراع مفتعل وبديل هو الصراع السني- الشيعي، لم يعد فيه الكيان المحتل عدواً بل هو أقرب إلى حليف للأنظمة العربية الوظيفية والتابعة (لعل الإيجابية الوحيدة لربيع نكبتنا هذا أنه أماط اللثام عن دور هذه الأنظمة الحقيقي بعد عقود طويلة من التكاذب المتبادل).
سيكتب لحزيران نصره التام إذا ما نجحت الحرب على سورية في فك ارتباطها بالمقاومة وتغيير بوصلتها عن فلسطين، وأما لا، فلا.