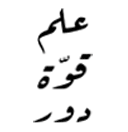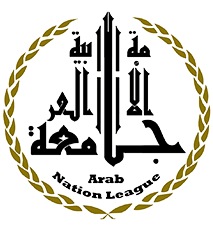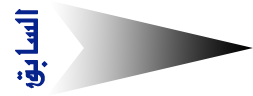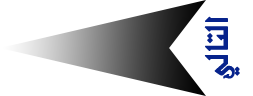يجادل كثير من العرب وربما في العالم الثالث، كجزء من رغبة في استعادة التوازن في العلاقات الدولية، على أن روسيا اليوم أصبحت قوية وقادرة على مجابهة الولايات المتحدة، ويستند بعضهم على معطيات الصراع الأيديولوجي الذي غطى أكثر من سبعة عقود من الزمان بين المعسكرين «الاشتراكي والرأسمالي» وثمرته الحرب الباردة (1947-1989)، وإلى القدرات النووية التي كانت تمتلكها روسيا السوفييتية.
ولعل المثال الأقرب إلى مثل هذه التقديرات، هو الحضور الروسي في الأزمة السورية، من دون نسيان موقف روسيا الحاسم في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وقبل ذلك في الشيشان وغيرها، لكن ذلك شيء، وعودة روسيا كقوة عظمى على المستوى العالمي، شيء آخر، فقد كان سباق التسلّح وحرب النجوم من أسباب سقوط الاتحاد السوفييتي، إضافة إلى فشل خطط التنمية بسبب شحّ الحريات والبيروقراطية المستحكِمة.
وبالعودة إلى الأزمة السورية المندلعة منذ العام 2011، فقد أدركت روسيا أن موقفها من العراق وليبيا (2003 و2011)، أفقدها مواقعها التقليدية في البلدين، لذلك اندفعت للمشاركة في الأحداث المتسارعة في سوريا، إلى جانب نظام الرئيس الأسد، يضاف إلى ذلك شعورها بأن الأخطار باتت قريبة منها؛ بل عند حدودها الجنوبية، لاسيما مشاركة مئات الشيشانيين في المنظمات الإرهابية بمن فيهم عدد من قياداتها، وهذا سيعني أن قوات حلف شمالي الأطلسي «الناتو»، ستصبح قاب قوسين أو أدنى من حدودها؛ الأمر الذي يمثل تهديداً حقيقياً وليس افتراضياً لأمنها الجيوستراتيجي، ارتباطاً مع احتمالات امتداد الجماعات الإرهابية الإسلاموية إلى العمق الروسي، علماً أن الديانة الإسلامية هي الديانة الثانية في روسيا، حيث يزيد عدد المسلمين على 20 مليون مسلم.
وإذا ما أضفنا إلى ذلك احتمال استبدال صادرات الغاز الروسي المتوجه إلى أوروبا، وهو يمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي، بالغاز القطري الذي يمكن أن يمرّ عبر الأراضي السورية، ومنها إلى تركيا وإلى جنوبي إيطاليا، فأوروبا، فسيكون ذلك بمثابة قطع أحد شرايين الحياة بالنسبة لها. وهذا كله سيكون «واقعاً» إذا خسر الروس مواقعهم في سوريا؛ لذلك بدت المعركة مصيرية لأنها معركة «كسر عظم». وكان رأي الكرملين في تبرير تلك الانعطافة، أو تفسيرها، هو أن المنظمات الإسلاموية المتطرّفة مثل «داعش» و«النصرة» (جبهة تحرير الشام لاحقاً)، تمثل خطراً كبيراً على روسيا أيضاً، وعلى السلم العالمي.
وقد اعتمد الرئيس بوتين منذ توليه الحكم في العام 2000، سياسة خارجية جديدة ورسم ملامحها وحدّد مرتكزاتها في ولايته الثانية؛ قوامها تطوير قدرات روسيا لتكون شريكاً فاعلاً للولايات المتحدة وأوروبا، لاسيما بعد نشوء حالة جديدة من العلاقات الدولية تتميز باستخدام القوة على نحو مباشر، عبر تحالف دولي بقيادة الدولة العظمى المتسيّدة للعالم، منذ انتهاء عهد الحرب الباردة وانهيار جدار برلين في 9 نوفمبر/تشرين الثاني1989.
واستهدفت السياسة الروسية الجديدة، العمل على تغيير موازين القوى على نحو هادئ، خصوصاً في إطار محيطها الإقليمي ونطاقها الحيوي، مستفيدة من مراجعة سياساتها وأخطائها مما حصل في أفغانستان والعراق وليبيا، وقد اختلف الأمر بالنسبة لسوريا على نحو جلي وواضح في مواقفها من قرارات مجلس الأمن الدولي، التي كانت واشنطن تريد فرضها، فعارضتها بشدة واستخدمت حق الفيتو (النقض)، وظلّت تستخدمه حتى وصل إلى 7 مرات في العام 2017 (منذ العام 2011)، والسبب في ذلك، كي لا تفقد مواقعها وتخسر معها مصالحها الحيوية، وكي لا يتكرّر المشهد الليبي الذي انعكس سلباً عليها، وعلى ليبيا والمنطقة والعالم، وقبل ذلك ما حصل في العراق.
ولكي تتضح معالم صورة روسيا من خلال سياساتها الخارجية المتعدّدة الاتجاهات، يمكن رصد ما عرضه بوتين في اجتماعه بالسفراء الروس بعد توليه الإدارة للمرّة الثانية (2004)، حين تناول عدداً من الدوائر ذات العلاقة بتوجهات السياسة الخارجية الروسية الجديدة.
أولها: أن السياسة الخارجية ينبغي أن تصبح أداة تحديث لروسيا.
وثانيها: أولوية علاقة روسيا مع الدول التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق. والمقصود بذلك (الدول التي انسلخت عنه واستقلت).
وثالثها: إبقاء العلاقة مع أوروبا بذات الأولوية التقليدية.
ورابعها: السعي للشراكة مع واشنطن.
وخامسها: التعاون مع الدول الواقعة على الساحل الآسيوي من المحيط الهادئ، من أجل تطوير سيبيريا.
وكان بوتين وما يزال إلى حدود غير قليلة يتعامل بحذر شديد مع فكرة «الدولة العظمى»، على الرغم من محاولته العزف على «الوطنية الروسية» التي تبقى حاضرة في أذهان كثير من الروس، والتي يمكن الاستناد إليها في مرحلة الأزمات الحادة والاستعصاءات الوطنية، كما حصل في الحرب العالمية الثانية، وما يحصل اليوم؛ لمواجهة الحصار ونظام العقوبات المفروض على روسيا، لكن ذلك شيء، ومستلزمات الدولة العظمى شيء آخر.