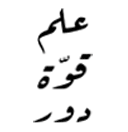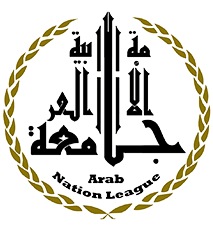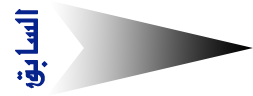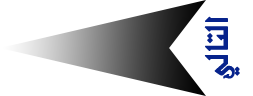ستترك الانتخابات "النصفية" الأميركية (لكلّ أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ) المقرّرة يوم 6 نوفمبر القادم، مزيجاً من التأثيرات السياسية الهامّة داخل أميركا. وستختلف هذه الانتخابات عن مثيلتها في العام 2016، والتي أوصلت نتائجها آنذاك دونالد ترامب للرئاسة وأكثرية من الحزب الجمهوري إلى مجلسيْ الكونغرس، حيث تتوقّع عدّة استطلاعات فوز الديمقراطيين بأكثرية مجلس النواب وربّما بمقاعد إضافية لهم في مجلس الشيوخ، وهذا إن حصل فقد يُشكّل خطراً على الرئيس ترامب نفسه بسبب الدعوات المتزايدة إلى عزله عن موقع الرئاسة.
لكن المميّز الأساس للانتخابات الأميركية القادمة سيكون في حجم الانقسام الحاصل داخل المجتمع الأميركي، بين غالبية شعبية ترفض سياسات ترامب، وبين مؤيّديه الذين ينتمون إلى تجمّعات سكّانية تتّصف بالسمات الدينية المحافظة وبالعنصرية للعرق الأبيض الأوروبي، وهي تنتشر في الولايات الوسطى والجنوبية وفي الأرياف الأميركية، بينما يُهيمن الديمقراطيون على أصوات الناخبين في المدن الكبرى والساحلية بحكم التنوّع الثقافي والإثني والعرقي في هذه المناطق.
صحيح أنّ ما حدث في انتخابات الرئاسة الأميركية، منذ عقدٍ من الزمن، كان تحوّلاً ثقافياً في المجتمع الأميركي سمح بوصول مواطن أميركي أسود، ابن مهاجر إفريقي يحمل اسم حسين، إلى سدّة "البيت الأبيض"، لكن الأصوات التي حصل عليها باراك أوباما في نوفمبر 2008 كانت فقط أكثر من النصف بقليل من عدد الذين شاركوا بالانتخابات، وهذا ما عنى وجود حوالي نصف عدد الأميركيين في خانة المعارضين لكلّ ما كان عليه أوباما من برنامج ورؤية ولون وأصول عرقية، وقبل أن يبدأ حكمه!. كذلك، كانت مشكلة أوباما هي أنّ مؤيّديه كانوا أشبه بتحالف أو جبهة مؤقّتة قامت بين قوًى عديدة اتّفقت فقط على دعمه في الانتخابات، لكنّها لم تكن قوّةً واحدة فاعلة بالمجتمع الأميركي، بل إنّ بعض هذه القوى المحسوبة على اليسار الأميركي والتيّار الليبرالي أرادت من أوباما أكثر ممّا فعل، بينما وجدنا على جبهة المعارضين أصلاً لوصول أوباما للرئاسة (لاعتبارات سياسية أو عنصرية) مزيداً من التنظيم والحركة الشعبية التي زرعت الخوف على مستقبل أميركا وشكّكت حتّى في شهادة ولادته الأميركية، كما كان حال ترامب آنذاك و"حزب الشاي" وبعض المحافظين المتشدّدين في "الحزب الجمهوري"!.
فباراك أوباما دعا إلى رؤية تتّصف بالاعتدال في مجتمع أميركي حكَمه التطرّف لعقدٍ من الزمن تقريباً (حكم المحافظون الجدد في إدارتي بوش الابن) وجرت على أرضه أحداث 11 سبتمبر 2001، وهو مجتمع قام تاريخه على استخدام العنف، وما زال عددٌ كبير من ولاياته يرفض التخلّي عن اقتناء الأسلحة الفردية ووجود الميليشيات المسلّحة.
إنَّ أميركا تعيش حالياً مزيجاً من حالات التمييز الديني والثقافي بحقّ المهاجرين الجدد عموماً وضدّ بعض العرب والمسلمين، إضافةً إلى مشاعر عنصرية ضدّ الأميركيين الأفارقة ذوي البشرة السوداء. وهذه المشاعر بالتمييز على أساس لون أو دين أو ثقافة هي التي تهدّد وحدة أي مجتمع وتعطّل أي ممارسة ديمقراطية سليمة فيه. فكيف إذا ما أضيف إلى هذا الواقع برنامج اليمين المحافظ الأميركي الذي عليه إدارة ترامب، إضافةً إلى الانقسام السياسي التقليدي في أميركا بين "ديمقراطيين" و"جمهوريين" وما في كلِّ معسكر من برامج صحّية واجتماعية واقتصادية مختلفة، وتأثيرات هامّة لشركات كبرى ومصالح ونفوذ "قوى الضغط" الفاعلة بالحياة السياسية الأميركية.
إنّ أميركا التي قامت على أساسٍ دستوري سليم واتّحادٍ قوي بين الولايات، هي أيضاً تأسّست كمجتمع على ما يُعرف اختصاراً بأحرف: WASP والتي تعني باللغة الإنجليزية "الرجال البيض الأنجلوسكسون البروتستانت". والدستور الأميركي العظيم الذي جرى إعداده منذ حوالي 230 سنة، كان معنياً به أولاً وأخيراً هؤلاء المهاجرون القادمون من أوروبا، والذين مارسوا العبودية بأعنف أشكالها ضدّ الإنسان الأسود البشرة المستورد من أفريقيا، إلى حين تحريره قانونياً من العبودية على أيدي الرئيس إبراهم لنكولن، بعد حربٍ أهلية طاحنة مع الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية في أميركا.
أيضاً، كانت الانتخابات في أميركا، قبل عقد العشرينات من القرن الماضي، محصورةً فقط بالرجال إلى أن حصلت المرأة الأميركية، بعد نضالٍ طويل، على حقّها بالتصويت. كذلك بالنسبة إلى أصحاب البشرة السوداء ذوي الأصول الأفريقية، حيث لم يحصلوا على حقوقهم المدنية إلاّ في حقبة الستينات من القرن الماضي. حتّى الشباب الأميركي، بين سن 18 و21، لم يأخذ حقّه بالتصويت في الانتخابات إلّا بعد حرب فيتنام التي كان من ينتمون إلى هذه الفئة من العمر أكثر ضحايا هذه الحرب، فجرى منحهم حقّ اختيار من يقرّر مصير حياتهم!. أيضاً، رغم أنّ النساء يشكّلن أكثر من نصف عدد السكان، فإنّ نسبة تمثيلهنّ في الكونغرس محدودة، وكذلك في مراكز القيادة بالمؤسّسات الحكومية والخاصة، ولم تحصل المرأة الأميركية في كثيرٍ من المواقع المهنية على المساواة مع الرجل في قيمة أجور العمل.
ومن المهمّ أيضاً الإشارة إلى ما شهدته نيويورك وأماكن أخرى، في مطلع القرن الماضي، من حوادث دموية بين "الأصوليين الأميركيين – الواسب" وبين المهاجرين الأيرلنديين الكاثوليك، كانعكاس للصراع بين البروتستانت والكاثوليك في أوروبا.
وقد تعايشت "الأصولية الأميركية" مع كلّ هذه التطورات الدستورية الهامّة وتعاملت مع نتائجها، لكنّ ذلك لم يلغِ العنصرية الدفينة في المجتمع الأميركي ولا المخاوف على المستقبل الديمغرافي والثقافي للولايات الأميركية.
طبعاً أميركا الحديثة هي غير ذلك تماماً، فالهجرة الكبيرة المتزايدة إلى الولايات المتحدة، في العقود الخمسة الماضية، من مختلف بقاع العالم، وبشكلٍ خاص من أميركا اللاتينية، بدأت تُغيّر معالم المجتمع الأميركي ثقافياً ودينياً واجتماعياً وسياسياً، وقد احتضن "الحزب الديمقراطي" هذه الفئات الجديدة، بينما سار "الحزب الجمهوري" باتّجاهٍ محافظ ولّد فيما بعد ظاهرة "حزب الشاي"، التي أصبحت قوّةً مؤثرة داخل تيار "الجمهوريين"، في مقابل نموّ وتصاعد "التيّار اليساري الليبرالي" وسط "الحزب الديمقراطي"، والذي عبّر عنه في الانتخابات الماضية المرشّح بيرني ساندرز.
إنّ المعركة الانتخابية القادمة هي الآن بوضوح معركة بين نهجين مختلفين في قضايا كثيرة داخلياً وخارجياً. وتبرز في الحملات الانتخابية الجارية عناوين القضايا المختلَف عليها فعلاً داخل المجتمع الأميركي، والتي هي تعكس الصراعات الدائرة بين قوى التأثير والضغط التي تقف عادةً مع هذا الحزب أو ذاك تبعاً لمدى تمثيل مصالحها في برنامج كل مرشّح. لكن أيضاً ستظهر في انتخابات نوفمبر القادمة جدّية الانقسامات الأيديولوجية والاجتماعية لدى الأميركيين، وأولويّة المفاهيم الثقافية والدينية والاجتماعية في معايير الكثير منهم لدعم أي مرشّح.
أميركا الآن، في ظل حكم ترامب، تنتعش وتتغذّى فيها من جديد مشاعر التمييز العنصري والتفرقة على أساس اللون أو الدين بعدما تجاوزت أميركا هذه الحالة منذ عقود. فالقوّة الحقيقية لأمريكا الحديثة كانت في تعدّديتها وفي تكامل وانسجام مكوّناتها الإثنية والثقافية وفي نظامها الدستوري الذي ساوى بين جميع المواطنين، وحينما تهتزّ عناصر القوّة هذه، فإنَّ الضعف والوهن لن يكون في القرار السياسي أو في الحكومة المركزيّة فقط، بل في خلايا المجتمع الأميركي كلّه.
أمّا هواجس معظم الناخبين العرب والمسلمين في أميركا فليست مرتبطة بالبرامج الدخلية فقط للمرشحين، بل بما يمكن أن تحدثه الانتخابات من تأثيرات على صعيد السياسة الخارجية. لذلك، ربّما يكون من المفيد أن ينشط الناخبون العرب في أميركا لدعم المرشّحين الديمقراطيين لعضوية الكونغرس وبعض حكّام الولايات وفي المجالس المحلية، وأن يحرص الناخبون العرب على التفاعل العميق مع تيّار بيرني ساندرز الذي يواصل أنشطته وحركته خلال الحملات الانتخابية، ليكون هذا التيّار قوة ضغطٍ على "البيت الأبيض" وعلى الكونغرس، بغضِّ النّظر عن الحزب الحاكم في أيٍّ منهما.