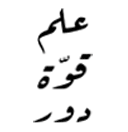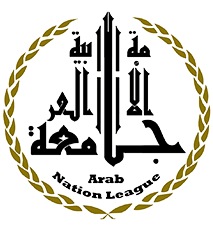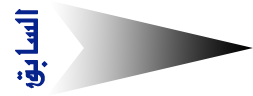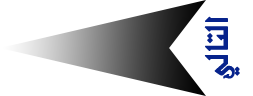مرّ أكثر من عقدٍ من الزمن على إشعال شرارة الحروب الأهلية العربية المستحدثة في هذا القرن الجديد، والتي بدأت من خلال الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 وتفجير الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية فيه، ثمّ من خلال اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بالعام 2005 وتسعير الصراعات السياسية في لبنان، ثمّ بالمراهنة على تداعيات الحرب الإسرائيلية عليه في العام 2006، ثمّ بتقسيم السودان في مطلع العام 2011 وفصل جنوبه المختلف دينياً وإثنياً عن شماله، ثمّ بتحريف مسارات الحراك الشعبي العربي الذي بدأ بتونس ومصر متحرّراً من أي تأثير خارجي، وسلمياً في حركته، فانعكس على دولٍ عربية أخرى، لكنّه انحرف عن طبيعته السلمية المستقلّة بسبب التأثيرات والأجندات الإقليمية والدولية المختلفة، حيث عمل بعضها على توظيف الانتفاضات الشعبية العربية لكي تكون مقدّمةً لحروبٍ أهلية ولصراعاتٍ طائفية ومذهبية وإثنية، ولتغيير كيانات وخرائط أوطان.
وقد رافق هذه الأجندات الإقليمية والدولية المتصارعة على الأرض العربية نموّ متصاعد لجماعات "داعش" المتطرّفة المسلّحة التي استغلّت حالات الفوضى والعنف لكي تمتدّ وتنتشر، بعدما صنعت والدتها "القاعدة" لنفسها قيمة دولية كبرى من خلال أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى بالعالم.
وقد استغلّت إسرائيل طبعاً هذه الصراعات العربية البينية، فواصلت عمليات الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة مراهنةً أيضاً على تحوّل الصراع الأساس في المنطقة من صراعٍ عربي/إسرائيلي إلى صراعاتٍ عربية/عربية، وعربية/إسلامية، وعلى إقامة كيانات طائفية وإثنية تبرّر أيضاً الاعتراف بإسرائيل كدولةٍ يهودية.
وفي غياب التضامن العربي الشامل، فإنّ خيار التسويات هو الحاصل حالياً من قبل الأقطاب الدوليين والإقليميين حتّى لو كانت هناك "معارضات" لهذه التسويات على الصعد المحلّية. لكن هذه التسويات يتمّ وضعها الآن على "ظهر سلحفاة"، بعدما فشلت تجارب دولية انفرادية سابقة بوضع مشاريع تسوية في "قطارٍ سريع"، لكن على سكك معطوبة من قِبَل أصحابها أو ملغومة بفعل هذا الطرف أو ذاك.
وفي ظلّ الظروف العربية السلبية القائمة حالياً وما فيها من مخاطر أمنية وسياسية، فإنّ هذه التفاهمات الدولية، خاصّةً الروسية/الأميركية، هي الأمل الوحيد المتاح حالياً لمعالجة أزمات المنطقة، وهي حتماً مراهناتٌ عربية جديدة على "الخارج" لحلّ أزمات مشكلتها الأساس ضعف "الداخل" العربي وتشرذمه.
وجيّد أن يُدرِك الآن الكثيرون من العرب ما كنّا نحذّر منه منذ بداية الانتفاضات الشعبية من مخاطر غموض الثورات الشعبية التي حدثت وعدم وضوح برامجها ومن يقودها، ومن التبعات الخطيرة لأسلوب العنف المسلّح ولعسكرة الحراك الشعبي السلمي، وأيضاً من عبثية المراهنة على التدخّل العسكري الخارجي، ونتائجه على وحدة الشعوب والأوطان.
إنّ التحرّر الوطني، واستقلالية القرار الوطني، هما الأساس والمدخل لكلّ القضايا الأخرى بما فيها مسألة الديمقراطية. وإنّ أولويّة الإنسان العربي، في أيِّ بلد عربي، هي تأمين لقمة العيش بكرامة وتوفير العلم والسكن والضمانات الصحّية لأفراد عائلته. وهذه الأولوية للمواطن لا تتناقض مع أولويات الوطن من حيث التحرّر والبناء الدستوري السليم. فإذا كان واجب المواطن هو العمل الصالح في المجتمع واحترام القانون، فإنّ واجب الحكومات هو توفير معاني المواطنة التي تحفظ كرامة المواطن وحقوقه أيّاً كان نسبه أو دينه، فبذلك يتعزّز الولاء الوطني لأبناء الوطن الواحد.
إنّ البلاد العربية هي أحوج ما تكون أيضاً الآن إلى بناء مؤسسات وروابط مدنية عروبية ديمقراطية تستند إلى توازن سليم، في الفكر والممارسة، بين شعارات الديمقراطية والتحرّر الوطني والهويّة العربية. مؤسسات فكرية وثقافية وسياسية تجمع ولا تفرّق داخل الوطن الواحد، وبين جميع أبناء الأمَّة العربية. وإذا ما توفّرت لهذه المؤسسات، القيادات والأدوات السليمة، يصبح من السهل تنفيذ الكثير من الأفكار والمفاهيم والشعارات التي تستهدف نهضة الأوطان والعرب.
نعم هناك ضرورةٌ قصوى للإصلاح والتغيير في عموم المنطقة العربية، ولوقف حال الاستبداد والفساد السائد فيها، لكن السؤال كان، وما يزال، هو كيف، وما ضمانات البديل الأفضل، وما هي مواصفاته وهويّته؟! فليس المطلوب هو هدم الحاضر دون معرفة بديله في المستقبل، أو كسب الآليات الديمقراطية في الحكم بينما تخسر الأوطان وحدتها أو تخضع من جديد للهيمنة الأجنبية، إذ لا يمكن الفصل في المنطقة العربية بين هدف الديمقراطية وبين مسائل الوحدة الوطنية والتحرّر الوطني والهويّة العربية.
ولا أعتقد أنّ هناك أمَّةً في العالم تشهد خليطاً من الصراعات والتحدّيات كما هو عليه حال الأمّة العربية. فهذه الأمَّة تشهد، وعلى مدار قرنٍ من الزمن، مزيجاً من الأزمات التي بعضها هو محصّلة للتدخّل الخارجي والأطماع الأجنبية، وبعضها الآخر هو إفراز لأوضاع داخلية يسودها الاستبداد السياسي والتمييز الاجتماعي والفوضى الاقتصادية والفساد الإداري، إضافةً إلى جمود فكري متواصل في كيفيّة فهم الدين وعلاقته بالمجتمع، وليس بالحكم.
ورغم ومضات الأمل التي ظهرت عربياً بين فترةٍ وأخرى، واستمرار إرادة العمل من أجل التغيير على أكثر من ساحة عربية، فإنّ المراوحة في المكان نفسه، بل التراجع والانحدار الخطير، هما السمة الطاغية الآن على الأوضاع العربية.
وقد تعرّضت أممٌ كثيرة خلال العقود الماضية إلى شيء من الأزمات التي واجهت العرب، كمشكلة الاحتلال والتدخّل الأجنبي، أو كقضايا سوء الحكم والتخلّف الاجتماعي والاقتصادي، أو مسألة التجزئة السياسية بين أوطان الأمّة أو الحروب الأهلية في بعض أرجائها .. لكن من الصعب أن نجد أمّةً معاصرة امتزجت فيها كلّ هذه التحدّيات في آنٍ واحد كما يحدث الآن على امتداد الأرض العربية.
فخليط الأزمات يؤدّي إلى تيه في الأولويات، وإلى تشتّت القوى والجهود، وإلى صراع الإرادات المحلية تبعاً لطبيعة الخطر المباشر، الذي قد يكون ثانوياً لطرفٍ من أرجاء الأمّة بينما هو الهمّ الشاغل للطرف الآخر، خاصّةً بعد غياب دور المرجعية العربية الفاعلة، وبعدما تعطّلت البوصلة التي كانت تُرشد العرب، وهي القضية الفلسطينية، كرمز للصراع العربي/الصهيوني المستمر لمائة عام.
ولا ننسى ما حدث في نهاية القرن الماضي، من ضغوط أميركيّة كثيرة من أجل التطبيع العربي مع إسرائيل قبل إنهاء احتلالها للأراضي العربية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلّة، كمدخل لمشروع "الشرق الأوسط الكبير"، وهو المشروع الذي جرى الحديث عنه علناً في مطلع حقبة التسعينات بعد مؤتمر مدريد للسلام، وأوضحه شيمون بيريز آنذاك بما كتبه من دعوة لتكامل التكنولوجيّة الإسرائيليّة مع العمالة المصريّة مع المال الخليجي العربي في إطار "شرق أوسطي جديد" يُنهي عمليّاً "الهويّة العربية" ويؤسّس لوضع إقليمي جديد تكون إسرائيل فيه بموقع القيادة الفاعلة.
ربّما المنطقة العربية الآن هي عشيّة مرحلة وقف الحروب الأهلية وبدء الخروج من النفق المظلم الذي ساد لسنوات، لكن هي المرحلة الأخطر لأنّ كلّ طرف معني بصراعات المنطقة سيحاول تحسين وضعه التفاوضي على "الأرض" قبل وضع الصيغ النهائية للتسويات. وتحدث كل هذه التطوّرات الهامّة بينما العرب منشغلون في أوضاعهم الداخلية. فلا توافق عربياً شاملاً على أي أزمة عربية، ولا رؤية عربية مشتركة لمستقبل المنطقة في ضوء المتغيّرات الحاصلة. ولعلّ ما يزيد من حجم المرارة في وصف الحاضر العربي أنّ الشعوب، وليس الحكومات فقط، غارقة أيضاً في الانقسامات!.
ومهما حدثت تطوّرات إيجابية محتملة، فإنّ السؤال يبقى: ما ينفع أن تخرج الأزمات العربية من النفق المظلم بينما تستمرّ عيون العرب معصوبةً بسواد الانقسامات، وأياديهم مقيّدةً بسلاسل الارتباطات الخارجية!؟.