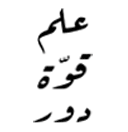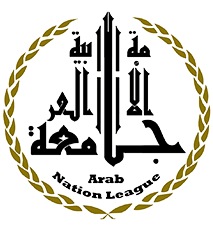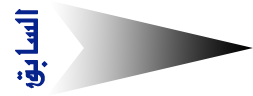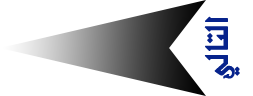في قلب الكثير من مشاكل الأمة العربية موضوع ثقافي يتعلق بمدى وجود العقلانية ومقدار ممارستها في الحياة العربية.
نحن هنا لا نتكلم عن العقل، فهو موجود في الإنسان العربي بنفس القدر ونفس الإمكانيات الموجودين في البشر الآخرين. وكل حديث عن نواقص تركيبية ذاتية في العقل العربي هو تمييز عرقي منحاز وحقير.
أما العقلانية فإنها معنية بمرجعيات العقل الفكرية والثقافية، وبمدى وجود حرية استعماله دون قيود عقدية وسلوكية وتشريعات قانونية وعادات خاطئة.
وليس أفضل، لفهم تلك الظاهرة في الحياة العربية، من تتبّع مسيرتها في التاريخ العربي، خصوصاً وأن مناهج التاريخ والدراسات الإنسانية في مدارسنا وجامعاتنا
لا تعطي المقدار الكافي من الأهمية لهذا الجانب من تكوين ثقافة وسلوكيات ونمط حياة هذه الأمة، وذلك لسبب حساسية الموضوع عند البعض، واختلاط مفاهيمه، وارتباطه بمحاولات استعمارية و«إسرائيلية» لتحقير هذه الأمة.
هذا موضوع يجب أن يناقش على نطاق واسع، مرّات ومرّات، إلى أن يستقر على أسس موضوعية رزينة وصادقة مع النفس، وإلى أن تصبح العقلانية منهجية حياة وميزان قياس لكل نشاط.
من الضروري أن يدرك الشباب أن غياب العقلانية هو انطفاء مؤقّت لنور أضاء جزءاً من تاريخ أمتهم، ثمّ انطفأ لأسباب مجتمعية لا دخل لها بالإمكانيات الذاتية لعقل الإنسان العربي.
بداية، مجّد القرآن الكريم استعمال العقل وممارسة التفكير الحر المستقل غير الخاضع للعادات والأعراف القديمة. لكن الخلافات والصراعات السياسية، بعد موت النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم )، أضعفت الوهج القرآني، بما فيه عقلانيته، لحساب أقوال وحكايات نسبت للرسول ولآل بيته وأصحابه، من أجل ترجيح كفّة هذه الجماعة أو تلك.
وشيئاً فشيئاً ألبست الأقوال والسّير والتفسيرات والاجتهادات ثياب القدسيّة حتى تبّرر وتتعايش مع كل أخطاء وخطايا الملك العضوض. وهكذا ران خمول فكري، وصعدت الممارسة السّلفية الخاضعة لتقاليد وأفهام وأقوال الماضي.
لم يدُم ذلك طويلاً، إذ بعد عقود قليلة ظهرت أولاً مدرسة القدرية ( من قدرة الإنسان) التي تعلي من شأن إرادة الإنسان الحرّة التي يتطلب وجودها استعمال العقل. وكامتداد لها وتعميق جوانبها الفكرية، ظهرت حركة المعتزلة.
هنا منح استعمال وتحكيم العقل أولوية على النّقل السّلفي الأعمى من أجل التأكيد على إن الإنسان لابدّ أن يكون مخيّراً ومسؤولاً عن نتائج أعماله، إذا كان سيحاسب على تلك الأعمال من قبل القدرة الإلهية.
لقد وصلت حركة المعتزلة، الرافعة لشعار أن تكون العقلانية هي مرجعية فهم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وصلت إلى ذروة انتشارها وهيمنتها في عصر المأمون العباسي. ولو لم تقحم حركة المعتزلة نفسها في إشكالية محنة «خلق القرآن» أو «وجوده منذ الأزل»، مع كل ما صاحبها من تخمينات وممارسات عبثية، ثم دخولها في ممارسة الاستبداد ضدّ المخالفين لما ترفع من شعارات، ثم التصاقها بصراعات سياسية لا دخل لها بالفكر والفهم الديني... لو لم تقحم نفسها في كل ذلك، لاستمرّت المدرسة العقلانية في فهم الدين، ومن ثمّ فهم السياسة والاجتماع والسلوك الإنساني، ولما دخلت الحضارة العربية - الإسلامية في خريفها العقلي.
كرّد فعل للمبالغات والتعصّبات المعتزليّة ظهرت مدرسة الإمام أحمد بن حنبل الفقهية السلفية المتشدّدة، مدرسة المحدّثين، أي الآخذين بالأحاديث والفقه المتزمّت العنفي. ثم ظهرت المدرسة الفقهية الأشعرية التي بالرغم من ادعائها بالوسطية بين المدرسة الحنبلية المتشدّدة والمدرسة المعتزلية، إلا أنها كانت معادية بعنف واجتثاث للمدرسة المعتزلية، أي لشعار استعمال العقلانية في فهم الدين والحياة.
وبعدها توالت الإحن والمحن على المدرسة المعتزلية العقلانية. فالإمام الغزالي بهجومه العنيف على الفلسفة هاجم العقلانية بصورة مباشرة، واعتبر العقل العدو الأول للإسلام. وابن تيمية رفع شعار الابتعاد عن ممارسة المنطق بقوله الشهير «من تمنطق فقد تزندق».
ومن أجل إيقاف تلك الصراعات صدر قرار غلق باب الاجتهاد، أي استعمال العقل والمنطق في تجديد فهم الدين.
وبالرغم من محاولة ابن رشد لردّ الاعتبار لمكانة العقل، إلا أن محاولته فشلت وأحرقت غالبية كتبه. ومع الأسف فإن الغرب هو الذي استفاد من عقلانية ابن رشد وأخذ بها، كجزء من نهضته وأنواره، بينما دخلت المجتمعات العربية في ممارسة فقهية لاعقلانية عنيفة وصلت الآن إلى ذروتها في مسميات «القاعدة» و«داعش» وأخواتهما.
كانت نهاية مأساوية، بدأت برفض قدرة العقل على فهم الدين، وانتهت شيئاً فشيئاً إلى عدم استعمال قدرة العقل في فهم الواقع وتغييره وتجديده.
فمثلما استطاع الغرب أن يخرج من فترة تاريخه اللاعقلانية في العصور الوسطى إلى رحاب نهضته الحديثة، فإن العرب يستطيعون ممارسة ذلك الانتقال والتحوّل.
ذلك أن وهج العقلانية في تاريخ هذه الأمة يؤكّد قدرة عقل إنسانها على ممارسة كل متطلبات العقلانية في كل مناحي الحياة العربية.