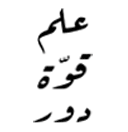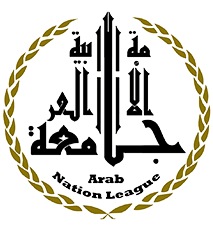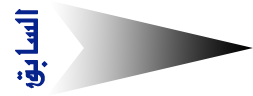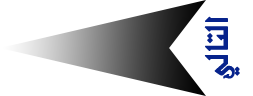حلّت قبل مدة قصيرة الذكرى المئوية الثانية لميلاد كارل ماركس ، الفيلسوف والمفكّر وعالم الاجتماع والاقتصادي والسياسي، الذي شغل العالم وملأ الدنيا، بأفكاره ونظرياته وأطروحاته، وقبل ذلك بمنهجه الجدلي. وكنت كتبت قبل ثلاثة عقود ونصف من الزمان (1983) مقالة في مجلة الهدف الفلسطينية بعنوان: “بروموثيوس هذا الزمان”، وهو استعارة عن حامل شعلة الفكر الربانية، أشرت فيه إلى فضل ماركس على البشرية من خلال اكتشافه قوانين الصراع الطبقي وفائض القيمة، وقلت ولا أزال إن إضافته الأساسية هي في منهجه الجدلي، وهو المنهج الذي استخدم بطرق خاطئة في الكثير من المرّات. وإذا كان ماركس مفترى عليه في عصره وحياته، فلم ينجُ من الافتراء حتى بعد مماته وبعد تاريخ طويل. والإفتراء جاء من جانب أعدائه وخصومه مثلما ورد من جانب مريديه وأتباعه على حدٍّ سواء، خصوصاً حين تعامل هؤلاء مع تعاليمه كنصوص مقدّسة، وحفظوا بعض مقولاته بطريقة أقرب إلى الأسفار التوراتية أو الآيات الإنجيلية والقرآنية. وأكثر من ذلك حين ردّدوها بوصفها تعاويذ أو أدعية فيها شفاء من كل شيئ وتم استخدامها بطريقة تلقينية لا علاقة لها بزمنها أو بجوهر العصر لاسيما بإضفاء قدسية كهنوتية عليها كان ماركس من أشد أعدائها، خصوصاً حين نزّهوه عن الخطأ ووضعوه خارج نطاق النقد وهو الذي عد المثقف ناقداً اجتماعياً. وجرى أحياناً التعامل مع ماركس والمادية الجدلية انطلاقاً من موروثات ريفية أو بدوية أو دينية وبطريقة انتقائية فيها الكثير من الخفّة والركاكة، في حين هي فلسفة حداثية مدنية يسمح منهجها بالحذف والإضافة والتطوير. وكان الأعداء والخصوم في السابق والحاضر وجدوا في ماركس وفلسفته، وخصوصاً منهجه خطراً على مصالحهم، فلعنوه وطاردوه بسبب الأفكار الجذرية التي حاول التنظير لها لإحداث التغيير المنشود ضد الفكر البرجوازي والهيمنة الرأسمالية الطبقية السائدة. أما المريدون والأتباع فقد عدوه “قديساً” لا يأتيه الباطل من خلفه أو من أمامه، وحسب بعض دعاته إن كل مساس بفكرة قال بها ماركس أو استنتاج توصل إليه كأنه مساس بأيقونة تستحق أن توضع في متحف بحيث لا تطالها الأيادي أو تلمسها ، ومنطق هؤلاء مثل منطق أصحابنا الإسلاميين على اختلاف انحداراتهم، شيعة وسنّة، يعتبرون ما قاله أئمتهم أو مرشدوهم يمثّل الحكمة والرشاد والفضيلة، وهكذا يتم تمجيد هؤلاء دون نقاش لآرائهم وأفكارهم، سواءً في الماضي أم في الحاضر، علماً بأنهم مثل غيرهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن الآيديولوجيا العمياء تريد إضفاء القدسية عليهم وعلى أعمالهم، والأمر ينسحب على الآيديولوجيات القومية والبعثية، فمجرد ذكر أي انتقاد لزعيم أو قائد يجعل منه عدوًّا أو خصماً، علماً بأن الأعمى يكاد يرى نتاج سياسات الاستبداد والإقصاء والتهميش. وبالعودة إلى ماركس فإن مثل هذه النظرة التقديسية تبقى حبيسة في النفوس كلّما سمع أحدهم نقداً أو تقريضاً لبعض أفكاره، أو أن الزمن تجاوز الكثير من أحكامه واستنتاجاته، والأمر ينسحب على لينين وحتى ستالين وإلى الأمين العام لهذا الحزب أو ذاك، سواء في تجارب الأصل أم في تجارب الفرع، وهي ثقافة سائدة لدى جميع الأحزاب الشمولية، شيوعية أو قومية أو إسلامية، حيث يتم التعامل معها من منظور عشائري، فكيف يتم انتقاد شيخ العشيرة مثلاً أو المرشد أو الإمام أو آية الله. لا أخال أحداً من جيلنا الستيني لم يترك اسم ماركس شيئاً لديه، سواءً كان من أنصاره أم من خصومه، ومع ذلك فإن ماركس لم يُقرأ عربياً وعراقياً، علماً بأن الأزمة الراهنة للرأسمالية، أعادت ماركس إلى الواجهة مرّة أخرى وكانت نتائج استفتاء لهيئة الإذاعة البريطانية BBC قد وضعت ماركس من بين 100 شخصية مؤثرة في العالم، حتى أن رجال أعمال ومدراء مصارف ورؤساء شركات تأمين شرعوا بقراءة كتاب “رأس المال” على نحو جديد الذي كان من بين الكتب الاقتصادية والسياسية الأكثر انتشاراً في أواخر العقد الماضي، ومع ذلك أقول إن ماركس لم يُقرأ عندنا، واصطفّ خصومه ينددون به ويتهمونه شتى التهم بما فيها الإلحاد، استناداً إلى تفسيرات خاطئة وإغراضية لعبارته الشهيرة ” الدين أفيون الشعوب” التي أخذها عن الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط، ووصولاً إلى رفض فكرته بإلغاء الاستغلال والانقسام الطبقي، مثلما كان مريدوه يتجمعون ليتغنّون بمواهبه وعبقريته، دون أن يستنبطوا الأحكام الصحيحة بواسطة منهجه وليس بتكرار مقولاته وأحكامه.وأعرف (شيوعيين) متعصبين أشدّ التعصّب، لم يقرأوا كتاباً واحداً كاملاً لماركس باستثناء “البيان الشيوعي” في أحسن الأحوال، ولولا الدراسة الشكلية في المدرسة الحزبية لبعض الكوادر لما كان تم قراءة هذا الكرّاس كاملاً في العديد من الحلقات والمفاصل الحزبية التنظيمية العليا أو الوسطية، خصوصاً وإن العمل اليومي المسلكي والإداري يكاد يستغرق الأغلبية الساحقة منها وحتى تلك القراءات كانت خلطة من رؤية سوفيتية وطبعات مستنسخة في مدارس الدول الاشتراكية الأخرى، ولكن ما أعرفه أيضاً أن صورة ماركس ولينين كانت تعلّق فوق الرؤوس أحياناً وفي المكاتب إذا سمحت الظروف، ولو إن بعضهم علّق صورة الخميني لاحقاً في ظروف الحرب العراقية – الإيرانية في المنفى، وهو أمرٌ ليس من باب النكتة، بل واقعاً. ماركس الذي كان شبحه يجوب أوروبا العجوز، “رمز الشيوعية” لوحق في فرنسا وطرد منها وذهب إلى بروكسل فطاردوه وانتقل إلى ألمانيا ليشارك في ثورة العام 1848 وحين فشلت غادر إلى لندن ليقضي فيها بقية حياته من العام 1849 ولغاية العام 1883 وعاش في ظروف مادية قاسية، ولولا مساعدات رفيقه في الفكر والعمل، فردريك إنجلز لما تمكّن من العيش وكان قد كتب معه: البيان الشيوعي ” المانيفاستو” والعائلة المقدسة، وأزهرت أفكارهما لتنجب ما نطلق عليه “الماركسية” أو “التمركس″، خصوصاً وهما مثّلا الحلقة الذهبية الأولى فيها. وأهم استنتاجات البيان الشيوعي أن تاريخ المجتمعات الإنسانية هو تاريخ نضال الطبقات وأن المجتمع أخذ بالانقسام إلى طبقتين ، أغلبية محرومة ” البروليتاريا” وأقليّة متخمة ” البرجوازية”، وبنى ماركس استنتاجاته على هذا التقدير، واضعاً رسالة للطبقة العاملة للإطاحة بالرأسمالية وإلغاء المجتمع الطبقي. واستقرأ التاريخ الإنساني ومراحله، وهو ما أكّد استنتاجه من أن الرأسمالية هي المرحلة الأخيرة للتطور الإنساني، وإن تناقضاتها ستؤدي إلى انهيارها الحتمي، وقد حاول لينين تطوير هذه القاعدة التي ارتكز عليها ماركس، فاعتبر “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية”، وحلّل ماركس وشرح وفسّر الرأسمالية القائمة في عهده أحسن تحليل وتشريح وتفسير، وهو ما يدعونا للقول أن “الماركسية هي علم الرأسمالية” بامتياز، وكان للمنهج الذي اعتمده والذي ما يزال صالحاً الأساس في بلورة استنتاجاته.
انعكاس الواقع
وقد قرّر ماركس أن تفكير البشر هو انعكاس لواقعهم الاجتماعي الذي يحدّد نمط حياتهم ووجودهم، باعتبار المادة هي أساس الوجود وهي في حالة تطور والتاريخ البشري مرهون لهذا التطور في الظروف المادية، ووفقاً لهذه القاعدة حدّد ماركس رؤيته للكون والعالم والثروة والاقتصاد والسياسة والثقافة والتغيير والثورة. وإذا كان منهجه الجدلي صحيحاً، فليس جميع مقولاته صحيحة، وحتى لو كان بعضها صحيحاً، فإنها ليست صحيحة لعهدنا، خصوصاً في ظل الثورة العلمية- التقنية، أو أنها كانت صحيحة لذلك العهد، فإنها لا تصلح لعهدنا وعلينا استنباط الأحكام الخاصة بنا في ظل الظروف الملموسة. وبهذا المعنى ليست جميع التنبؤات الذي قال بها ماركس يمكن أن تتطابق مع الواقع، فالرأسمالية حطّمت الإقطاع ووجهت النظم والحكومات والبلدان نحو المدنية وتمركزت المِلْكية بيدها أو بيد فئة صغيرة، خالقة عالماً جديداً. وهذا يجسّد صواب رؤية ماركس حيث تعولمت الرأسمالية من خلال ثورة الاتصالات والمواصلات وتمركز المال وازدادت الفجوة الطبقية والاجتماعية، الأمر الذي كان حسب ماركس يقتضي عملية التغيير. وإذا كانت الأزمة الاقتصادية والمالية الطاحنة قد أعادت “طيف ماركس” إلى الواجهة، بعد أن أصبح شبحه «أثراً بعد عين» كما يُقال، الأمر الذي اعتبره البعض جزءًا من المتحفية إذا جاز التعبير، فإنها في الوقت نفسه استحضرت التجربة الشيوعية الدولية، خصوصاً نماذج الماركسية السوفييتية المطبقة. صحيح أن ماركسية القرن الحادي والعشرين لا تشبه ماركسية القرن العشرين، وإنْ كانت تلتقي مع ماركسية ماركس في القرن التاسع عشر، لكنها قد تتجاوزها إلى آفاق أكثر رحابة في ظل مرحلة ما بعد الحداثة والثورة العلمية-التقنية والعولمة وتأثيرها، ومعارفها وعلومها. ولعلّ “الماركسية السوفييتية” تختلف اختلافاً كبيراً عن “ماركسية ماركس” وطبعتها الكلاسيكية، مثلما تختلف هذه الأخيرة التي كشف ماركس قوانينها في القرن التاسع عشر، عن ماركسية ما بعد سقوط جدار برلين العام 1989 ولا شك أن ماركسية القرن الحادي والعشرين ستكون شيئاً آخر، حيث لم يعد التاريخ كما كان المتخيّل منكشفاً في ثنائيات وتبسيطات في ماضيه وحاضره ومستقبله، وعن تشكيلات ومراحل وأدوار يحكمها الصراع الطبقي بكليّاته، ويطرح أشكالاً تتواءم مع التفسيرات اليقينية والحتميات السائدة آنذاك. وكانت إنجازات ماركس قد ساهمت في تعميم معارف عصره، واستنباط حلول تتواءم مع التطور السائد حينئذ، وهو ما أسماه الانتقال إلى عالم الحرية، الذي لم يكن سوى فهم الضرورة، وظلّت الماركسية الكلاسيكية تدور في وحول “الحتميات التاريخية” على نحو سرمدي، وإنْ لم تعر اهتماماً بدور الفرد، معتبرة إيّاه عرضة للتوّهمات والكبوات، وعندما حلّت لحظة تطبيق الماركسية من خلال نظام حاكم، هيمنت عليها الهرمية الكيانية البيروقراطية الحزبية، حيث ارتفع دور الفرد القائد الزعيم، وإن اعتبر الأفراد بفرديتهم وبجمعهم ليسوا سوى جزء صغير وربما مجهري من حركة التاريخ ومساره، الذي تصنعه الطبقة العاملة وطليعتها ويتربع على عرشه القائد الذي تُنسب إليه جميع الصفات الخيّرة فكرياً وإنسانياً وأخلاقياً لدرجة التماهي بينه وبين الطبقة. وقد عمّمت الستالينية نموذجاً احتذى به القادة الآخرون وساروا على هداه، ولعلّ بعض زعماء ما أطلق عليه “حركة التحرر الوطني”، قلّد هذا النموذج بحذافيره، بل زاد عليه في ظروف العالم الثالث المتخلفة، ممارسات أكثر بؤساً على صعيد الإدارة والاقتصاد والسياسة والثقافة وحقوق الإنسان، وبشيء من موروثه وعاداته وتقاليده بما لا ينسجم مع الفكرة الماركسية. لقد شغلت الماركسية، لاسيّما منذ البيان الشيوعي العام 1848العالم أجمع والعلاقات الدولية خلال 170 عاماً ولا تزال، وعندما وصلت إلى السلطة لأول مرة بعد سقوط كمّونة باريس العام 1871 بنجاح ثورة أكتوبر العام 1917 شقّت العالم إلى قسمين، وشهد التاريخ أولى تجارب الحكم «الاشتراكي» وتوسّع الأمر بقيام الجمهوريات الديمقراطية الشعبية بعد الحرب العالمية الثانية العام 1945 ومن ثم نجاح ثورة الصين العام 1949 وتأثر بعض حركات وزعامات العالم الثالث، بالحركة الشيوعية والاشتراكية الدولية، في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، خصوصاً بعد نجاح الثورة الكوبية العام1959 .
مادية جدلية
بهذا المعنى كانت المادية الجدلية منهجاً للتحليل وأداة للعمل من أجل التغيير، وإذا كان قد سبق ماركس وجايله الكثير من المفكرين والباحثين، مثل كانط وديكارت وهيغل وفيورباخ وغيرهم، إلّا أنه كان الوحيد بينهم الذي ترك مثل هذا التأثير على العالم أجمع، فلم يكن مفكّراً كبيراً أو باحثاً متعمقاً أو فيلسوفاً حالماً أو منظماً وداعية حسب، بل كان كلّ ذلك. ولعلّ في هذه الموسوعية وربط الفكرة بالعمل مصدر قوّته وربما مصدر ضعفه في آن، فالمشروع الماركسي الفلسفي قدّم رؤية للتاريخ من جهة، مثلما قدّم منهجاً للتحليل، وهما الأساسان اللذان تعتز الماركسية في حلقتها الذهبية الأولى (ماركس وانجلز) بإضافتهما إلى علم الاجتماع الإنساني، مثلما كانت مشروعاً لتحرير الإنسانية، وحركة ثورية ذات أهداف محددة، لكنها لم تنجح في الاختبار في تجارب دامت نحو 70 عاماً، ولعلّ الجزء المهم منها ظلّ يوتوبياً، ففي كل فلسفة جزء من اليوتوبيا. لم تحبس الماركسية نفسها في إطار الجدل الفكري الأوروبي، بل كانت الساحات العالمية كلّها مجال حركتها، الأمر الذي وضعها في مواجهة الرأسمالية في كلّ مكان، وهذا الأمر أخذ طابعاً تعبوياً وسياسياً بعد التجارب الاشتراكية الأولى، خصوصاً بعد ثورة أكتوبر وتأسيس الأممية الثالثة بقيادة لينين العام 1919 التي استمرت حتى العام 1943? حيث تم حلّ الكومنترن. احتفى البعض بموت الماركسية، بل إنه أهال عليها التراب بعد دفنها، وما تبقّى منها وضعه في إطار الذكريات أو الكتب المتحفية، وكان بعض الماركسيين قد حاول تدوير تاريخه وإنكار احتسابه على هذا التيار الذي ظنّ أنه تم توديعه إلى الأبد ولم يعد أحد يتذكّره، وإذا بالأزمة المالية العالمية تعيده إلى الصدارة ويصبح طيف ماركس وليس شبحه في كل مكان.
فكرة شمولية
وكما أصبح الحديث عن موت الماركسية بوصفها فكرة شمولية توتاليتارية، ومدخلاً للحديث عن ولادة الليبرالية الجديدة، فقد أصبح الحديث عن فضائل الأخيرة وسيادتها وظفرها مسألة موازية، وهو ما بشّرنا بها فرانسيس فوكوياما حين تحدّث عن نهاية التاريخ وتلقفها بعض زملائنا من الماركسيين القدامى “الليبراليين الجدد”، منتشين باكتساح العولمة للقارات والدول والأمم والشعوب واللّغات والنظم والحدود. وإذا كان هناك في الغرب من أخذ يتحدّث عن عودة ماركس ولكن ليست الماركسية الوضعية النقدية، حيث يريد ماركس لا بسترته المتّسخة، بل كعالم إنثربولوجي وسسيولوجي واقتصادي، ويسير خلفه لا جوقة الرعاع والبروليتاريا، بل مجموعة من البروفسيرات والأدباء والفنانين والمثقفين وأجمل النساء، وهؤلاء يريدون من الماركسية ومن ماركس فكرته الفلسفية ضمن طائفة الأفكار الفلسفية التي تغتني بها اللوحة الفكرية الأوروبية-الغربية، أما هدف تغيير العالم وليس تفسيره، كما دعا إليه ماركس، فهذا أمر تاريخي ومتحفي ليس إلاّ حسب وجهة نظرهم، بحيث لا يتم جمع النظرية إلى جانب التطبيق، وهو ضرورة، انفصلت عنها التجارب الاشتراكية بالكامل وفي جميع الحقول والمجالات. لاشكّ أن الذي مات هو النموذج أو الموديل السوفييتي، وقد أثبت فشله وعدم صلاحه وبالتالي انهياره، لأنه لم يكن ماركسياً أو اشتراكياً، بقدر كونه نموذجاً توتاليتارياً-استبدادياً حيث شكلت قاعدته القسرية الإكراهية الأساس في تطبيقه، الأمر الذي جعله صورة مشوّهة للماركسية الكلاسيكية، رغم بعض نقاط ضعف الأخيرة، وكانت صورة لينين وبالدرجة الأساس ستالين الشاهد الحقيقي للتشويه القيمي والفكري للماركسية، لاسيّما بغياب وجهها الإنساني. ولذلك فإن تبديد أو حتى موت النموذج القسري سيكون متوائماً ومنسجماً مع جوهر الماركسية وذاتها لا خلافاً معها، خصوصاً أن أفكار ماركس المستقبلية لم تكن محط اقتناع، بل هي الأخرى حملت إشكاليات زمانها، فضلاً عن إشكاليات زماننا. وإذا كانت تقديرات ماركس وقراءة بعض أطروحاته، لاسيّما التي تم تطبيقها لم تزكها الحياة، مثل نظريته عن الدولة، التي قال إنها ستذبل وإشكالية دور الفرد في التاريخ، ودور العامل النفسي ووصمه شعوباً بالرجعية بالكامل في معرض حديثه عن الشعب التشيكي، فإن جوهر منهجه ظل حيوياً وقادراً على تحليل واستنباط الأحكام والحلول، رغم أن البعض أرادها أحكامه وحلوله، في حين يقتضي المنهج الماركسي أن نكتشف قوانينا وحلولنا وأحكامنا، لا قوانين وأحكام ماركس، التي كانت تصلح لزمانه وليس لزماننا. هل يحق لنا أن نقول إن الماركسية كفلسفة تستطيع أن تجدّد نفسها رغم شيخوخة بعض جوانبها، حتى إن استبقت بعضاً منها في المكتبات أو اليوتوبيات أو الأحلام أو المتحفيات، فتلك مأثرة الفكر الحي ورائدة بروموثيوس الذي يستحق كما الماركسية القراءة الارتجاعية، بمنهج نقدي وضعي، لا بمسلّمات عفا عليها الزمن!!
صحيفة الزمان العراقية