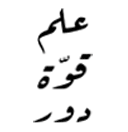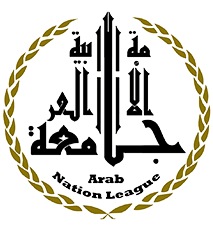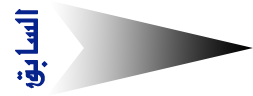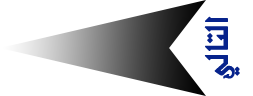حين يتحدث من يتحدث (الدساتير العربية في ديباجاتها مثلاً) عن «دين الدولة»، فإنما الوصف ذاك يجري مجرى المجاز لا مجرى التعيين الدقيق؛ إذ ما من دولة ذات دين، أو تحمل كيانها على ماهية دينية بها تتحدد كدولة وتكتسب شخصيتها، وإلا عُدَّ نظام الحكم فيها نظاماً ثُيوقراطياً. وإذا كان من السائغ أن يصدق ذلك على أنظمة الحكم القائمة في دول القرون الوسطى، من التي كان الدين من أساسات شرعيتها وقيامها، فمن العسير أن يصدق على دول حديثة لم يعد النظام الديني وأحكامه الشرعية نظاماً لها، أو - على الأقل- لم تعد أحكامه الشرعية تمس إلا جوانب جزئية من الحياة الاجتماعية فيها مثل الأحوال الشخصية مثلاً (كما في الدول العربية)، فيما أكثر القوانين الحاكمة في منظومتها وضعي مبلوغ إليه إما من طريق الاقتباس (من منظومات قانونية غربية) فالتوطين، أو من طريق الاشتقاق المحلي والتوافق داخل المجتمع السياسي، أي نظير أي نموذج في العلاقة بين الدولة والدين خارج نطاق الدائرتين العربية والإسلامية. ولقد يفهم أن تكون المنظومة الدينية ومدونة أحكامها من مصادر التشريع؛ لكن ذلك شيء بينما وسم دولة بدين ما شيء آخر مختلف تماماً.
قلنا إن الحديث عن «دين الدولة» حديث مجاز؛ لأن الدين مستغن عن الدولة، في وجوده والقيام والاستمرار، والدولة غير مشروط وجودها به. ووجه المجازية في القول إنما هو في أن الدولة هي، حكماً، المجتمع بشكل منظم. ولما كان للمجتمع دين يدين به أو يعتنقه؛ ولما كانت المجتمعات حواضن للديانات، ووحدها توصف بأنها متدينة أو غير متدينة، شمل الوصف الدولة بما هي الإطار الكياني المعبر عن المجتمع. هكذا أتت الدساتير تتجوز في القول إن «دين الدولة» كذا، في مجازية تبغي به (القول) التشديد على الانتماء الديني لمواطنيها أو للأكثر منهم. وهي، بالمناسبة، مجازية لا تقبل الاستخدام في نص حساس كالدستور؛ لأنها تستجر عليها تبعات مستعوصة هي في غنى عنها لو احترمت لغة الصرامة الدستورية. والمشكلة في هذا الإقرار المجازي أنه إذ يتولد، في الغالب، من محاولة مداهنة الشعور الجمعي الديني للمؤمنين/ المواطنين، وسد الثغر أمام محاولات المعارضات «الدينية» مناكفة نظام الحكم المدني، ورجمه بتهم الانشقاق عن عقيدة الشعب والجماعة، ينتهي إلى وضع نفسه موضع نقض - غير مقصود- لمنطق الدولة الحديثة! والأنكى من ذلك أنه إقرار (مجازي) يزود خصوم النظام المدني الحديث ب «ورقة» لعب اعتراضية يحاكم بها النظام ذاك في مدى التزامه بمقتضيات نصه الدستوري على أن دين الدولة هو كذا (الإسلام في حالة مجتمعاتنا). وما أكثر ما استخدم ذلك كسلاح من أسلحة الاحتجاج السياسي من قبل جماعات «الإسلام الحركي»!
ولأن ولاية الدولة على المجتمع تشمل ولايتها على كل ما يدخل في تكوين علاقات الاجتماع الوطني؛ ولما كان الدين في جملة ما يدخل في ذلك التكوين، «كتب» على الدولة ألّا تعرض عن الدين أو أن تكون عنه بمعزل؛ بل حملت على أن تأتمن عليه ائتمانها على السيادة والثروة والأمن الاجتماعي، بحسبان ذلك من مشمولات عملها، كدولة، ومن ألزم وظائفها لإدارة الاجتماع الوطني. ولا يعني ائتمان الدولة على الدين استدماجه في النظام السياسي مصدراً من مصادر السلطة أو أساساً من أسس الشرعية، وإنما حمايته من أي أنواع الاستغلال السياسي له من قبل قوى المجتمع. وبالجملة، ليس للدولة - القائم سلطاتها على نظام الحكم المدني- غير أن تحتكر الحق في الإشراف على المجال الديني وإدارة مؤسساته بحسبانه واحداً من المجالات الاجتماعية، التي تقع تحت ولايتها؛ بل وأن تحتكر الحق في التفسير الرسمي للتعاليم والنصوص باعتبارها الجهة المخولة بإصدار القوانين. أما مسوغات هذا الحق الحصري للدولة فثلاثة على الأقل:
أولها، أن للدولة مسؤولية تجاه الشعب أو الأمة التي تعبر عن إرادتهما، ويقع في قلب المسؤولية تلك حماية حقوقها في ما تملكه ويعود إليها؛ والدين، مثله مثل الملكية والحرية والثروة والسيادة، في جملة الحقوق الجمعية التي على الدولة صونها، ووضعها تحت الإشراف القانوني.
وثانيها، أن حق الدولة في الإشراف على الشأن الديني إنما هو ينبع من أن للدين وجهاً خارجياً يمس الجماعة (الوطنية)، ويؤثر في العلاقات العامة، وقد يمتد تأثيره إلى الاستقرار السياسي والسلم المدني.
أما ثالثها، فلأن احتكار الدولة الإشراف على المجال الديني ومؤسساته، وحيازة الحق الحصري في تأويل النص الديني، يوفر ضمانة سياسية؛ لعدم التلاعب بالدين، من طرف الجماعات المختلفة، التي تستثمره كرأسمال في صراعها من أجل السلطة، وتقوده - بذلك الاستثمار- إلى الصيرورة وقوداً لتغذية المنازعات الداخلية التي، عادة ما، تنتهي إلى المس بالاستقرار العام وتوليد عوامل الفتنة والحرب الأهلية. وهكذا ينتهي احتكار الدولة الدين، عملياً، إلى تحييده في الصراعات الاجتماعية، أو النأي به عنها؛ وهو التحييد الذي يحفظ له حرمته كعقيدة جامعة وكمبدأ للوحدة، بمثل ما يحفظ للدولة استقرارها وللمجتمع وحدته الوطنية وسلمه المدني.