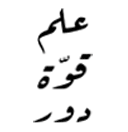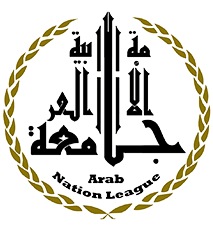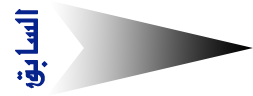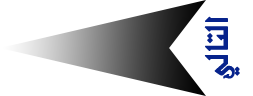كانت الشدائد وما زالت تدفع الأفراد والجماعات والشعوب والأمم إلى الإبداع في وسائل المقاومة والدفاع لترسيخ البقاء ودرء الخطر وإثبات الذات والمحافظة على الهوية والحقوق والمصالح ومقومات الحياة.
ـ 1 ـ
وفي ظل الشدائد بحث العرب عما يعصمهم ويدفع عنهم الأخطار فوجدوا في القومية العربية والدعوة إلى الوحدة غاية ووسيلة ومعتصَماً، فكان ذلك رأس أهدافهم في مرحلة من تاريخهم الحديث؛ وراحت طلائعهم تدعو إلى العمل العربي المشترك الذي يقيم لهم بين الأقوام قواماً ويحفظ لهم شخصية وثقافة ومنزلة، لا سيما في ظل الطغيان العثماني الذي مارس اليهود الدونما دوراً بارزاً في إظهاره وانتشاره، وفي ظل حملة التتريك التي كانت عنواناً للاستبداد والتعصب القومي الطوروني ومقدمة لمحاولات محو الشخصية العربية بدءاً من محاولة محو اللغة العربية.
ويوم تمكن "الماسون" من استقطاب "طورانيين" متعصبين للطورانية خلقتهم حملات استشراق أوروبي ويهودي - صهيوني كانت في خدمة الاستعمار، يوم ذاك تمكَّن اليهود من أمثال رئيس المحفل الماسوني في سالونيك "إيمانويل كراسو"، من أن يصبحوا أعضاء في مجلس "المبعوثان" العثماني بعد عام 1908 وأن يتوصلوا إلى المساهمة في إسقاط أعلى سلطة في السلطنة العثمانية "السلطان عبد الحميد"، حيث سلمه إيمانوئيل كراسو وأسعد باشا توتاني قرار خلعه عن العرش؛ وكان ذلك بالدرجة الأولى ثمناً دفعه السلطان الجائر لرفضه تقديم فلسطين وطناً قومياً لليهود مقابل قيام الصهيونية بتسديد جميع ديون الدولة العثمانية بالليرات الذهبية.
وفي مواجهة هذا المد الطوراني- الماسوني الذي يغذيه اليهود الدونما في الخفاء ويدعمه الاستعمار الغربي في السر والعلن من أجل تمزيق الإمبراطورية العثمانية والسيطرة على تَرِكَة الرجل المريض، نادى رجالات العرب بالقومية العربية وذكروا "الأمة العربية" بمفهوم سياسي محدد واضح موظف لهذا الاستعمال.
وكان المبعوثون العرب، الذين يناضلون مع ممثلي القوميات الأخرى التي تتعرض للاضطهاد الطوراني ـ أو الطوروني ـ في الإمبراطورية العثمانية، يرفعون أصواتهم في مجلس المبعوثان باسم "الأمة العربية" ليدافعوا عن حقوق العرب وهويتهم وحرية وطنهم ووحدة هذا الوطن أرضاً وشعباً، لا يفرِّقون بين مغرب عربي ومشرق عربي، أو بين قطر عربي وآخر، أو بين دين وآخر.. ومذهب وآخر.
وكان أهل الشام، من بين أولئك العرب، سباقين إلى هذه الرؤية القومية وإلى تأكيد ذلك الانتماء وتلك النظرة الشاملة؛ ففي 21/7/1912 قال خالد البرازي مبعوث حماة في مجلس المبعوثان حين كانت قضية طرابلس الغرب مطروحة:
" أيها الأخوان شاع في المحافل أن الصلح سيعقد، ومع أنني واثق بالحكومة، وأمين من وجدان رجالها، فلنفرض أنها استحصلت على فرمان بالاعتراف بإلحاق طرابلس الغرب بإيطاليا، فإنني أقول باسم "الأمة العربية" إننا نمسح هذا الفرمان بدمنا ولا نرضى بذلك، ولو لم يبقَ عربي على وجه الأرض. ".
وتواصل نضال العرب في الإطار القومي ولتحقيق الأهداف العربية فكانت لذلك تجليات ومراحل، وكل منها كانت تنضِج الوعي وتجدد العزيمة، "فالثورة العربية الكبرى" 1916، التي انطلقت مع الرصاصة الأولى من شبه الجزيرة العربية لم تكن إلا تعبيراً صريحاً وعميقاً عن درجة من الوعي القومي ـ الوحدوي، كما لم تكن إلا فعلاً عربياً شبه شامل من أجل التحرر واستعادة المكانة وصنع النهضة لقي دعماً أوربياً ظاهراً بصورة عامة، وأخفي التوظيف الغربي لهذا التوجه والمخطط الاستعماري الصهيوني الذي جسدته اتفاقية سايكس ـ بيكو 1916 إلى أن ظهر لاحقاً بعد أن جاءت النتائج والمواقف والممارسات المخيبة للآمال. وقد دفع العرب من أجل التحرر تضحيات كثيرة ولكنهم وقعوا في شراك الغدر والتآمر التي نصبها الاستعمار الأوربي الذي أراد منذ البداية أن يوظف ثورتهم للمساهمة في إضعاف الإمبراطورية العثمانية وتدميرها من جهة، وتمزيق الرابطة الإسلامية والوطن العربي واحتلاله، وإطلاق وعد بلفور وتنفيذ مشروع الحركة الصهيونية في فلسطين من جهة أخرى.
وقد أدت الأوضاع والظروف المتداخلة إلى ضياع الثورة العربية واحتلال مباشر وغير مباشر للأراضي العربية التي كانت تحت السيطرة العثمانية. ولم يُمِتْ ذلك فكرة الثورة ولا أهدافها ولم يقتل الوعي القومي وأهدافه، بل أخذ يصهر ذلك كله في أتون المقاومة وحروب التحرير والتصدي لمخططات الاستعمار والصهيونية، والتنبه لمسلسلات التآمر البعيدة المدى وحالات الاستلاب وفرض التبعية والاستغلال والتسلل إلى التكوين الثقافي بأشكال مختلفة.
وأصبحت شعارات العروبة والوحدة والحرية والتحرير زاد السالكين في طريق الوعي والمعرفة والسياسة والفكر القومي والتحرر من الاستعمار في وطن العرب. وعلى الرغم من ولادة تنظيمات وأحزاب اتخذت من الدعوة "الوطنية" في ظل الاستعمار وبمواجهته أهدافاً لها، إلا أن ذلك لم يمنع بقاء الفكر القومي مهيمناً ونموه في أوساط اجتماعية قوياً، لم تلبث تلك التنظيمات أن تنبهت إلى ضرورة العمل على مشروعها العربي القديم- الجديد بعد أن سلخ الاستعمار الفرنسي لواء اسكندرون عن سورية عام 1939 و"منحه" لتركيا، وكان قد "منحها" في العشرينات من القرن العشرين ديار بكر وكليكيا ومناطق شاسعة أخرى تمتد من جبال طوروس حتى الحدود الحالية لسورية السياسية، متجاوزاً القوانين الدولة واعتراضات السوريين والعرب، ليرضي تركيا ويكسب ودها من جهة وليشغل سورية بمطلب وطني- قومي في الوقت الذي كان ينفذ فيه مع شركائه الاستعماريين في ظل عصبة الأمم وبتكليف منها مشروع إقامة دولة "إسرائيل" تنفيذاً لوعد بلفور المشؤوم 1917 الذي صدر إثر اتفاقية "سايكس ـ بيكو" 1916.
وفي بداية الأربعينيات من القرن العشرين استعادت الشعارات القومية وهجها النسبي وبدأ الحديث عن الإحياء والنهضة والبعث في ظلال ما شاع من صورة زاهية لثورة 1916 وما أضيف إلى أفكارها ومشروعها من عمق ووعي في إطار شمول قومي عام.
وفي عام 1943 كانت تراود بعض الطلائع العربية أحلام قومية- تحررية وحدوية وتدفعها إلى تلمس طريق ما لتحقيق: الخلاص من الاستعمار، وما تتطلع إليه من تحرر وتقدم وامتلاك قوة تدفع بها العدوان والتآمر المستمرين.
وأخذت الأحداث تنضج ذلك الفكر وتدفعه إلى الوجود الفاعل في أطر وصيغ تنظيمية تكفل له التطور والتحقق والاستقطاب الجماهيري، ولم يكن ذلك الذي قالت به طلائع مناضلة على طريق الوحدة والحرية من أهداف وأفكار مجلوباً إلى أرض العرب، ولا تنظيراً أقحم على حياتهم "فاستهوى" مناضليهم، وإنما كان استلهاماً فعلياً لما يعتلج في النفوس وتلهج به ألسنة الناس ويعتمل في الوجدان العربي ويستدعيه الواقع والظروف وتتطلبه حاجات النهضة والتحرر والبقاء والعدالة والتقدم.
ومع تطور المواجهات ضد الاستعمار، والأحداث في فلسطين، وتصاعد الصراع العربي الصهيوني على الأرض والسيادة ـ بعد أن قرر الاستعمار البريطاني تنفيذ آخر مرحلة من مراحل تهيئة فلسطين لتصبح وطناً قومياً لليهود وتسليمها لهم، تحميها هذه المرة الأمم المتحدة التي ورثت تلك المسؤولية عن عصبة الأمم ـ بدأ إلحاح الحاجة يشتد والضرورة تضغط على المؤمنين بأهمية العمل العربي المشترك وضرورته لإيجاد صيغة تنظيمية ملائمة لمواجهة التحديات المباشرة وغير المباشرة: العسكرية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية، التي لا سبيل إلى مواجهتها إلا بقدرات الأمة مجتمعة، ولمجاوزة الضعف والأمية والتخلف والتجزئة والقيود المفروضة التي أقامها الاستعمار ويعمل على حمايتها وترسيخها. وكان أبرز ما يستدعي ذلك ويفرضه سرعة العمل وضرورته لاستنقاذ فلسطين من اليهود والحيلولة دون قيام "إسرائيل": رأس المشروع الصهيوني –الاستيطاني- التوسعي في المنطقة المرض السرطاني الذي أخذ ينتشر فيها.
وكان أن دفعت الفكرة المستلهَمة من حياة الجماهير وتطلعها ومعاناتها، فكرة الأمة الواحدة التي يعمل كل أبنائها لخير كل أقطارها، إلى تشكيل تنظيم قومي، فكان أن ولد تنظيم البعث على أرضية ذلك الحلم القومي العربي الكبير وفي ظلاله، ولم يكن التنظيم الوحيد في هذا الاتجاه فحركة القوميين العرب والحزب السوري الاجتماعي في دائرة أضيق وسواهما نشأت في المناخ ذاته تقريباً، وكان في صلب ولادة الحزب شيء كثير من تراث الثورة العربية الكبرى ونضال العرب قبلها وبعدها من أجل بعث مجد الأمة وتحرير أرضها والنهوض بها واستعادة مكانتها. وهكذا تداخلت الأهداف والرموز وتنافرت أحياناً ولكنها كانت تتسابق لتخدم هدفاً مشتركاً، وصار علم الثورة العربية الكبرى علماً للبعث وعلماً لفلسطين، ووجدان الجماهير الشعبية العامر بتلك المشاعر والأفكار وتاريخها البعيد والقريب يتوهج ويدفعها إلى النضال، وأفقها الرحب الذي أغناه الوعي والفكر والعمل طوال عقود قاسية صار أفقاً عاماً للمرحلة.
ـ 2 ـ
ويجوز لنا أن نتساءل اليوم، بعد الذي جرى ويجري في هذا الزمن العربي الرديء.. بعد الاحتلال المباشر وتصاعد المد العدواني للكيان الصهيون، وإعلان العملاء المتعاونين مع الاستعمار والصهيونية ضد بلدانهم وشعوبهم والقيم القومية والمواطنية في أبسط تعاريفها وتجلياتها.. وبعد أن أصبح العربي متخاذلاً يخشى أن يدفع الأذى عنه، ولا يقف بوجه من يلاحقونه بأشكال الإذلال والعدوان والاستفزاز في أرضه التاريخية خوفاً من استعداء الهمجية الأميركية التي تقف بالمرصاد للعروبة والإسلام موظفة عملاءها وغباء بعض من يرى فيها قوة " منقذة، ومن تستخدمهم مخلب قط ضد أهلهم وأحلامهم وأوطانهم وشعبهم لخدمة استراتيجياتها التي نجحت في تدمير العراق وزرع الفوضى وانعدام الأمن والأمان في ربوعه ، يجوز لنا أن نتساءل:
هل القومية العربية وما انبثق عنها وبُني عليها واشتُقّ منها وأوحت به وعمَّق إيحاءاتها من فكر قومي ومشاعر شعبية وتوجهات نظرية وتنظير وتنظيم وعمل ونضال، هل كانت مجرد وهم نمّيناه وابتلعناه فتورّم في أعماقنا وأصبحنا بسبب من ذلك خارج حدود التاريخ ومعطى الواقعية بتياراتها ومذاهبها ومنطقها كما يحاول أن يشيع أصحاب العداء المقيم للعروبة والوحدة والإسلام؟!.
وهل هي مشروع مستورد كما كانت تقول تنظيمات حزبية في الأربعينيات والخمسينيات من هذا القرن، وهو ما يتردد في هذا العقد من القرن الحادي والعشرين على ألسنة بعض السياسيين المعارضين لفكرة القومية العربية وللتنظيمات التي بنيت عليها أو استلهمتها ـ مشروع صدَّره الإنكليز ولا يقولون استغله الإنكليز ـ أم أنها نبت أصيل في أرض الأمة وتربتها الوجدانية والثقافية تعود جذوره إلى تاريخ أبعد من تاريخ أية أمة من الأمم؟! وهل التطلع الوحدوي العربي الذي يعتبر أهم أقانيم الفكر القومي والعمل القومي وأبرز أهدافهما هو خرافة ونوع من أساطير تُبنى عليها سياسات أو تتقنع بها سياسات، في حين لا تمتد لذلك التطلع أية جذور في الواقع المعيش بَلْه في النفوس وفي التاريخ القريب والبعيد، ولم يكرَّس بقاء لتلك الجذور عندما تحقق له بعض الوجود التنظيمي والرسمي؟!
هل القومية تنفي الدين وتتعارض معه، وهل الدين ينفي القومية ويرى فيها بالضرورة نوعاً من عصبية مرفوضة تقف في وجه تسامحه وأمميته واتساع مداه الإنساني الشامل؟!
في علاقة القومية العربية بالدين عامة وبالإسلام خاصة هناك تكامل تام وعلاقة عضوية، فلا هوية ولا شخصية للعروبة بقيمها ومقوماتها إذا ما استلب منها الإسلام أو ابتعدت عنه أو تضادت معه، وروح الجماهير التي تعمل العروبة من أجلها وتتعامل مع منظومات قيمها ومشاعرها العميقة مستمدة في معظمها من الإسلام ومنسجمة معه، وأي وضع للعروبة في مقابل الإسلام أو للإسلام في مقابل العروبة يضعف كلاً منهما. والإسلام الذي ساهم في تكوين الشخصية القومية وأكدها ولم يتعارض إلا مع التعصب المقيت، رفع مفهوم الانتماء القومي فوق علاقة الدم واللحم ليكون معطى معرفياً ثقافياً إنسانياً رفيعاً محكوماً بمنظومات العقيدة وقيمها ومرجعياتها وروحها الإنساني العميق، وتأكد ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح:
" أيها الناس إن الرب واحد والأب واحد، ليست العربية من أحدكم بأب ولا أم؛ العربية لسان، فمن تكلم العربية فهو عربي.". وعلينا أن نذهب في فهم مغزى هذا الحديث إلى أبعاد: منها مكانة اللغة العربية بما ورثت وما حملت عبر الزمن في كل من معطى العروبة والإسلام حضارياً وعقائدياً، لا سيما القرآن، لندرك المغزى العميق للعلاقة والأبعاد المستمرة للرؤية المعرفية الإنسانية المتسامية التي نحتاج إلى تعميقها وتجسيدها.
ومن هنا يطرح السؤال: هل القومية العربية نوعٌ من " شوفينية" ظاهرة أو با طنة، فاعلة أو كامنة، يرى فيها أعداء التعصب " نظرياً " ومن يمارسونه على أسوأ صوره عملياً ويتهمون الآخرين فوق ذلك بممارسته، هل القومية العربية تشكل خطراً على الآخرين وتقدم نزوعاً مؤذياً يؤدي إلى تصاعد المشكلات والنزاعات والحروب ؟!
إن هذا يستدعي فتح ملفات ضخمة تتصل بالحروب ومشعليها، والقوميات وأصالتها ونزوعاتها المَرَضيّة والصحيّة وما لها وما عليها، والتعصب وتاريخه ودعاته وممارساته وأسبابه وتوظيفاته، كما يستدعي الخوض في حوار واسع وتحليل نقدي موضوعي مسؤول حول القوميات بشكل عام ومواجهة عللها بوجه خاص ومقاربة السؤال: هل يجب القضاء عليها؟ وهل يمكن ذلك أصلاً؟ هل هو إنساني وحضاري وضروري لحل أزمات ومشكلات في طليعتها قضايا التنمية والأمن والبيئة والصحة وتأمين الاحتياجات الضرورية للبشر، أم أن المستحسن أن تقوم بينها جسور ثقافية ومعرفية وعلاقات مبنية على الاحترام والتفاهم والتعاون والاعتماد المتبادل والثقة والمصالح المتبادلة ليزيل التعارفُ والمعرفة حقد الجهل وجهل الحقد، ولتتأكد هوَّيات روحية ومعايير قيمية للقوميات لا تجعلها تسلطاً عرقياً وادعاء مريضاً بتعال فارغ من كل مضمون، وجشعاً مادياً وقسوة سلطة وهيمنة من أي نوع، وادعاء مضحكاً بتكليف إلهي لفئة يجعلها فوق الناس، أو بنقاء عرق ودم يكسب أصحابه سطوة ويرفعهم فوق الناس درجة.. أو ساحة لادعاء المظلومية بهدف استعداء الآخرين على قومية أخرى.
وفي مسارات الأسئلة النابتة على هذا الجذع نقول:
هل العرب أمة حسب المعايير التي وضعها المنظرون لوجود الأمم وتطورها وحضورها الفاعل في التاريخ، أم أنهم ما زالوا بنظر من لا ترضيهم القومية العربية بالذات، ومن عادوها كل هذه السنوات: "مشروع أمة ومشروع قومية ومشروع هوية ومشروع حضارة.."؟! على الرغم من توافر المقومات جميعاً ورسوخها منذ زمن طويل جداً في التكوين الثقافي والاجتماعي والتاريخي العام للشعب العربي وفي تمايزه الحضاري وخصوصيته الثقافية وإضافاته التي لا ينكرها سوى جاحد أو جاهل للحضارة البشرية!؟! ومن أسف أنه حتى في مجال التطبيق العلمي للمعايير المعرفية تبدو ازدواجيتها ظاهرة ومتطرفة وفجة في معاداتها للعرب حتى من بعض أبناء الأمة العربية الذين اتبعوا مدارس الغرب الفكرية وابتلعتهم مركزيته الثقافية وأصبحوا أبواقاً لأحزاب وأيديولوجيات وسياسات بأسماء وذرائع شتى، وتحت شعارات تمتد من التقدم والاشتراكية إلى الرأسمالية والإمبريالية؟!.
وهل " التشنج" القومي هو السبب في رفض عرب اليوم دخول أبواب
"سلام اليوم" الذي يقدمه للمنطقة: الصهيوني والمتصهين والعميل والمتخاذل والإمبريالي الذي يرقِّط جلده بوشم الشعارات الإنسانية ويلغو بحقوق الإنسان والحريات العامة والديموقراطية وهو يزري بها ويزني بها في كل آن وتشير أفعاله إلى حقيقة أنه سُبُّتها في كل زمان ومكان.. وأنه الهمجية التي لا تدرك أبعاد تخلفها الروحي والخلقي ومقدار خطورتها على الأمن والسلام والعلاقات الصحية بين الدول والشعوب والثقافات والحضارات؟!
وهل التنظيمات القومية والقومية العربية لا تقوم إلا على أسس علمانية، وعلى نفي الدين والتنازع مع الإسلام: فإما هي وإما هو؟! وأنها لا يمكن أن تكون تقدمية وعصرية ومرضيَّاً عنها إلا إذا زوّرت هويتها وأهدافها، وتنازلت عن ثوابتها وحقوقها التاريخية وأرضها، وغيرت ثقافتها وقيمها وعقيدتها، وزورت تاريخها وشوهت بنية مجتمعاتها، وارتدت ثوباً مفصَّلاً على الطريقة اليهودية لحل مشكلة مجتمعية: اقتصادية وسياسية أو لخلق مشكلات لكل المجتمعات تعيشها وتعاني منها وتبقى في أسرها وتدفن مستقبلها ومستقبل أجيالها فيها ليفرَغ اليهودي لمشروعه الصهيوني وعبثه بقوميات الآخرين وثقافتهم وعقائدهم ومقدساتهم، وليتفرَغ محتكر النفط وتاجر السلاح والحروب والدم إلى احتكاره وتجارته وجشعه الكريه وهيمنته العنصرية على الآخرين؟!
إن مفهوم العلمانية في هذا المجال يحتاج إلى تمحيص وتدقيق، فمن يريد أن يقدم إلحاده في ثوب العلمانية وينفي حق المؤمنين والمعتقدين بإله في أن يمارسوا حرية الاعتقاد والعبادة والتفكير والتعبير والتدبير، يستطيع أن يحوّر ما يشاء وأن يقدم مفهومه كما يشاء، ولكنه لا يستطيع محو الإيمان من قلوب المؤمنين ولا يستطيع أن يقيم صرحاً وطنياً أو قومياً وحدوياً من أي نوع مع كثرة يرفض توجهها العام وحقائق معتقداتها وطبيعة تكوينها، وهو عندما يتوجه نحو ذلك ويضع نفسه على المحك سيجد أنه عاجز تماماً عن الوصول إلى الهدف أو عن إقناع الناس به، وأعجز عن إثبات أن المتدين لا يخدم العروبة والوحدة والحرية والتحرير مثلما ـ أو أكثر مما ـ يخدمها هو، وأنه أحوج ما يكون إلى علمانية مؤمنة، إن صح التعبير، لا تحارب معتقدات الأفراد الدينية، ولا تزدريها تحت قناع "التقدمية الإلحادية الشامخة الأنف في فراغ مذهل مخيف". ولا يستطيع أحد الادعاء بأن تاريخ المصطلح ومنطقه يتعارضان مع الدين، أي دين، ومع الإيمان والاعتقاد، وإنما يجعلان حاكمية ذلك لله وليس لسلطة بني البشر من خلال إمساكها بالسلطة الزمنية واستخدامها استخداماً تعسفياً ضد الناس أو لإجبارهم على الدخول في قفص مصنَّع.
ومن المفيد الوضوح التام في هذا المجال فالمناسب أن نأخذ بالعلمانية المؤمنة ونرفض العلمانية غطاء للإلحاد، أو لنشر الإحاد والدعاوة له، أو مدخلاً له ومظلة لجرح مشاعر المؤمنين الذين ندعوهم للوحدة و"نقودهم" للتقدم والحرية والتحرير، أو وسيلة لإلغاء دين الأكثرية أو تهميشه بأشكال من الأداء غدت نتائجها معروفة جيداً وأدت إلى ولادة تعصب بذريعة الدفاع عن المعتقد ضد من يقفون ضده باسم علمانية لا يطبقونها أو لا يطيقونها أو يلغمونها ويفترضون في الناس الغباء. ونرفض العلمانية ذريعة لتدمير الأخلاق والعقيدة والقيم من طرف أكثرية أو أقليات أو ملحدين هنا وهناك، أو من طرف غزو ثقافي خارجي وأجهزة ودول وقوى أجنبية تتسلل إلى معقل الوحدة الوطنية وصميم الوطن من خلال أقليات لا تؤمن بالمواطنة والوطن والديمقراطية الحقة وتروج بضائع سياسية مسمومة هي مدخل الإمبريالية المعاصرة للتدخل في شؤون الآخرين وتخريب مجتمعاتهم.
ونرفض أن تجتاح الأكثرية تحت أية ذريعة أو سبب حقوق الأقليات التي يصونها الدستور ويكفلها القانون فتقضي عليها.. إنه طغيان الأكثرية المرفوض الذي يدخل في باب التعصب ويثير العصبية والتعصب. إن الديمقراطية التي تصنعها أكثرية تحافظ على حق المواطن في الوطن وتحترم حقوقه وحرياته وخصوصيته في إطار القانون وليس على حسابه أو على حساب المواطنة هي المطلوبة والمقبولة والمشروعة وما ينبغي التمسك به والدفاع عنه والعمل على تطبيقه.
ـ 3 ـ
وبعد، هل أفلست القومية العربية وعليها أن تلملم أوراقها وتنسحب خارج التاريخ والحاضر لأنها حكمت على مستقبلها بالموت من وجهة نظر من يطرح هذه المقولات بتلك الصيغ من السرد والفهم والحكم، وذلك بعد أن تحمّل نفسها مسؤولية كل ما حدث للأمة العربية خلال القرن العشرين الذي لفظ أنفاسه والقرن الوليد الذي بدأ التنفس؛ وأنّ على التيار القومي بكل تشعباته وفروعه واجتهاداته وتناحراته أن يخلي الساحة لسواه بعد أن يعلن إدانة نفسه، وعليه من بعد أن يكتفي من الغنيمة بالإياب ويخسر الحاضر والمستقبل ويبوء بوصمة تاريخية من نوع ما ويقعد مذموماً مدحورا؟.
وهل أفلست أطروحات ذلك التيار ونظرياته وشعاراته، ووصل إلى درجة من الجمود لا تجدي معها المراجعة ونقد الذات وتصحيح المسارات ومرونة التحرك، أم أنه ما زال قادراً على أن يرى ما له وما عليه، وما زال حضوره في ساحة العمل والنضال أساسياً، إن لم نقل هو الأساس، لتحقيق أهداف الأمة والدفاع عن وجودها، وأن مساحة المستقبل مفتوحة أمامه ولكن وصوله إلى حالة من الأداء المقبول المطلوب تحتاج إلى وقفة شجاعة ودقيقة وموضوعية مع الذات يمارس فيها النقد الذاتي على الخصوص ويخرج بعدها أكثر تعافياً وحيوية وأشد تواصلاً مع أصوله وركائزه وثوابته التي حاولت تنظيمات وتيارات أخرى أن تشوهها وتهزها وأن تخترقها وتدخل من خلالها إلى بنية أمة لا يمكنها أن تقبل التهجين الممرِض، والدخيل المدمر، والرافض أو الناقض لمنظومات قيمها وأصالتها وحقوقها وعقيدتها ومعطى هويتها وتاريخها الحضاري العريق، ذلك الذي يرمي إلى نفي وعيها وتفتيت تماسكها والتشكيك بقدراتها لنقض بنيانها من الداخل ومن ثم الانقضاض على حقوقها وقيمها ووجودها ذاته ومقومات ذلك الوجود؟!.
أسئلة نطرحها ونحن بمواجهة التهديد الأميركي الصهيوني وأعوانه والمرتبطين به، ذلك الذي دمر أفغانستان والعراق واحتلهما، وفتك بالشعب الفلسطيني وما زال يفتك به أمام نظر العالم وسمعه، ويهدد سورية ويحرك أدواته لزعزعة استقرارها وجعلها تنقض موقفها ويعمد إلى تهديدها وإرهابها لتخضع وتنفذ كل ما يريد، ويتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية وإسلامية ويهدد بمزيد من التدخل المباشر وغير المباشر في شؤونها ليفرض عليها رؤيته وثقافته ومصالحه ومناهجه وما يريد أن يراها عليه.
إننا نعيش في خضم زمن عداء لقوميتنا وديننا.. للعروبة والإسلام معاً، عداء لا يفرق بين عربي ومسلم، وندخل عقد تنافر عربي كبير وخطير تجلت بعض مظاهره وظواهره في التملص من المسؤولية عن الانتفاضة وقضية فلسطين وفي الابتعاد عن قومية المعركة في كل مجال، والتقرب من عدو الأمة في كل حال ومشاركته في العدوان عليها وتسهيل مهام من يعتدي على أي قطر من أقطارها على مجمل مصالحها ويمكنه من تحقيق اختراقات في كل مجال يريد اختراقه.. نعيش وضعاً يطرح علينا أسئلة مرة في مسار وقائع أشد مرارة بعد انقضاء خمسة وخمسين عاماً على تأسيس تنظيمات قومية توجهت نحو استلهام حس الجماهير العربية وحاجتها ونادت بتجسيد تطلعاتها ورفعت شعاراتها، ولم يلبث أن انتشر فكرها وحضورها في أنحاء الوطن العربي، وعياً قومياً، ومقاومة للاستعمار والصهيونية، ودعوة لتحرير فلسطين من الاحتلال، وتوجهاً للوحدة بغية الوصول إلى القوة والحرية للوطن والإنسان، وتحرير للقرار السياسي والإرادة القومية، والتأسيس للتقدم والنهضة والعدالة الاجتماعية؛ تنظيمات قومية أو تيارات قومية تعدّ وريثاً واستمراراً بشكل ما لتوجهات قومية سابقة تصدت لحملات التتريك وقاومت الاستعمار والاستيطان ومحاولات إذابة الشخصية العربية وتهجينها وحققت التحرير، ونادت بوحدة الأرض والشعب العربي من المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى طوروس، ولم يكن ذلك مجرد مصادفة أو اندفاعات انفعالية وحماسة عاطفية عابرة وإنما كان رؤية ذات بعد تاريخي عريق ودفع واقعي وتطلعات مستقبلية متكاملة للخلاص والتقدم وامتلاك القوة المنقذة. ولكنها للأسف عند التطبيق لم تستطع أن تحافظ على وحدة بين قطرين ولم تجمع بين بلدين على مبدأ عقائدي واحد؟! ووصلت بنا أو وصلنا وإياها إلى وضع لا يطاق ولا يحسد أحد عليه. ومن الضروري والحال هذا تقصي الأسباب والمراجعة الدقيقة لكل ذلك وليس التنصل من الهدف والتاريخ والمبدأ والتماس الأسباب والذرائع للقيام به. مما يستوجب طرح السؤال للبحث عن بواطنه بمسؤولية وعمق: هل أفلس الفكر القومي والطرح القومي والتيار القومي؟! وهل العصر تجاوز القوميات.. أم يراد له أن يتجاوز القومية العربية فقط من بينها ويسمح لقوميات ميتة بالحياة على حسابها؟! وهل عدم توصل دعاة الفكر القومي إلى أهدافه ناتج عن النظرية أو عن الممارسة أو عن حجم العداء لهذا النوع من التوجه، أم لوضع العروبة في مقابل الإسلام نتيجة تدخل جراثيم الفساد الأيديولوجي في تيارات الفكر القومي لتخرب من الداخل فوجدت حقلاً خصباً ومناخاً ملائماً مما أدى إلى ضعف عام؟! أم لغياب التنظيم في ظلال الأشخاص وغياب الديموقراطية في ظلال الديكتاتورية، وسيطرة الوصولية والانتهازية والديماغوجية على بعض مفاصل التنظيم والتفكير وصنع القرار في كثير من التنظيمات القومية لا سيما تلك التي وصلت إلى الحكم واستقرت فيه طويلاً وحاولت جماعات وأقليات السيطرة على الحكم وجعله يدور في أفق ضيق يقل عن القطر ويناوئ الرؤية القومية ويتضاد معها، فتشكل بذلك مانع عملي قوي بين التواصل القومي والعمل القومي والنضال القومي والتطلعات في الوقت ذاته.؟!
وطرح هذه الأسئلة يرمي إلى التحريض على التفكير في الواقع والأهداف والأوضاع والحالة العامة التي يعيشها الوطن العربي وتعيشها قضية فلسطين وشعبها، وتعيشها أقطار تحت الاحتلال وأخرى محتل منها الإرادة والقرار.. أوضاع تعيشها التيارات الفكرية والسياسية الرئيسة فيه من جهة، والتعامل مع ما تقدمه المتغيرات في وطن العرب والعالم من معطيات ذات تأثير وحضور من جهة أخرى، لتتم مقاربة الأجوبة وتلمّسها في ضوء ما يُطرح على هذا التيار من قضايا وأسئلة وتحديات وما يخوضه من صراعات داخلية وخارجية وما يواجهه من قوى الاحتلال ومؤامرات حلفائه وحماته وأعوانه وعملائه، مواجهة ذلك في إطار من الموضوعية والروح العلمية والواقعية العملية التفاؤلية والمسؤولية القومية.. مقاربة تضع كل أمر وكل شخص في موقعه الصحيح لا سيما في الوضع العربي الراهن الذي ينبغي أن يكون مقروءاً ومستقرءاً بوعي وعمق وشمول في ضوء وقائع تاريخنا وتاريخ الأمم والشعوب وما نتعرض له من مخططات وهجمات ومشاريع ذات أهداف عدوانية شمولية على رأسها المشروع الصهيوني الأميركي المسمى " الشرق الأوسط الكبير".
ـ 4 ـ
يبدو من شبه المؤكد أنه ما من نظرية توضع موضع التطبيق، إلا وتصاب بشروخ أو تظهر شروخها وعللها الكامنة فيها أصلاً قبل أن تُعْرَض على التطبيق. وما من شعار يُدفع إلى ساحة التنفيذ إلا وتظهر هوة بينه وبين الممارسة المؤدية إلى إنجازه، لأسباب عدة تتصل: إما بسلامة الفكر والرأي والرؤية والأفق الاستراتيجي الذي يبلغه، أو بالعنصر البشري القادر على التمثّل والأداء وترجمة المطلوب إلى ملموس منجز، أو بسبب الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة ودرجة النضج والاستعداد البشريين، وما قد يعترض ذلك من معوقات وتحديات خارجية وما ينصَب له من شراك، أو بسبب عدم توظيف الأداء والإمكانيات والإنجاز والتجارب في إطار تراكم واع للخبرة والأداء وعرض ذلك دورياً على العقل النقدي في ضوء التقدم أو التأخر عن تحقيق الهدف المنشود أو قطع خطوات على طريق تحقيقه ضمن برنامج زمني يحترم بدقة تامة.
وهذا الذي ينطبق على معظم إن لم نقل على النظريات والشعارات كلها في البلدان والأزمان المختلفة ينطبق على الفكر القومي والعمل القومي العربيين. فليس بدعاً ولا غريباً أن نلمس فجوات ونستشعر نواقص، وتنهض في وجهنا صعوبات وتحديات، وأن يقال لنا: هناك تقصير وعيوب وأخطاء وممارسات مؤسفة، الخ.. وأن نطالب بمراجعة وتصحيح وإصلاح من خلال ممارسة النقد والنقد الذاتي، ومحاسبة المقصرين والفاسدين والمفسدين، ووضع الكفاءة الملائمة في موقعها ومساعدتها على خلق مناخ العمل والإنتاج والإبداع، والتخلص من الأمراض بمجرد ظهور أعراضها. ولكن محاولة النفي للأصل والمشكلات النابتة عليه جملة وتفصيلاً، وجعل الفكرة القومية ذاتها موضع الشك وموطن الوهم وسبب الخلل والعجز، ونفي مقومات الأمة ومعطيات القومية عن العرب وعن التوجه القومي الذي يتخذه تيار كبير منهم، مستلهماً وجدان الشعب كله ومعطى تاريخه العريق وتطلعه العام، ومطالبة القومية بالتنحي عن موقعها بعد اتهامها واتهام كل من نادى بها وأخذ بفكرتها، هو الغريب المستغرب الذي لا يمكن أن يسوّغ على أرضية مقبولة معقولة نظيفة ومبرأة تماماً من العلل والخلل.
وفي موسم من مواسم العبث بالمقدرات والأهداف والشعارات والقيم والمصطلحات نبيح لأنفسنا دخول حرم سؤال ما كان ليسأل لولا متغيرات عمَّقها هذا الزمان، ومحن عم خطبها وطم حتى شغلت كل مكان من وطننا وطرقت مسامع سكان أي مكان في العالم، ومستجدات في مدار الحدث والحوار والاحتمالات قد تتمخض عن شيء كبير، أخذت تطفو على ثبج الكلام، نقدم مسوغاتنا بين يديه هو سؤال: "الوحدة العربية" هل هي أسطورة، أم خرافة صنو العنقاء والخل الوفي، كانت حلم أقوام نبتوا في مرابع الوهم وتغدوا في مراتعه حتى تورموا.. وكانوا أكثر مثالية وطوباوية من: أفلاطون وماركس معاً؟!.
هل كانت الوحدة في زمن ما حلما مشروعاً، وإمكانية قابلة للتداول وأصبحت اليوم غير ذات شأن وغير ذات معنى بعد الذي استجد في ساحات العرب الجغرافية والسياسية والنفسية؟! أم تراها كانت وما زالت هدفاً مشروعاً، وحلماً ممكناً، ومنهجاً واقعياً يمكن التفكير في اتباعه والعمل على تحقيقه بوسائل وعزمات تختلف عن السابق الذي أوصلنا إلى طرح السؤال.
حتى في ظل الإجهاضات الوحدوية السابقة، والإحباطات التي لحقت بالروح المعنوية للوحدويين، بعد أن أصيبت التجارب والشعارات القومية إصابات مباشرة في الصميم من جراء الانفصال وضمور التضامن وتضاد الجهود وإفلاس الأداء في أزمات الخليج وحروبه وما أعقب الأزمات والحروب، وفي قضية فلسطين وفي لبنان وغير ذلك كثير؟!
هل الوحدة العربية ما زالت رصيداً جماهيرياً قابلاً للتداول يفيد الأحزاب والساسة والمثقفين المنتمين إلى أحزاب وسياسات، ويشكل ركناً من أركان مبدئيتهم، أم أن عليهم أن يعلنوا إفلاس هذا الرصيد تماماً.؟!
هناك أصوات عربية ترتفع مناديه باعتماد المصالح القطرية في الوطن العربي أساساً للسياسة القطرية، وتعلن أن مصالح الدول فوق مصالح الأمة، وتعرب عن اعتقاد مكلل باليقين التام، بأن المصالح التي تعلن عن صيانتها يمكن أن تحمى كلياً بالاعتماد على الصلات الدولية ومجلس الأمن، والقوة القطرية، وأن أي مناداة بأن العرب لن يحققوا مصالحهم إلا في إطار الوحدة العربية هي من قبيل السعي إلى تلبية رغبات وتحقيق مصالح تحت ستر قومية وشعارات وحدوية متهافتة.
وهناك أصوات عربية تعلن إفلاس الجامعة العربية، والشعارات القومية وتطالب بالبحث عن المصالح المؤمَّنة للبلدان سواء أكان ذلك بالتعاون مع بلدان عربية أو غير عربية دون التزامات أخلاقية أو قومية من أي نوع، طارحة في السوق البضاعة "البراغماتية" وحدها بكل وضوح ولو كان ذلك على حساب الأمة كلها.
وهناك أصوات تعلن أن التضامن العربي- على الأقل- وليس الوحدة أمر لا معدى عنه، إذا أراد أي عربي مسؤول أن يحافظ على حد أدنى من الأهداف والمصالح، ويحفظ الحد الأدنى من مقومات الأمن والوجود العربيين. ويقول أصحاب تلك الأصوات بضرورة إعادة النظر بأساليب العمل العربي والتعاون والتضامن العربيين، في ضوء المستجدات الدولية ونتائج حرب الخليج، والصراعات الرئيسية التي تخوضها الأمة العربية مع العدو الصهيوني وما ينبغي أن تخوضه ضد المحتل الأميركي.
وهناك فريق "الحالمين" الذين ما زالت لهم أصوات تنادي بالوحدة والعمل من أجل تحقيقها، وإن كانوا أسقطوا من حسابهم -فيما أظن- مقولة أو نظرية "القطر القاعدة" الذي يلجأ إلى الوحدة بالقوة والضم إن اقتضى الأمر بعد أن تبين لهم وجود قوة دولية ذات أنياب وأظافر تظهرها في أماكن وحالات وأزمنة وأزمات.. وتخفيها إذا تطلبت مصالحها ذلك. ولأنهم يعرفون أن الوحدة العربية أمر "ممنوع" التحقق لاعتبارات "وقرارات" أجنبية وعربية في بعض الحالات فإنهم استجابوا لنداء "العقل" بعد أن نطحوا "الحِنْت" أو نطحهم فشج أحلامهم قبل رؤوسهم.
ورغم هذا الذي في الساحة العربية، يبقى سؤال الوحدة العربية" في ضمائر الناس -على الأقل في مثل هذه المواسم والأزمات القومية والوطنية- من الأسئلة التي تحتاج إلى مواجهة موضوعية وواقعية ومسؤولية في إطار رؤية شاملة واستشراف للمستقبل لا ينفع معه التعجل ولا يشفع فيه التنصل.
لا مجادلة في حقيقة أن "الوحدة العربية" هدف قومي بعيد وطموح عربي مشروع وقد كان هذا الهدف وذلك الطموح، حتى زمن قريب جداً من الأهداف التي لا يجاهر حاكم عربي بمعاداتها ولا يقول مثقف عربي بسقوطها، أو هما لا يفعلان ذلك علانية على الأقل، أما اليوم فقد صار ذلك ديدناً للبعض أو "شعاراً" لهم وصار الإعلان عن "سقوطه" باتهامه، مما يجهر به ويعد من الواقعية والعقلانية، وأخذ الكلام في الوحدة معنى "الأسطورة" والخرافة وما شابه ذلك، وأصبحت أفضل طموحات الساسة والمثقفين العرب تتعلق "بتضامن" عربي يحقق الحد الأدنى من الوفاق للحفاظ على الحد الأدنى من المصالح وثبات المواقف، ومواجهة الصراعات والمستجدات.
وإذا أردنا أن نمتحن الواقع العربي وتوجهات سياساته فما علينا إلا أن نقرأ توجهات إعلامه ومقولات ذلك الإعلام اليومية، وما يعبر عنه من سياسة ومبدئية ثابتة في التحرك العام، ونحن واجدون ببساطة وسهولة من يقول: بأن أي تحرك وحدوي عربي في شرق المتوسط يشكل خطورة على مصالحي، وواجدون من يقول بأن سلطة الشعار القومي أسقطت قدرة العرب على حل " القضية" وأية "قضية" بإجماع وحسم، ويضربون مثلاً قضية "الكويت" ودور الجامعة العربية أثناء أزمات عديدة آخرها احتلال العراق مروراً بمخيم جنين، وواجدون من ينادي بالفم الملآن بالبحث عن بدائل غير عربية للعلاقات التي كانت ترسم في ظل الأحلام القومية.
إن تحركاً لتيار عميق تحت السطح العربي العام، من الأمور الجديرة بالملاحظة والدراسة.. فلندرس في ظله المتغيرات وما ينبغي أن يطاله الإصلاح والتغيير وكل إمكانات المواجهة والتحرك، إذا أردنا لبعض أهدافنا الكبيرة والنبيلة أن تبقى وأن تعيش، وعلينا أن نلتمس الإقناع بتلك الأهداف والتدليل على صلاحها وإمكانية تحقيقها بالتركيز على أمرين:
-إظهار المصلحة القطرية والقومية في ذلك الهدف، والتدليل على عدم فراغ الشعار من مضمونه ومحتواه عملياً، والتركيز على الرؤية القومية السليمة في برمجة تأخذ المستقبل البعيد والهوية والخصوصية العربيتين والبعدين الروحي والثقافي بالاعتبار عند طرح المصلحة المرتبطة بقطر ما أو بإنسان ذي خصوصية وتمايز.
-التفكير -ولو مرحلياً- بصيغ عمل عربي سياسي عام، تأخذ بالاعتبار الوجود المتورم للدولة القطرية، والمصلحة القطرية الموضوعية التي لا تتعارض كلياً مع المصلحة القومية وتتكامل معها على المدى البعيد، وتبحث في إطار تعاون وعمل عربيين يظهران المصلحة الحقيقية والمنفعة المباشرة على الأرض، ويقيمان صلات حقيقية بين الأقطار ويتم تطوير هذه الصلات حيث يصبح من غير الممكن أن يستغني قطر عن قطر عملياً حتى بالاعتماد على الآخرين، إلا بكلفة باهظة جداً غير اعتيادية أو بقهر عدواني عليه أن يعلنه ويدعو الأمة إلى مواجهته لا أن يغطيه بإرادة قطرية تتشنج أكثر كلما كان الخرق للمصلحة القومية أكبر وأخطر، وحيث يغدو العمل العربي المشترك محققاً لمكاسب جماهيرية وفردية وحكومية وقطرية ملموسة تحرص عليها السياسات وتطمئن إليها وتجد فيها مخارج من أزماتها عموماً، وتحميها الجماهير بكل قوتها لأن لها مصلحة في حمايتها.
وإذا ما أظهر ذلك إلى الوجود المنفعة والمصلحة القوميتين من خلال الصلات والمنافع والمصالح القطرية بتكامل مدروس فإنه سيكون عملاً أقرب إلى الواقعية والسلامة يؤسس عملياً لخدمة الأهداف القومية والطموحات العربية المشروعة وإعادة الحياة والمشروعية للأحلام الكبيرة بإخراجها من دائرة "الطوباويات" النظرية إلى دائرة الممكنات العملية المتدرجة من البسيط إلى المركب، من الخاص إلى العام، ومن القطري إلى القومي في توجه مبدئي ثابت يعي مصالحه وأهدافه.
فهل نفعل ذلك وبسرعة ودقة ؟! إن في القيام بهذا مصلحة وخدمة للأمة ولتياراتها وأحزابها القومية وللقضايا المصيرية الكبرى في مواسم التحديات الكبرى، وفيه حيوية وإحياء للأهداف والشعارات والأفكار التي تريد الجماهير أن تراها حية ومؤثرة وواقعية، وفيه بعث للهمم وتجديد للعزائم، وخروج من شعار المصلحة إلى مصلحة الأمة في تجسيد الشعار.
ليس لنا أن نهرب من ذواتنا فلا يوجد في قاموس الأمم الحية والأفراد الواعين شيء اسمه الهرب من الذات لأنها لا تعوض .. ومن يريد تقمص ذاتاً أخرى هو شخص مريض وحالة شاذة. لا مهرب من الذات في واقعها ولا بد من مواجهة ذاك الواقع بانتماء ومسؤولية وقوة، لا نهرب ولا نتخلى عن كل ما يريد العدو أن نتخلى عنه، حتى لوكنا في مرحلة ضعف وتراجع ينبغي أن ندفع اليأس ومن يدفعنا إلى اليأس.. ومن المهم ألا نكون في مراحل انهيار يفاقم الضعف ويغرس الاستكانة والشعور بالدونية ويجعل مقاومتنا لحالات الضعف والاستسلام موضع إدانة من بعضنا. علينا ألا نترك البغاث تستنسر في أرضنا وهي تفعل ذلك بين ظهرانينا وسيكون لذلك تأثير خطير جداً علينا إذا ما استمر سكوتنا عليه.. سيكون بالتأكيد أشد فتكاً بنا من العدو الخارجي فضلاً عن كونه أداته أصلاً وقوته مضافة إلى قوته. علينا ألا نترك العدو المحتل يرتاح على أكتافنا، وألا نجعل دمنا رخيصاً ويرخصه الطامعون بنا أكثر، وألا نسكت من خطر أشد بينما الخطر يجتاحنا بكل ما أشد ومنذر بالأشد.. إن الأمم تحتاج إلى الحلم والهدف والشعار.. مثلما تحتاج إلى العمل والإنجاز والتضحية والنضال والأنموذج البطولي والقدوة الحسنة.. والأمم تحتاج إلى معيار سليم ودقيق تعرض عليه الأشخاص والأفعال وتحتكم إليه وتأخذ بنتائج أحكامه.. وكل ذلك يحتاج إلى أن يروى بالتضحيات ويعزز بالعمل والفكر والمعرفة العلمية والإرادة القومية الصلابة الروحية والسلامة الخلقية والنضالية. لسنا على ضلال وأفكارنا ومبادئنا ليست مما يتجاوزه الزمن، ولكن ضعفنا وتمزقنا وولاء بعضنا لعدو الأمة وبحثه عن مصالح ضيقة أضعفنا وأضعف كل شيء فينا ويصدر عنا حتى بنظرنا نحن، وجعل الأمة والأهداف والشعارات والقضايا الكبرى وحتى المستقبل والمصير موضع تساؤل وموضوع أسئلة.. ولا يضيرنا أبداً أن نسأل أسئلة قومية: إيجابية وسلبية، وأن نحلم أحلاماً وردية في أزمنة عربية رديَّة.. فالسؤال يطارد الجواب، والليل طريد نهار، والحلم من مداخل تغيير الواقع.. وكل هذا نحتاج إليه ونحتاج إلى مقاربته بمسؤولية وسرعة وعزم في زمن المراجعة والإصلاح والاستصلاح في المجتمعات والعقول والنفوس.