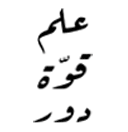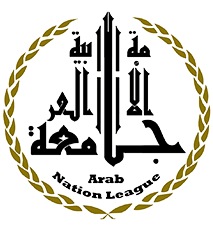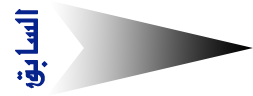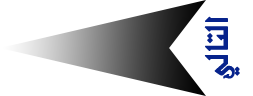التعصّب fanatism هو الانحياز التحزبي إلى شيء من الأشياء، فكرة أو مبدأ أو معتقد أو شخص، إمّا «مع» وإمّا«ضد». والتعصب للشيء هو مساندته ومؤازرته، والدفاع عنه، والتعصب ضد الشيء هو مقاومته، وقد يتداخل الأمران في فعل التعصب الذي يتجلى فيه التهور والتحمس والعنف معاً. ويرتبط مفهوم التعصب في أذهان الناس بالجانب السلبي منه، ذلك أن التعصب هو في أساسه نظرة سلبية إلى الغير، والمتعصب يتجه إلى تحقير الآخرين وإلحاق الضرر بهم، أكثر مما يميل إلى تأكيد مزاياهم الخاصة أو الحصول على كسب منفعة خاصة.
وتكمن خطورة التعصب في كونه عقبة في وجه التفكير العلمي، فالتعصب يلغي التفكير الحر والقدرة على التساؤل والنقد، ويشجع قيم الخضوع والطاعة والاندماج، وهذا ينطبق على كل أشكال التعصب في شتى الميادين، الدين والفكر والسياسة والقومية.
فالتعصب في الدين يؤدي إلى اضطهاد العلماء والجمود، وفي الفكر يؤدي إلى الدوغماطيقية (الجزم من غير بينة أو دليل) والمذاهب المطلقة والمغلقة، وعلى مستوى الدولة (القومي)، يؤدي التعصب إلى تكوين إيديولوجيات لا تقبل إلا مبادئها والخضوع من ثمّ لسلطتها، وترفض غيرها من الإيديولوجيات، وهذا يؤدي تبعاً إلى الصراع الإيديولوجي والحروب، وفي مجال السياسة يؤدي التعصب إلى الديكتاتورية والاستبداد، والتعصب العنصري (الجنسي أو العِرقي) يؤدي إلى تحقير جنس لآخر كما في أسطورة رينان عن تفوق الجنس الآري على السامي التي هي أكذوبة علمية تهبط بالعقلية السامية (بما فيها العربية) مقابل الإعلاء من ذكاء وتفوق الجنس الأوربي.
أعظم الأخطار التي يجلبها التعصب على العلم هو أنه يجعل الحقيقة ذاتية ومتعددة ومتناقضة، وهو ما يتناقض تماماً مع طبيعة الحقيقة العلمية.
وينطوي التعصب على تفكير أسطوري، فالتحيز لشيء ما، يُخفي طابعه الحقيقي، ويحل محله طابعاً وهمياً مختلقاً، أي يحوّله إلى أسطورة، وهذا بطبيعته يشجع التفكير اللاعقلي لأنه الدعامة الوحيدة له. وهذا ينطبق على سبيل المثال، على ما تضمنته فلسفة روبرت فلود الموسوية التعصبية في منتصف القرن السابع عشر، حيث فسرت ظواهر الوجود بإرجاعها إلى تأثير القوى الخفية والمعجزات الإلهية. وكذلك ما حدث لألمانية في عهد هتلر ـ في النصف الأول من القرن العشرين ـ حيث كان أساس النازية هو أسطورة الجنس الآري المتفوق، وكان أساس التفرقة العنصرية هو أسطورة الجنس الزنجي، إلى غير ذلك من الأساطير التي يستند إليها كل شكل من أشكال التعصب.
التعصب والحرية والتسامح
التعصب نقيض الحرية Liberty والتسامح Toleration، إذا ازداد التعصب قلت الحرية، وضعف التسامح، فالتسامح يمنح المرء حرية الضمير في إبداء الرأي واعتناق المعتقدات رغم مخالفة الغير. يقول بوسويه Bossuet: «التسامح هو عدم معاقبة أصحاب الآراء المخالفة لرأي ما، إنه واجب أخلاقي ناشئ عن احترام الشخصية الإنسانية، واحترام المرء لآراء الغير، عاداته ومعتقداته». والتسامح عند علماء اللاهوت هو الصفح عن مخالفة المرء لتعاليم الدين، فهو يزيل الاستبداد ويقضي على الاضطهاد. يقول غوبلو: «التسامح لايوجب على المرء التخلي عن معتقداته أو الامتناع عن إظهارها، أو الدفاع عنها أو التعصب لها، بل يوجب عليه الامتناع عن نشر آرائه بالقوة والقسر والقدح والخداع».
ارتبطت فكرة التسامح تاريخياً بممارسات وعقائد دينية، وذلك منذ صدور مراسيم التسامح الرومانية المسيحية (311-313م)، ثم التسامح بين المسيحيين وفرقهم المختلفة، وتأكدت أهميتها في أوربة أثناء الإصلاح الديني. وعالج كثير من مفكري القرنين السادس عشر والسابع عشر حججاً لصالح التسامح الديني ونبذ التعصب، أمثال بودان وألتوسيوس وميلتون وسبينوزا. فأنشأ روجر وليامز R.Williams من جماعة البيوريتان[ر] (التطهرية) أول حكومة عصرية في رود آيلند تؤمن بالتسامح وطبقه عملياً. كما أصدر جون لوك J.Lock عام 1689عدة رسائل دفاعاً عن التسامح، فأكّد أن الغاية من تكوين الدولة هو إنماء المصالح المدنية وذلك عن طريق التسامح، فالتسامح هو المبدأ الذي يتيح للإيمان الصحيح أفضل فرصة لأن يسود، أن التعصب الديني غير مبرر إلا عندما يكون ضرورياً للمحافظة على النظام العام. وأكد بيير بيل (1686) Bayle ضرورة التسامح مع المعتقدات التي تبدو مغالطة، لأنها قد تكون حقة، فمن الخطورة لأي دين أن لا يكون متسامحاً، ومن واجب الدولة السماح بكل شيء إلا بعدم التسامح.
كما دافع فولتير[ر] Voltaire، في القرن الثامن عشر عن التسامح وحقوق الإنسان وحارب التعصب. وتتجلى أهم جهوده في حملته المنظمة على الخرافات، وفي كتابه «مقبرة التعصب» (1767) الذي يهاجم فيه الكنيسة الكاثوليكية: «إن التعصب هوسٌ دينيٌ فظيع، مرضٌ معدٍ يصيب العقل كالجدري. ولا يوجد علاج لهذا الداء المعدي إلا الروح الفلسفية التي بانتشارها شيئاً فشيئاً تتهذب أخلاق البشر وتتحاشى التطرف. وليس القوانين ولا الدين بكافيين لمكافحة هذا الطاعون الذي يصيب النفوس. إن الروح الفلسفية تضفي على النفس السكينة، أما التعصب فعلى العكس من ذلك ضد السكينة، والتسامح هو قوام الإنسانية لأننا كلنا خطاؤون، وهذا أول قانون للطبيعة، والشقاق هو أكبر شر يصيب الجنس البشري، والتسامح دواؤه».
كما وضع جون ستيوارت مل أيضاً كتابه حول الحرية (1859) مؤيداً التسامح في مواجهة التعصب. وكذلك صاغ الفيلسوف الألماني لسينغLessing (1729-1781) في مسرحية «ناتان الحكيم» (1778) بشكل أدبي فكرة التسامح بين الأديان، وذلك عن طريق العمل الصالح، وليس بالتعصب الأحمق. وصار هذا العمل مثلاً يُضرب في التسامح.
وقدم الإسلام للبشرية جمعاء أروع مثل للتسامح تمثل في أمرين:
أولاً: نظمه ومبادئه المعلنة، كقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي[سورة البقرة:256]، وقوله:إن أكرمكم عند الله أتقاكم[سورة الحجرات:13].
ثانياً: تعامله مع الغير من فجر أيامه إلى قمة انتصاراته، يشهد له بذلك جمهور علماء الغرب المنصفين، يقول غوستاف لوبون: «إن القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن، إذ لم ينتشر بالسيف بل انتشر بالدعوة، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخراً كالترك والمغول، وأدرك رجاله الأوائل أن النظم والأديان ليست مما يفرض قسراً، فتعاملوا مع المغلوبين بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم، والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم».
عارض بعضهم أمثال «ميرابو» (السياسي) التسامح بقوله:»إنني أرى الحرية الدينية المطلقة التي لا تخضع لأي قيد، تبلغ حداً من القداسة تبدو لي فيه كلمة التسامح كأنها نوع من الاستبداد لأن السلطة التي تتسامح قد يتراءى لها أن تتعصب«. وقدم توماس بين T.Paine الاحتجاج نفسه في كتابه «حقوق الإنسان»: «ليس التسامح عكس اللاتسامح، وإنما هو تلفيق له، وكلاهما تحكم واستبداد، فإن أحدهما يزعم لنفسه حق منع حرية الضمير، والثاني يزعم لنفسه حق منحها».ومع هذا يبقى التسامح الغاية القصوى بل القاعدة الأساسية ونقطة البداية للتعامل بين البشر، لأنه يتحول إلى تعاطف ومحبة.