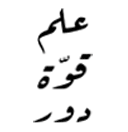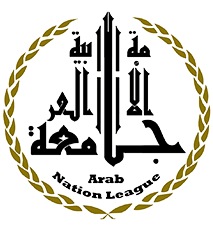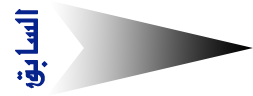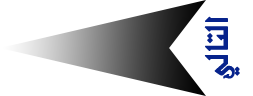الأمثال جمع مَثَل ومِثْل ومثيل، وهذا الأصل في اللغة العربية يدل على المماثلة، أو على مناظرة الشيء للشيء، من قولك: هذا مِثْل الشيء ومثيله، كما تقول: شِبهه وشبيهه، مأخوذ من المثال والحذو، شبّهوه بالمثال الذي يُضرب عليه غيره.
ويقول الزمخشري (ت 538هـ) في مقدمة كتابه «المستقصى من أمثال العرب»: «والمَثَل في أصل كلامهم بمعنى المِثْل والنظير». ومَثَل الشيء أيضاً صفته، كما رأى بعض المفسّرين في قوله تعالى: مَثَلُ الْجَنَّةِ التي وُعِدَ الْمُتَّقُوْن (محمد15)، أي صفة الجنة. وفي قوله تعالى: ذَلِكَ مَثَلُهُمْ في التَّوْرَاةِ ومَثَلُهُمْ في الإِنْجِيْل (الفتح29)، أي ذلك صفة محمد وأصحابه في التوراة والإنجيل.
وقد يكون المثَل بمعنى العِبْرة، ومنه قوله تعالى: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَاً ومَثَلاً لِلآخَرِيْن (الزخرف 56)، ويكون المثل بمعنى الآية، من قوله تعالى: وجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنيْ إِسْرَائِيل (الزخرف59) أي آية تدل على نبوّته.
والمثل هو القول السائر الذي يُشبَّه به حال الثاني بالأول، أو الذي يشبه مَضرِبه بمَورِدِه، والمراد بالمورد الحالة الأصلية التي ورد فيها الكلام، وبالمضرب الحالة المشبهة التي أريدت بالكلام.
ويقولون: «الأمثال تُحكى، يعنون بذلك أنها تضرب على ما جاءت عن العرب، ولا تُغير صيغتها». والمراد بضرب المثل هو اعتبار الشيء بغيره وتمثيله به.
وعن حقيقة المثل وشيوعه وسيرورته يقول المرزوقي (ت421هـ) في «شرح الفصيح»: «المثل جملة من القول مقتضبة من أصلها، أو مرسلة بذاتها، فتتّسم بالقبول، وتشتهر بالتداول، فتُنقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها من غير تغيير يلحقها في لفظها، وعمّا يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني؛ فلذلك تضرب وإن جُهلت أسبابها التي خرجت عليها».
لمّا اتجه علماء العربية بمدلول المثل نحو الاصطلاح اتّسعوا بتعريفه وصفاته العامة كما يستفاد من كلام أبي عبيد القاسم بن سلاّم (ت224هـ) في كتابه «الأمثال» إذ يقول: «هذا كتاب الأمثال، وهي حكمة العرب في الجاهلية والإسلام، وبها كانت تعارض كلامها، فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق، بكناية غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه».
وبهذه الرؤية تبدو الأمثال حكمة مستخلصة من تجارب المجتمعات العربية وخبراتها وأحوالها في الجاهلية والإسلام، وقرْنُها بالكناية على إرادة الصياغة الأسلوبية الغالبة، لا الكناية بمعناها الاصطلاحي عند علماء البلاغة.
ولعل أكثر التعريفات إحاطةً وشمولاً لمفهوم المثل قول أبي إبراهيم إسحاق الفارابي (ت350هـ): «المثل ما تراضاه العامة والخاصة، في لفظه ومعناه، حتى ابتذلوه فيما بينهم، وفاهوا به في السرّاء والضرّاء، واستدرّوا به الممتنع من الدّر، ووصلوا به إلى المطالب القصية، وتفرّجوا به عن الكرْب والمكْرُبة، وهو من أبلغ الحكمة؛ لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصِّر في الجودة، أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة».
وفي الاصطلاح عرف العرب ثلاثة أنواع من الأمثال هي:
المثل السائر: وهو المراد عند التعميم والإطلاق.
والمثل القياسي :وهو «سرد وصفي أو قصصي أو تصويري لتوضيح فكرة، عن طريق تشبيه شيء بشيء، لتقريب المعقول من المحسوس، لغرض التأديب، أو التهذيب، أو الإيضاح، أو غير ذلك. ويمتاز هذا النوع من النوع الأول بالإطناب، وعمق الفكرة، وجمال التصوير».
وهذا النوع من الأمثال لم تُعن به مصنفات الأمثال العربية القديمة، وهو مبثوث في القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف وغيرهما. منه في القرآن الكريم قوله تعالى: ومَثَلُ الَّذِيْن كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً ونِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُوْن (البقرة 172).
ومنه قول الرسول: «مَثَل عِلْم لا يُنتفع به كمثل مال لا يُنفق منه في سبيل الله». وقوله : «مَثَل هذه الدنيا كمثل ثوب شُقَّ أوَّله إلى آخره».
أما النوع الثالث فهو المثل الخرافي:وهو قصة قصيرة بسيطة رمزية غالباً، لها مغزى أخلاقي، وقد تكون على ألسنة الحيوانات، كقصص «كليلة ودمنة» التي نقلها إلى العربية ابن المقفع، ومثل قصة الأرنب والضب، وكقصص الشاعر الفرنسي لافونتين La Fontaine.
ويختلف المثل الخرافي عن القياسي في أن الأحاسيس الإنسانية فيه تنسب إلى غير الإنسان. أما المثل القياسي فالحيوانات فيه، وإن استخدمت، فلا تعدو أن تكون مجرد أداة للفكرة، وفي الأول تستخدم الحيوانات على أنها رموز إلى ناس، أو إلى أمور، أو إلى أشياء أخرى، أما في الثاني فتقصد لذاتها، أو يؤتى بها لتوضيح الفكرة عن طريق التشبيه والتمثيل.
وتدل الأمثال على عقلية الشعب الذي تصدر عنه، وتُصوِّر حياته الاجتماعية، وهي خير دليل على أخلاقه وطبيعة ثقافته، ومشاغله، وهمومه، وراصد لأحوال بيئته وموجوداتها، وترجمان لمستوى لغته ونهج تربيته، وفيها تسجيل دقيق لجانب من تاريخه العام، ذلك أن بعض الأمثال تكون وليدة الأسطورة في إطار التاريخ المحلّي، أو وليدة حادثة تُروى على أنها حدث تاريخي كبير كتلك المستمدة من أيام العرب، مثل حرب داحس والغبراء، ويوم الرحرحان الثاني، ويوم النفراوات (يوم حليمة)، أو (عين أُباغ)، ويوم الكلاب (الأول والثاني)، ويوم حجر، وكالأمثلة المستمدَّة من قصة الزبَّاء. وقد ترتبط بشخصيات كانت ذات شأن في مجتمعها، كلقمان الحكيم، وأبي لهب، ومسيلمة الكذّاب، والنعمان بن المنذر، و بيهس الأحمق.
وإذا كانت الأمثال قد ظهرت مع بداية التجربة الإنسانية وتكوّن المجتمعات واللغات، فمن الممكن ربط تلك الأحداث والأسماء العربية بنشأة الأمثال عند العرب منذ الجاهلية، كما يستخلص من المثلين «أشأم من البَسُوس» الذي قيل في حرب البسوس، و«أشأم من داحس» الذي قيل في حرب داحس والغبراء. أو كما يستفاد من المثل: «ما يوم حليمة بسرّ»، أو من المثل المقول في حديث جذيمة الأبرش والزبَّاء: «خَطْب يسيرٌ في خطب كبير».
ويمكن فرز الأمثال الجاهلية من غيرها بنسبتها إلى قائليها أخذاً بما نصّ عليه العلماء والمؤرخون، كاتفاقهم على نسبة المثل: «ربّ أخ لك لم تلده أمك» إلى لقمان بن عاد، ونسبة المثل: «إنك لا تجني من الشوك العنب» إلى أكثم ابن صيفي، وكذلك نظيره: «أول الحزم المشورة»، وكقول عامر بن الظرب: «رُبَّ أَكْلَةٍ تَمْنَعُ أَكَلاتٍ».
وقد تُغفل الإشارة إلى الحدث الذي قيل فيه المثل، أو تغفل نسبته إلى قائله، ولكن يبقى النص على جاهليته، أو على نسبته إلى قبائل جاهلية، من ذلك نسبتهم المثل: «ألحن من الجرادتين» إلى قبيلة عاد، والمثل: «شرّ يوميها وأغواه لها» إلى قبيلة طَسْم، والمثل: «من دخل ظفار حَمَّر» إلى حِمْيَر.
أما الأمثال الإسلامية ففي صدارتها ما جاء في محكم آي الذكر المجيد مقروناً بلفظة «مثل» أو «أمثال»، كما في قوله تعالى: ويَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْن (إبراهيم25)، وقوله تعالى: وضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّة (النحل112)، وقوله عزَّ وجل: إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِيْ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَها (البقرة26)، إلى غير ذلك مما أشار به إلى منافع الأمثال في متصرّفاتها وحسن مواقعها.
ومن الأمثال الإسلامية ما سيق متأثراً بما جاء به القرآن الكريم من قصص الأنبياء، ومن الحكمة والموعظة والتشريع والترغيب والترهيب، أو متأثراً بلغة التنزيل وجمال تصويره وإعجازه المحفوظ، كما يلحظ بوضوح في المثل: «أتبُّ من أبي لهب» أو «أقرب من حبل الوريد»، من الآية الكريمة: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْد (ق16)، أو «أفرغ من فؤاد أم موسى» من الآية الكريمة: وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوْسَى فَارِغاً (القصص10).
وغير خفي أن قسماً كبيراً من الأمثال والحِكَم الإسلامية يرتبط بالحديث النبوي الشريف، قولاً، أو أصلاً، أو نقلاً وتضميناً، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «حمي الوطيس» و«مات حتف أنفه»، و«إن من البيان لسحراً»، و«اليد العليا خير من اليد السفلى»، و«التائب من الذنب كمن لا ذنب له». وقسماً منها يعزى إلى الصحابة والتابعين، كما في قول أبي بكر الصديق: «لا طامّة إلا وفوقها طامة»، وقول عمر بن الخطّاب: «النساء لَحْم على وَضَم إلا ماذُبَّ عنه»، وقول علي بن أبي طالب: «رأي الشيخ خير من مشهد الغلام»، وقول ابن عباس: «إذا جاء القدر عَشِي البصر»، وقول ابن مسعود: «النساء حبائل الشيطان»، وقول عمرو بن العاص: «استراح من لا عقل له».
فهذه الأمثال لا يداخل الشكّ نسبتها إلى قائليها لأن التدوين بدأ معهم معزّزاً بتسلسل الروايات وصحة السند.
أما بقية الأمثال العربية فقد صنّفت في نسبتها تحت مصطلح المولَّد، وأطلق بعضهم عليها اسم «الحديثة» و«الجديدة». وأول من اهتم بتمييز الأمثال المولّدة من غيرها حمزة الأصفهاني (ت360هـ) في كتابه «الدُّرَّة الفاخرة»، وسمي أيضاً «كتاب سوائر الأمثال على أفعل». وأبو هلال العسكري (ت395هـ) في كتابه «جمهرة الأمثال»، فالميداني أبو الفضل أحمد بن محمد (ت518هـ) في كتابه «مجمع الأمثال».
وإلى جانب الأحداث والشخصيات التاريخية كانت مادة الأمثال تدور حول الحيوانات كالإبل (السائبة، البَحِيْرة، الوصيلة، الحامي)، والفرس، والكلب ونظائر ذلك من حيوانات البرِّية. أو كانت تدور حول القبائل والموروثات الدينية القديمة، ومظاهر الطبيعة، والدهر، والمأكول والمشروب. على أنها كانت تولي الإنسان عناية خاصة، يستوي في ذلك الملوك والرؤساء والبؤساء والفُتَّاك وأصحاب الخرافات، مع ما يتصل بحيوات هؤلاء وأضرابهم من المشاعر والغرائز والصفات والأفعال والعادات.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك من يخلط بين المثل والحكمة متأثراً باللغة المحكمة الموجَزة، أو بتشابه الأسلوب في الحكمة والمثل، بيد أن المثل يختلف عن الحكمة في كونه أكثر إيجازاً في الغالب، وأكثر شيوعاً واعتماداً على التشبيه، وميلاً إلى الحسيّة، والاحتجاج، والترف اللغوي الظاهري، وقد يكون المثل «عبارة تقليدية»، تستخدم في الدعاء واللعن والخطاب والتحيّة. أما الحكمة فتقوم على العظة والاعتبار، وتصدر عن طول تجربة وإعمال فكر، وتهدف إلى الإرشاد والتربية وتحض على التأمّل وتحكيم العقل.
أسلوب الأمثال
من أبرز سمات أسلوب الأمثال الاعتماد على البلاغة في الصياغة، ذلك أن أساس المثل تشبيه حالة بحالة، أو استعارة حالة لحالة أخرى، كقولهم: «بيتي يبخل لا أنا». ويؤدَّى ذلك بألفاظ متخيَّرة موقّعة أو مسجوعة أو مزدوجة مصوغة في إفصاح وإيجاز وإحكام. ومن الأقوال التي تلخّص وصف أسلوب الأمثال ما جاء في مقدمة كتاب الميداني، قال: «يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، فهو نهاية البلاغة».
وكثُر الحديث عن الإيجاز والاختصار في الأمثال حتى صُوِّرت وكأنها رموز وإشارات يلوَّح بها إلى المعاني تلويحاً، كقولهم: «عشبٌ ولا بعير». ويصف أبو هلال العسكري ملامح هذا الإيجاز في قوله عنها: «فهي من أجلّ الكلام وأنبله، وأشرفه، وأفضله، لقلة ألفاظها، وكثرة معانيها، ويسير إيجازها، تعمل عمل الإطناب». ومن الشواهد التي يسوقها على ذلك: «العَوْدُ أحمد» و«السِّرُّ أمانة» و«جزاء سِنِمَّار» و«الخلاء بلاء».
ومما تتصف به لغة الأمثال جودة الكناية في مثل قولهم: «بقضِّه وقضيضه» أو «بلغ السيل الزُّبَى». كما تتصف بالسجع أو توافق الفواصل، وبحسن التشبيه، والمبالغة والمغالاة في مثل: «أبقى من الدهر» و«أثقل من طَوْد». وأحياناً بالطباق من نحو: «ويل للشّجيّ من الخليّ». ويُعزى طغيان صيغة أفعل التفضيل في أسلوب الأمثال إلى المتأخرين أو المولَّدين، ولكنه أسلوب شائع عند القدماء مألوف في مثل قولهم: «أحلم من الأحنف» أو «أشأم من طويس» أو «أعزُّ من كليب وائل» أو «أكبر من لُبَد» و«أسْيَرُ من مثل». على أن المدقق في أسلوب الأمثال يجد أنها تضمّنت مجمل صيغ الإنشاء الأدبي من الأمر والنهي والدعاء والتمنّي والتعجب والشرط والجمل الاسمية والفعلية.
وتلتزم الأمثال منطوق الكلام الذي قيلت به أول مرة من غير تغيير يراعي القواعد أو الفصائل اللغوية. يقول الزمخشري في هذا: الأمثال يُتكلَّم بها كما هي، فليس لك أن تطرح شيئاً من علامات التأنيث في «أطرِّي فإنّك ناعله»، وفي «رمتني بدائها وانسلّت»، وإن كان المضروب له مذكَّراً، ولا يبدَّل اسم المخاطَب من (عقيل) و(عمرو) في «أشئت عقيل إلى عقلك» و«هذه بتلك فهل جزيتك ياعمرو». وقل مثل ذلك في المثل: «الصيف ضيّعتِ اللبن»، أو في المثل المشهور: «مكره أخاك لا بطل».
وما من شك في أن شيوع المثل الفصيح هو الغالب على مر العصور العربية القديمة لأنه قرين الفصحى التي استمرّت مواكبة الفكر العربي الذي كانت أداته ووسيلته، ومن هنا كانت الأمثال التي ترجمها العرب عن الفارسية أو اليونانية فصيحة اللغة تبعاً لزمن ترجمتها الذي كانت محتفظة بمكانتها فيه.
ولم تكن الأمثال مقصورة على النثر، أو على التعابير المَثَلية، نحو «سكت ألفاً ونطق خُلْفاً»، وإنما كان لها حظها من النظم، إذ جاء بعضها على أسلوب المثل في أشطار، أو في تعبيرات موزونة الأداء نحو:«إنّ البُغاث بأرضنا تَسْتنسِر»، أو: «تجري الرياح بما لا تشتهي السُّفُنُ».
وأقل من شطر نحو: «لا تُفسدِ القوس [أعطِ القوس باريها].
ومن طريف ما قيل في ذلك بيت أبي تمّام:
ما أنتَ إلا مَثَلٌ سائرٌ يعرفه الجاهل والخابر
وكان من شدة اهتمام العرب بالأمثال أن وَضَعت فيها ما يزيد على ستة وستين كتاباً بدءاً من صَحَار العبدي (ت40هـ) ووصولاً إلى إبراهيم الأحدب الطرابلسي (ت1308هـ). وهذا كله حصيلة معرفتهم بأهمية الأمثال في مجال فتنة اللغة أو الإمتاع اللغوي وحسن الأداء، فضلاً عن رصد الأمثال لأحوال المجتمعات والتطور العقلي للعرب، مع إحساسهم بقيمة وظيفتها الأخلاقية التربوية، وأثرها في الترفيه وإعادة قصّ الماضي وربطه بالحاضر والمستقبل، ولهذا ما خصص لها سفر في العهد القديم من الكتاب المقدس، وحيّز واسع في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
مراجع للاستزادة
ـ الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري)، مجمع الأمثال، حققه وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد، ط3 (دار الفكر 1982).
ـ أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، عبد المجيد قطامش، ط3 (دار الجليل، بيروت، لبنان 1988).
ـ رودلف زلهايم، الأمثال العربية القديمة، ترجمة رمضان عبد التواب (مؤسسة الرسالة، بيروت 1987).
ـ الزمخشري (جار الله أبو القاسم محمود بن عمر) المستقصى في أمثال العرب، ط2 (دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1977).
ـ حمزة بن الحسن الأصفهاني، سوائر الأمثال على أفعل، تحقيق فهمي سعد، ط1 (عالم الكتب، بيروت، لبنان 1988).