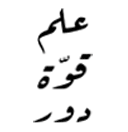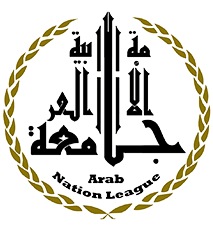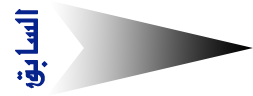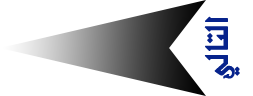العَلمانية (بفتح العين) هي موضوع يشغل بال الكثيرين اليوم، وبصورة متزايدة، خاصة في المجتمعات المتعبة من أزمات الحروب والمصاعب الاقتصادية، وذلك منطقي ويرجع لعوامل مفهومة، وبمكننا المرور عليها سريعا. فأغلب الحروب على مدى التاريخ كان الدين الاجتماعي (النسخة المتداولة منه في مجتمع ما، وزمن ما) دائما عنصرا متداخلا فيها، وربما من مسبباتها، أو على أقل تقدير مستخدم فيها. وهذا بدوره أيضا مفهوم لسبب تشابك وتلازم مسألة الدين مع الحكم عبر التاريخ. فابن خلدون يقول أنه لا يمكن بناء دولة بدون عصبية، والعصبية الأقوى هي الدين. لذلك فهو لازم للاستخدام في كل التشكلات والتحولات السياسية عبر التاريخ، وهذا بالطبع يمكن أن يكون سلبيا أو إيجابيا، فليس كل استخدام للنظرية أو العقيدة التي تؤمن بها مجموعة من البشر، هو بالضرورة أمرسلبي.
اليوم حديث العلمانية مطروح بصوره المتناقضة أحيانا بين من هو معه ومن هو ضده، وعلى كل المستويات ابتداء من المفكرين والمثقفين ورجال الدين، ومرورا بالشرائح الاجتماعية الأكثر ثقافة وتعلما، وصولا إلى تلك الأقل معرفة وخبرة. والكل لديه موقف راسخ، فهناك من يعتبرها الحل، وهؤلاء غالبا لديهم مشكلة مع دين معين أو طائفة، بمقابل من يعتبرها المشكلة، وهؤلاء بدورهم ممن لديهم انتماء محافظ لدين معين أو طائفة، والقليلون جدا ممن يعتبرونها أحد التشكلات الموضوعية للصيرورة والنهضة التاريخية للمجتمعات، ويعتقدون بأنها لا تتعارض مع الدين أساسا.
البحث في العلمانية، يمكن أن يقسم على مستويات، و إلى أقسام. فالعلمانية قد تكون على مستوى الأفراد، و أيضا على مستوى المؤسسات و الدول، كما و أنها عند الفرد و المؤسسة، قد تكون في العقيدة، وقد تكون في السلوك. فماذا نقصد بكل ذلك، و هل تجيب العلمانية على كل الاسئلة و الإرهاصات الإجتماعية و السياسية، التي تدورحولها..!
أولا لنفصل بين قسمي العلمانية، كسلوك و منهج، أو كعقيدة و مذهب. فإذا كانت العلمانية، تعني و بالمختصر "فصل الدين عن الدولة"، فهذا يعني أن لا تعامل الدولة أو المؤسسة أفرادها انطلاقا من خلفيتهم الدينية أو المذهبية، و ينسحب هذا في المجتمعات المتمدنة إلى العرق، و المنطقة، و غيرها.. هذا على جانب السلوك، أي أن الدولة تسلك سلوكا علمانيا، فلا تميز بين أفراد مجتمعها بناء على انتماءاتهم. وهذه الحيادية في سلوك الدولة والمؤسسات، ليست مطلقة ولكن نسبية مثلها مثل كل الأمور الإنسانية التجميعية، حيث تتواجد بنسب معينة كوصف للسلوك، وترتفع هذه النسب أو تنخفض. انطلاقا من هذا ولأن العنوان الدارج "فصل الدين عن الدولة" يبدو إقصائيا في صيغته أكثر مما يوحي بالقبول والتفهم، والعلمانية نفسها يجب أن تكون قبولا وتسامحا وإلا كانت عكسها، فإنه يمكننا إعادة صياغة التعريف هنا لكي يكون، بأن العلمانية هي سعي لتكريس مبدأ عدم التمييز بين المواطنين بناء على انتمائهم الديني، أو حتى اللاديني أيضا. والأمثلة من الواقع ربما ستكون أفضل مقاربة لشرح هذه التفاصيل ومعانيها التي لا تنطوي على أحكام بقد ما يجب أن تلقي الأضواء هنا وهناك في دائرة الفكر المهتم.
إن دساتير بعض الدول الغربية، لا تحدد دين رئيس الدولة فيها، كعنوان عريض عن علمانية هذه الدول، و في معظم الدول الغربية الأخرى، و التي تعلن علمانيتها، فإن دساتيرها تحدد دين رئيسها أو ملكها، وفي هذا سلوك غير علماني، و لكنه لا ينسف بالضرورة علمانية تلك الدول. أما إذا دنونا نحو الشرق، فنجد سوريا مثلا، و دستورها يحدد دين رئيس الدولة، و عليه فهي تخفق هنا في تطبيق علمانيتها التي تعلنها بصورة مواربة، و هو أمر أيضا لا ينسف بقية سلوكياتها العلمانية. في إيران مثلا يخصص مقعد في البرلمان للملحدين، و هذا سلوك فيه من العلمانية شيئا، لجهة الإعتراف بحق الإلحاد، و إعطاء الملحدين موطئ قدمٍ في السلطة التشريعية، و لكن هذا السلوك لا ينفي دينية الدولة الإيرانية، و ربما مذهبيتها. قد يرى البعض أيضا، و عن حق، أن إعطاء "كوته" طائفية للوظائف، أو للمجالس، هو بطريقة أو بأخرى يحمل تمييزا بين أبناء المجتمع طائفيا، و هذا أمر غير علماني، مع أنه يبدو كضمان لحقوق الطوائف، أو "الأقليات"، و لماذا نقول "يبدو كضمان"؟ لأن هذا الضمان ينطلق أساسا من تقسيم المجتمع على أساس طائفي، و هو أمرٌ يتخلف كثيرا عن البيئة المدنية التي تسعى إليها الشعوب المتحضرة، و هو أيضا خطرٌ و لا يؤدي إلى انسجامٍ في الولاء الوطني عند شعب ما. فعندما تسود روح المواطنة العالية في المجتمع، و تتجذر العلمانية في سلوك المؤسسات، تصير هي ضمانة تحمي حقوق الاعتقاد الديني، و الطائفي، كما و حق ممارسة الشعائر الدينية بحرية لا تتجاوز على حرية الآخرين. أما عن الإدارة و السياسة و الحكم، يكون التمثيل بناء على الكفاءة و الاختصاص ليس إلا، فيُمَثَّلُ المواطن الصالح، بمواطنٍ صالحٍ مناسب.
أما كيف تكون العلمانية عقيدة عند الدولة، فذلك عندما تعلن هذه الدولة عدم اعترافها بالدين، و ترفض فكرة وجوده، و هنا و إن كان هذا حق مكفولٌ للأفراد، بأن يرفضوا الإيمان بالدين، و أول من كفل هذا الحق، هي الشرائع الدينية ذاتها. و لكن بالنسبة للمؤسسة، يصبح جنوحا باتجاهٍ معاكس للعلمانية، فالعلمانية قبول و اعتراف، بل و ضمانُ الحق بالوجود و الإعتقاد، و لا يمكن أن تكون رفضا و إقصاء. و المؤسسة إذ ترفض الاعتراف بالدين، تنحو نحو فكر المتطرفين الدينيين، و الذي يرفض الاعتراف بالآخر و يكفره. لذلك بالضبط نجد أن تجارب التاريخ أعطت مثالا واضحا كيف أن كلا من السلطتين المتشددتين العلمانية و الدينية، تنتج الأخرى بعد حين، فهما و إن ظهرتا متناقضتين في الظاهر، و لكنهما متشابهتان في الجوهر، و خير مثال على ما نقول، هو تطور و انقلاب نظامي الحكم في تركيا خلال القرن الماضي، من العلمانية المتشددة إلى التشدد الديني و بالعكس، و أكثر من مرة.
أما على صعيد الأفراد، و كما ذكرنا سابقا، فإن الدين نفسه كفل لهم حق الكفر به، فالشرائع بصلبها لمن يحسن قراءتها وفهمها، علمانية تماما. عندما يقول القرآن ((فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر)) و ((لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي)) و عندما يقول المسيح ((من ليس ضدي فهو معي)) فنحن أمام فكرٍ يمتلئ قبولا بالآخر، و يعطيه حق الوجود و الاعتقاد. نحن و في نفس الإتجاه نعتقد أن الإنسان حرٌ في أن يؤمن بما يشاء، فهو يمكن أن يكون عِلماني العقيدة أيضا، يؤمن بالعلم، و لا يعترف بالدين، إذ أن هذا لا يترتب عليه بالضرورة، رفضٌ للآخر، فعلى صعيد السلوك و هو مستوىً مختلف، بإمكان الفرد و هذا ما نؤكد عليه، أن يتصرف بعَلمانية أيا كان اعتقاده، دينيا أو علميا، بحيث لا يميز في تعامله مع محيطه على أساس الاعتقاد و الدين و الطائفة.
هنا لا بد من ملاحظة على صعيد الأفراد، و الذين يعتقدون بجدوى العلم ليس إلا، فإنه و لأن البحث العلمي لا يؤمن إلا بالتجربة و الدلائل، فإن الاعتقاد بعدم صحة الدين، و أحيانا بعدم وجود الله، حتى و إن وُجِدَت عليه الكثير من الدلائل و القرائن، و لكنه يفتقر إلى الأدلة القطعية. لذلك ومن باب العلمية في التفكير، وجب عدم التورط في رفض أو إنكار إحتمال وجود الماورائيات، ولأسباب علمية، و بالتالي يكون الإنسان العلمي هو الأكثر قبولا و اعترافا بالآخر فكرياً.
وبالمقابل فإن المنزلق الأخطر الذي يقع فيه المحافظون دينيا وعقائديا، والذي يوديهم دائما إلى عكس مبادئ عقائدهم التي دائما تبنى على الحرية والإنسانية، هو قمع الآخر المخالف أو المختلف، ومحاولة ضمه قسريا إلى الجماعة التي ينطلق منها المحافظ، فيتحول هو بالضرورة إلى متطرف، لأن الشعرة التي تفصل الإيمان القوي عن التطرف، هي المسافة التي يقطعها المؤمن بين الالتزام بتعاليم العقيدة، وبين فرض هذا الالتزام على الآخرين.
في النهاية، نحن نرى في علمانية السلوك، إن على مستوى الدولة و المؤسسات، أو على مستوى الأفراد المواطنين، الضمانة و الحضن، لحرية الفكر و الاعتقاد، بين أفراد المجتمع على صعيد الشرائع التوحيدية، ومذاهبها، وأيضا وانطلاقا من ذلك و بناءً عليه، إلى ما هو أوسع من قبول للعقائد الحزبية و الفكرية و السياسية، وصولا إلى كافة التنوعات في الإنتاج الإنساني، لأن القبول سمة كاملة لا تتجزأ.. هنا، و اعتمادا على كل ما سلف، نحن نرى أن تطبيق العلمانية، يستلزم صيرورة من علمنة المجتمع، و التي يجب، ولا يمكن أن تكون، إلا في إطار نهضة مجتمعية علمية، و ثقافية، وإنتاجية على التحديد، تضمن تحقق الشروط الموضوعية للعلمانية، ولكل التطبيقات المدنية المتقدمة، بما فيها الممارسات الديمقراطية.