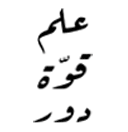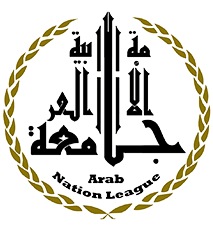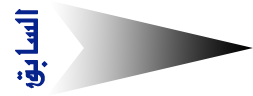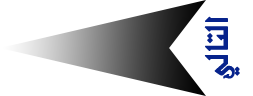لا يلخّص القضية ذلك الممثّل المتفلّت بتصرفاته ونوع الفن الذي يقدّمه، ولا هو بذاته موضوع أيّة معركة كبرى في لحظة حرجة من انقلابات السياسة في إقليم مشتعل بالنيران والمخاوف. في لحظةٍ، تصوَّر أنّه بثقل شعبية يتوهّمها يمكنه أن يكسر جدران مقاومة التطبيع التي شُيّدت شعبياً على مدى أكثر من أربعين عاماً، منذ معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية (1979).
سافر بطائرة خاصة أُرسلت إليه من دبي، ليشارك في افتتاح فرع لشركة إماراتية في تل أبيب، رقص على أنغام أغنية «هافانا نجيلا» للمطرب الإسرائيلي عمير أدام، احتضنه سعيداً، بُثّت الصور على أوسع نطاق ممكن، وانقلبت الدنيا على رأسه في بلده مصر.
بضغط هائل من رأي عام غاضب على ما جرى في دبي من انتهاك للمحرّمات المصرية، أُلغي مسلسل رمضاني يقوم ببطولته، وأوقفت شركة اتصالات شهيرة بثّ إعلانٍ جديدٍ قام بتصويره خشية أن تتضرّر مصالحها، كما قرّر اتحاد النقابات الفنية وقفه عن العمل لحين التحقيق معه، وأصدرت نقابة الصحافيين بياناً دعت فيه إلى منع نشر اسمه وصوره في الجرائد محذّرة من أنّ أيّ اختراق للتطبيع سوف يخضع للمساءلة النقابية.
كانت تلك ردّة فعل غاضبة على رسائل الصور التي التُقطت في حفل دبي واحتفت بها إسرائيل، كما لم يحدث من قبل. لم تكن تلك مقدّمة سلام دافئ مع أكبر دولة عربية، بعد أربعة عقود وُصفت بـ«السلام البارد». العكس تماماً هو الذي حدث، وتحوّل الممثل المتفلّت إلى أمثولة حتى لا يجرؤ أحد آخر على اتّباع الفعل نفسه. بدت الصدمة الإسرائيلية مروّعة، أعادوا اكتشاف قدر الكراهية المصرية لعنصريّتها المتأصّلة واستهتارها بكلّ ما هو إنسانيّ وعادل في القضية الفلسطينية.
الرسالة وصلت إلى الإقليم كلّه: رفضُ التطبيع قرار شعبيّ نهائيّ في مصر، لا سبيل إلى تجاوزه والتحايل عليه، أو القفز فوق محظوراته بادّعاء أنّ الدنيا تغيّرت، وأنّ اللغة القديمة لا تصلح مع العوالم الجديدة التي تؤذن بـ«الحقبة الإسرائيلية».
أيّة معركة تكتسب خطورتها من سياق حوادثها وقدر تحدّياتها وآثارها على حركة المستقبل. بالنظر إلى السياق الذي جرت فيه واقعة دبي التي دوّت في القاهرة، فإنّنا أمام مفترق طرق وسياسات وتحالفات أخطر من أن تُنسب لممثل متفلّت لا يعرف تاريخ بلده، ولا حقيقة ما يجري حوله ويهدّد مصيره لحقبٍ طويلة مقبلة.
هناك - أولاً - هرولة للتطبيع مع إسرائيل، من دون قيد أو سقف، والدولة الخليجية الأكبر السعودية على وشك أن تتّخذ الخطوة نفسها. رغم النفي الرسمي أن يكون هناك لقاء قد جرى في مدينة «نيوم» على ساحل البحر الأحمر، بين وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمشاركة ورعاية وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلّا أنّ الإسرائيليين أكّدوا الواقعة.
من حيث التوقيت، فإنّ اللقاء يعبّر عن قلقٍ سعودي من إعادة فتح ملف مقتل جمال خاشقجي، بعد أن تتولّى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، السلطة يوم 20 كانون الثاني/ يناير المقبل. إعادة فتح ملف خاشقجي، يؤثّر بالضرورة على فرص وليّ العهد بتولّي السلطة، بعد والده الملك سلمان بن عبد العزيز.
هكذا، تجد الرياض نفسها محشورة في زاوية ضيّقة: إذا اعترفت بإسرائيل بداعي حفظ العرش، فإنّ ما قد يحدث تالياً يصعب توقّعه أو تجنّب مخاطره؛ وإذا امتنعت انتظاراً لتولّي الإدارة الجديدة السلطة في الولايات المتحدة، فإنّه يصعب رفع السكّين عن رقبتها. في الاحتمالين، إشارات إلى أوضاع قلقة في الخليج وخرائط سياسية مختلفة وأحلاف استراتيجية محتملة، تنال من مصر وأمنها القومي بفداحة.
هناك - ثانياً - إقدام السلطة الفلسطينية على إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل، بصورة مفاجئة قبل أن يدخل بايدن إلى البيت الأبيض. وهو تخاذل في توقيت حرج، حرّضت عليه قوى عربية عديدة، تردّد أنّ السعودية على رأسها، تمهيداً لإقدامٍ محتمل على عقد اتفاقية تطبيع جديدة مع إسرائيل، حتى يمكنها أن تقول: «لسنا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين».
وهناك - ثالثاً - أجواء تصعيد ضد إيران «العدو البديل»، تلوح بعمل عسكري أميركي ضدّها قبل انتهاء ولاية ترامب. التلويح لا يعني أنّ الحرب سوف تحدث، فهناك قيود عديدة تمنع هذا الاحتمال، لكنّه قد يكون مقصوداً به ابتزاز الإدارة المقبلة حتى لا تعيد الاتفاقية النووية إلى الحياة مرة أخرى.
إذا ما تغيّرت بالتطبيع المعادلات والحسابات في الإقليم، فإنّ الضرر الأكبر سوف يقع على مصر، يضرب في صلب أمنها القومي ويهمّش أدوارها إلى حدود الإلغاء، أو الإعدام الاستراتيجي.
هكذا اكتسبت معركة التطبيع الأخيرة أهمّيتها ورسائلها التي تتجاوز أشخاصها المباشرين إلى أسئلة المستقبل والمصير، أن تكون أو لا تكون. باتّساع النظرة إلى الملفّات الملغّمة التي تعترض مصر، فإنها مستهدفة في أمنها المائي، وإسرائيل حاضرة في الملف بالتحريض، ومستهدفة في سلامة حدودها، وإسرائيل متأهّبة على حدودها بأفضل ما لديها من نخب عسكرية وأكثر من نصف قواتها المسلّحة، ومستهدفة في مستقبلها الاقتصادي، وإسرائيل جاهزة بمشروعات تعمل على تهميش قناة السويس، وأن تكون هي مركز القيادة الذي يحدّد الحصص والأنصبة حسبما يرى ويقرّر.
بحسّه التاريخي، يدرك الشعب المصري أين مواطن الخطر، وأنّ إسرائيل ليست صديقاً. استُدعيت على شبكة التواصل الاجتماعي صورٌ تقادمت عليها السنين من السجلّات العسكرية تحت عنوان شبه متكرّر: «هكذا يطبّع الرجال؟»، ضمّت إلى رجال القوات المسلّحة أسرى إسرائيليين في حرب 1973، واستُدعيت من السجلّات العائلية صورٌ لآباء وأبناء استشهدوا في ملاحم القتال. إحياء الذاكرة الوطنية صلب قضية مقاومة التطبيع. إذا مُحيت الذاكرة تخسر مصر كلّ شيء، فلا معنى لحرب خاضتها، ولا قيمة لتضحية بذلتها.
لماذا حاربنا؟ «حاربت مصر من أجل نفسها قبل أيّ اعتبار آخر»، كما كتب بخط يده الضابط الشاب جمال عبد الناصر في حرب 1948، على دفتر مذكّرات شخصية. في كلّ الحروب التالية (1956، 1967، 1973)، تصدّرت الوطنية المصرية مشاهد النار والتضحية، بذلت وضحّت، انتكست وصحّحت، من دون أن يفقد شعبها بوصلته في أي وقت، وهي أنّ التطبيع عار وخيانة.
بقوة الرفض الشعبي، أُزيحت أغنية «هافا نجيلا» الإسرائيلية عن المشهد، واستعادت مصر صوتها القديم، كأنّها تتحدّث عن نفسها، تاريخاً ودوراً، رغم كلّ ما جرى ويجري لها ومن حولها. «أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي»، كما أنشدت سيدة الغناء العربي أم كلثوم ذات يومٍ بعيد، من كلمات الشاعر الكبير حافظ إبراهيم.
إذا ما قالت مصر لا، إذا ما ارتفعت إلى مستوى قامتها التاريخية، فإنّ روح المقاومة والرفض سوف تتمدّد إلى الإقليم كلّه، تنقضي تحالفات وتسقط ادعاءات، ويرفع الشرق رأسه من جديد.